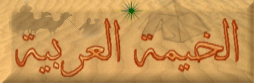
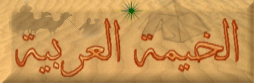 |
منظومة ثوب
ثوب –لباس – جلباب – كساء – خِمار – سربال – ريش – سابغ - مزّمّل ثوب : هو الثوب الظاهر الذي يستر العورة والذي تقابل به الناس وقد استعملها القرآن الكريم بمعناها المعنوي (مروءة، نيّات، خُلُق رفيع) والمادي (ما نلبسه). وهناك فرق بين العورة والسوءة، فالعورة هي كل شيء تستره عن الناس لجماله، والسوءة هو كل ما تستره عن الناس لقبحه. وجمعه أثواب وثياب والثياب توضع وضعاً برفق وسهولة. (وثيابك فطهّر) سورة المدثّر آية بمعنى الأعمال الصالحة والأخلاق والتقوى والعلم والعمل، والسورة جاءت فيها قواعد التقوى في الخمس آيات الأولى. وفي الحديث: يُبعث الميّت بثوبه، أي بعمله. لباس: هو كل شيء خفي سواء كان مادياً أو معنوياً يسمى لباس، وهو الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تُستر بسياج عال حول البيت. واللباس يُنزع نزعاً لأنه يكشف السوءة ولا يُنزع إلا بالقوة وللضرورة فقط (ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤتهما). واللباس يدل على الستر المادي والمعنوي. أما الستر المعنوي ففي قوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ) وهذا أمر بعدم إظهار سيئات الزوج أو الزوجة، وفي قوله: (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) سورة النحل آية تدل على أن القرية كانت منيعة لكن عندها إحساس خفيّ بالجوع والخوف وكلما ازدادت قوة الدول ازداد شعورها بالجوع والخوف كما هو هاجس الدول العظمى الآن من التلوث النووي والإشعاعات وغيرها على رغم قوتهم. واللباس جاء هنا بمعنى نظرية وهذا يعود إلى سوء استعمال الوسائل وسوء استعمال القوة لأنه كلما توفر لدى الإنسان ما لم يتوفر عند غيره أرهقه ذلك وأخافه. (وأنزلنا عليكم لباساً يواري سؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير) والتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية. (وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها) وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، ولباس التقوى هو كل عبادة فيها جانب خفيّ ووقار (الشعور الخفيّ وتوقير العبادة) وهذا امتحان للتقوى (أولئك الذين امتحن قلوبهم بالتقوى). واللباس يواري السوءة الحسّية والمعنوية، ومن سوء العبادة أن تؤديها مفضوحة والأفضل أن تؤديها خالصة لله تعالى وقلبك مخلص لله بدون مراءاة، (أقم الصلاة لذكري) عند ذكر الله يجب قول سبحانه وتعالى أو جلّ جلاله أو لا إله إلا هو. (وتعزّروه وتوقّروه) للرسول صلوات الله عليه وهو غض الصوت عنده والصلاة عليه عند ذكر اسمه. (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) وهذا هو وقار الصلاة. وكل ما سبق هو من ضمن لباس التقوى وتأدية العبادة بوقار كامل. جلباب: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام. (وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن( كِساء: هو الثوب الذي يُلقى على الكتف إلقاءً. () سورة المائدة آية 89، () سورة النساء آية 5، ومنها قوله تعالى () سورة المؤمنون آية 14. خِمار: غطاء الرأس. (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) سورة آية . سربال: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب. (سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم) يلبس الحديد عادة للحرب. ريش: هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى الخيلاء والزهوّ. (وأنزلنا عليكم لباساً يواري سؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير) سابغ: كل شيء واسع وتامّ ومريح ومنها اشتّق إسباغ الوضوء و(أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) مزّمّّل: طريقة لبس الكساء إذا لفّ الإنسان نفسه بكسائه. (يا أيها المزّمّل) سورة المزمل آية 1 دثار: (يا أيها المدثّر) سورة المدثر آية 1، والمدثر هو المتدرّع دثاره. |
باب حرف الجيم
منظومة الجوع جوع – خصاصة – مخمصة – مسغبة كل هذه الكلمات تنتمي الى منظومة الجوع وكل منها لها معنى خاص بها ولا يصح استبدال كلمة بكلمة وإلا تغير المعنى كلياً. وكل هذه المرادفات تعني الجوع وتدل على خلو البطن من الطعام لكن لكل منها معناها الخاص المتفرد الذي لا يصح المعنى بدونها ولا يغني عنه استعمال كلمة أخرى الجوع : هو ألم البطن الأولي لفراغ المعدة من الطعام وهو أول درجات خلو البطن من الطعام. فكل يوم نصاب بالجوع وهو من قوانين البشر كما نظمأ فنشرب ونتسخ فنغتسل وكذلك نجوع فنأكل. فقد نشعر بالجوع صباحاً فنفطر ونجوع ظهراً فنتغدى ونجوع مساءً فنتعشى. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) (الغاشية:7) )الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش:4) (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال و الأنفس والثمرات وبشر الصابرين) ( سورة البقرة: 155) خصاصة: إذا استمر الجوع في الإنسان أو في مجموعة من الناس لمدة أطول كأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أكثر يسمى خصاصة. والخص هو نبات من القش أصفر وضعيف وهزيل، فإذا أدى الجوع بالإنسان الى اصفرار لونه ولا يشبع مما يأكل ولكنه لم يصل بعد الى درجة المجاعة إنما الطعام قليل فيظهر على الوجوه عدم الشبع وهو ما يعرف بمصطلح العصر بـ(سوء التغذية) تسمى هذه الحالة خصاصة وهكذا كان أهل المدينة المنورة من الأنصار لقلة الطعام عندهم بعدما تقاسموا مع المهاجرين طعامهم وآثروهم على أنفسهم في كثير من الأحيان. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ تبوءوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر:9) مخمصة: إذا تطور الجوع بحيث أدى إلى تشويه في الوجه والجسد كأن تصبح العيون غائرة والبطن مخسوف وغائر إلى حد مشوه فعندها يسمى مخمصة (غار الوجه بحيث تبدو الجمجمة ظاهرة والبطن عظامها ظاهرة) كما نرى في صور من أصابتهم المجاعة في أفريقيا ودول العالم الثالث الفقيرة. ويقال أخمص القدم إذا تشوهت القدم من الأسفل أي حدث فيها خسف غلى الداخل. هذه الحالة تسمى مخمصة وهي الحالة التي فيها يحق لصاحبها ان يأكل مما حرم الله عليه كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة:3) )مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (التوبة:120) (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) والآية هنا لا تعني من كان في سفر قصير ولم يجد طعاماً حلالاً وجاع فالإنسان يمكنه البقاء بدون طعام مدة من الزمن وذلك لوجود الدهون والشحوم في جسده التي تذوب عند الإحساس بالجوع وتغطي إحساس الجوع الذي يشعر به الإنسان، وعندما تنفذ هذه الدهون ويصفر الوجه ويهزل الجسم وتغور البطن وتصبح حياة الإنسان مهددة، عندها يجوز أكل المحرمات فقط. ولهذا يجب مراعاة هذه النقطة لئلا نقع في المحظورات لمجرد سوء فهم معنى الكلمة (مخمصة) مسغبة: إذا صادف مع هذه المخمصة حالة من التعب والعناء والحالة المزرية تسمى مسغبة. والله سبحانه وتعالى عنده عبادات تكفي عن كل العبادات مثل الشهادة في سبيل الله فكأن كل طاعات الشهيد الأخرى اختزلت في هذه الشهادة. كذلك الذي يطعم في مسغبة فالحال هنا تشابه حال المحكوم بالإعدام ثم تفكه أو عبد مملوك فتعتقه وتحرره (فك رقبة) وكذلك الإطعام هنا يجب أن يكون له مزية وليس بإطعام ما تبقى لدينا من طعام في يوم ذي حصار شديد ومعاناة شديدة وتعب شديد ثم يصبح عندك طعام فتطعمه هذا الذي يحاسب الله تعالى عليه بما شاء سبحانه. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) (البلد:14) الجوع له جانبان: جانب ايجابي عظيم وهو الجوع الاختياري أو الجوع لهدف عظيم وجانب سلبي لئيم كالجوع الإجباري كأن تجوع لأن غيرك استولى على حقك بالغذاء. وللجوع عدة أنواع منها: الجوع العظيم: وهو الصوم الذي يعتمد على الجوع أولا وهو أعظم العبادات (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فالصوم يطهر الشمائل ويكفر الذنوب وما من حسنة وفضيلة في الإنسان إلا الصوم أساسها ولما أراد الله تعالى أن يقابل موسى ليكلمه طلب منه الصوم فصام موسى 40 يوماً فارتقت نفسه عن الغرائز والشهوات. وفيما يروى أن الله تعالى خلق العقل فقال ما خلقت أفضل منك فقال له أقبل فأقبل ثم قال له تعالى أدبر فأدبر فقال له الله تعالى من أنا قال: أنت الله لا اله إلا أنت، وخلق الله تعالى النفس فقال لها ما خلقت أشر منك فقال لها من أنا قالت أنت وأنا أنا ففرض عليها الصوم ثم دعاها فأقبلت قال من أنا قالت: أنت الله لا اله إلا أنت. والله أعلم. ولأهمية الصوم وعظم ثوابه وحسناته كان كفارة للذنوب، فكفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين وكفارة اليمين الكاذب صوم ثلاثة أيام وكفارة الحلق للمحرم صيام عشرة أيام وكفارة ترك معاشرة الزوجة الصوم أيضاً ولولا ثوابه العظيم وما يفيد النفس البشرية لما فرضه الله تعالى علينا وجعله كفارة لذنوبنا. وقد وصف الله تعالى الصوم بالصبر في قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة). الجوع الإجباري: هو أسوأ أنواع الجوع بأن يحرمك غيرك من حقك بالطعام فالتجويع من شر الأعمال على الأرض فما من شر أشد من أن تتعمد أن تجيع فرداً أو مجتمعاً أو شعباً بأكمله كما يحصل في الحصار للبلاد العديدة كما حصل في العراق وغيره من البلاد التي يتسلط عليها من يجوعها ويمنع الطعام عنها. وصدق الرسول الكريم صلوات الله عليه في حديثه (امرأة دخلت النار في قطة حبستها وأجاعتها( الجوع الرحيم: كأن تجوع لغيرك كما فعل أهل المدينة من الأنصار، جاعوا هم ليطعموا إخوانهم من المهاجرين. الجوع الكريم: أو جوع العفة كما في قوله تعالى: (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم) (البقرة:273) حتى ولو كان بهم جوع لا يسألون أحداً الطعام لشدة عفتهم وعزة نفوسهم مع أنهم يتضورون جوعا. الجوع الوسيم: هو ما يفعله الناس من جوع بهدف الرشاقة واللياقة أو ما يفعله بعض فرق الكوماندوس الذين يتدربون تدريباً قاسياً ويتبعون حمية معينة فلا يأكلون أي شيء يريدون متى شاءوا. الجوع اللئيم: وهو شعور الجوع الذي يشعر به من لا يثق بالله تعالى (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) (النحل:112) يخاف الناس من الجوع القادم لأنهم لا يثقون بالله الرزاق العليم. الجوع السقيم: وهو جوع المرض أو الخوف أو الكآبة فكل هؤلاء يفقد شهيته للطعام. الجوع العظيم: وهو الابتلاء(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين( ولنتوقف قليلاً عند هذه الآية: الخائف لا يتلذذ بشيء فالأمن والغذاء هما أساس كون الإنسان صالح للحركة، الجائع حركته خاطئة والخائف حركته خاطئة (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)(قريش:3-4) وفي حديث الرسول r: (لعن الله من أخاف مسلماً). وهنا ينبغي أن نفرق بين البلاء والفتنة والامتحان. الابتلاء يكون بما تكره (الجوع، الخسف، الخوف..) ويكون لجلاء الصبر.)لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين( الفتنة تكون بما تحب كالمال والسلطة والنساء والأولاد وهي لجلاء الشكر وليرى الله تعالى مدى شكرك له وكيف تستعمل هذه النعم بالكفر أو الشكر. الامتحان هو الامتحان بما يخفى وهو اختبار الكفاءة. الخوف والجوع متلازمان والفرق بين الخوف والجوع أن الجوع يزول بلحظة ما إن تأكل الطعام حتى يتلاشى الإحساس بالجوع حتى ولو استمر الجوع لسنين. أما الخوف فلا يزول. كما في قصة بني إسرائيل مع فرعون، فمن كثرة ما أخافهم فرعون وارهبهم لم يصدقوا أن الله نجاهم مع موسى في البحر وأغرق فرعون وجنوده فلما قال لهم موسى ادخلوا الأرض قالوا لموسى إن فيها قوماً جبارين. ولكي يزول الخوف من شعب أو أمة يجب أن يزول الجيل بكامله ولأجل هذا بقي بنو إسرائيل تائهين أربعين عاما حتى نشأ جيل جديد لا يخاف. في النعمة فقد قدم الله تعالى الطعام على الأمن(الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(. أما في النقمة فقد قدم سبحانه الخوف على الجوع (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) والصوم هو ابتلاء من رب العالمين ليعلم صبرنا، أما تجويع الناس فهو من فعل الناس(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) وليس من فعل الله عز وجل فقد قال تعالى: (لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع) ولا بد من الشعور بشيء من الخوف لجلاء الصبر والتحمل عند مواجهة العدو جعل الله تعالى الجوع والخوف والتضحية جعلها في أيدينا. فلسفة الجوع الإيجابي: • قال يحيى بن معاذ وهو من صالحي هذه الأمة: جوع الراغبين منبهة الذين يرغبون بالتقرب الى الله. مثل سيدنا موسى عليه السلام صام أربعين يوماً حتى صفت نفسه وطهرت من الغازات والتجشؤ وغيره من أدران الجسد. وجوع التائبين تجربة (عندما يتوب المذنب من ذنوبه ويريد أن يكون عبداً صالحاً يجب أن يجرب الجوع هتى يعود نفسه على حسن العبادة وعلى الصبر) • وقال سعد بن سهل: أفضل العبادة ترك فضول الطعام اقتداء بالرسول صلوات الله عليه. وضعت الحكمة والعلم في الجوع والمعصية والجهل في الشبع وما وصل الصالحون إلا باخماص البطون. من جوّع نفسه انقطعت عنه الوساوس. إقبال الله على العبد بالجوع • سألوا حكيماً: بأي قيد أقيّد نفسي؟ قال: قيّدها بالجوع والعطش، وذلّلها بإخمال الذكر وترك العز، وصغّرها بوضعها تحت أقدام الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: عندما صام سيدنا موسى ثلاثين يوماً فأتمها بعشر مع أنه كان صائماً وجائعاً لم يشكو تعباً ولا جوعاً وفي قصته مع العبد الصالح خرج مع فتاه وقال له آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. |
منظومة جعل
جعل – خلق- سوّى – أبدع – أنشأ – صنع – عدل –عمل - فعل أبدع: إيجاد الشيء من العدم (بديع السموات والأرض) لم تكن موجودة قبل. خلق: الخلق من شيء موجود (خلق الإنسان من طين). تقدير الشيء قبل إيجاده كالتصميم قبل البناء فالتصميم هو الخلق والخلق هو التصميم. خلق الله تعالى الإنسان قبل أن يكون طيناً (ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). سوّى: إذا وُجد الخلق صار تسوية مثال عندما ينفّذ التصميم فيصبح بناءً. عدل: هذه التسوية ليس لنفر واحد وإنما لمليارات الناس فحقق العدل بين البشر جميعاً كلهم بنفس المواصفات متناظرين عدول طيبون (ابن آدم طيّب في خَلقه وخُلقه) يقال اعتدل الطقس أي صار طيباً جميلاً. صنع: الصناعة هي حسن الخلق وحسن التسوية (ولتصنع على عيني) المصنع فيه نماذج وهياكل تتطور فتصبح صناعة متطورة. والصنع هو إتقان الشيء (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم) بما صنعوا: لإتقان الشيء وحسن إيجاده الأسلحة العظيمة بدأت تتغلب على أصحابها لشدّة ما ظلمت العالم. هؤلاء القوم جاءهم صلح الحديبية فانقضّ عليهم المسلمون ودخل الناس في دين الله وجاءتهم بدر. وجاءت لفظة (لا يزال) هنا للدلالة على الاستمرارية ليوم القيامة، والقارعة من القرع الشديد بخلاف النقر. أنشأ: أي نمّاه من طفل إلى شاب (أومن يُنشّأ في الحلية) وقوله (وينشيء السحاب الثقال). فالتنشئة هي التنمية الفكر ينمو والعقل ينمو فهي أطوار مع حسن تربيتها وتنميتها. جعل: بعد أن يخلق الله تعالى الشيء يهديه إلى وصف جديد أو صفة جديدة. عندما يهدي سبحانه وتعالى المخلوقات الحيّة إلى وظيفتها يسمى جعلاً (واجعل لي وزيراً من أهلي) أضاف إلى هارون وصفاً جديداً وظّفه توظيفاً جديداً سلباً أو إيجاباً. (وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها) (ومن آياته..وجعل بينكم مودة ورحمة) خلق: قدّر الله تعالى الرجل والمرأة وخلق من الرجل امرأة وبعد أن قدّر الله الرجل والمرأة أضاف الله تعالى لهما وظيفة جديدة بأن جعل بينهما مودة ورحمة وهذا يسمى جعلاً. وقال لتسكنوا إليها والسكون ضد الحركة وهو سكون مادي ومعنوي وهناك ثلاثة أسباب لسكون نفس المؤمن: صلاة النبي صلوات الله عليه على أمته.(وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) البيت الطيّب (ومساكن طيبة) أي مريحة وآمنة المرأة سكن زوجها. جعل بينكم مودة ورحمة: الحب للفعل (أحبه لأنه كريم أو شجاع) ولا يمنع أن يكره الشخص لشيء آخر. الكره يكون لفعل في الشخص وليس لذاته، أما المودة فلذاتك كما تودّ أباك وأمك وأقاربك بغض النظر عن أفعالهم صالحة كانت أو غير ذلك. ومهما أساؤوا إليك تبقى المودة لقرابة الدم وما من مخلوق يدخل في هذه المنظومة والمودة إلا المرأة. (وعاشروهن بالمعروف) والمعروف هو عرف الناس الصالح الواقعي على كل من الزوجين أن يتعامل مع الآخر على أساس ما هو رجل وامرأة فلا يعامل الزوج زوجته كما يعامل صديقه أو عامله. (وما خلق الذكر والأنثى* إن سعيكم لشتى) لا يجب أن تتطابق المرأة والرجل في كل الأمور لأنه هذا يتنافى مع طبيعتهما التي خلقهما الله تعالى عليها. (إنا جعلناه قرآناً عربياً) النسخة التي بين أيدينا من القرآن هي النسخة التي يسّرها الله تعالى للناس. (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) هذا الإنزال بالصيغة الأصلية للقرآن فهو لم يكن عربياً إنما جعله الله تعالى عربياً لييسره للناس (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر) عمل: أي أثّر في الشيء فعل: جزئيات العمل تسمى فعلاً. كل فعل عمل وليس كل عمل فعل. وأضيف هذه الكلمات التي قد تدخل في المنظومة ولم يذكرها الدكتور الكبيسي في الحلقة وهي والله أعلم: صوّر وبرأ |
منظومة جلّ
الجليل – الكبير – العظيم – السيّد - الوجيه هذه الكلمات كلها في ألقاب الرؤساء والملوك وهي صفات تطلق على الناس وهي مختلفة تماماً عن صفات الله تعالى التي تحمل نفس الاسم لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. الكبير: كل من هو رأس يسمى كبيراً سواء كان عادلاً أو ظالماً يسمى كبير بلا منازع (كبير الدولة، كبير المهنة، كبير العشيرة) (كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) العظيم: إذا لم يكن الكبير فوقه أحد أعلى منه يقال له صاحب العظمة وهذه صفة تطلق على الرؤساء والحكام الذين ليس فوقهم أحد. ولا حرج من إطلاق صفة صاحب العظمة على ملك. وقد استخدمت لفظة عظيم في القرآن لأمور عدة منها: للفوز: (فوز عظيم) بمعنى ليس بعده فوز. وللعذاب (عذاب عظيم) أي ليس هناك أعظم منه. والكبير والعظيم ليس فيهما مدح أو ذمّ. السيّد: إذا أردت أن تمدح الكبير أو العظيم تقول السيّد وهو أعظم أوصاف الملوك ولذا وُصف الرسول r بأنه سيّد الخلق (أنا سيّد ولد آدم) والسيّد تعني الملك المحبوب من شعبه لأنه يتسيد سوادهم وهو قليل في التاريخ. الجليل: صاحب الجلالة أو الجليل تطلق على عظيم القدر المستحق الحمد لسنّه وعمله ومقامه وله تعظيم خاص وتوقير خاص ومهابة لأن له رهبة في القلب. الجلالة هي عظيم القدر المستحق للمدح والحمد. الحمد يلي النعمة أما لمدح فقد يكون بدون تقديم نعمة فقد يكون الشخص مستحقاً للمدح لصفاته. كل سيّد يستحق الحمد والمدح يسمى جليلاً فلا يطلق على كل ملك صاحب الجلالة إنما يطلق على الملك الوقور الحليم الناصح لشعبه. صاحب الجلالة ذو الجلال: تعني الهيبة، إذا بلغت الجلالة غايتها ولا تطلق إلا على الله تعالى. الوجيه: جليل ووجيه عند الله يشفع عند الله (كسيّد الأوس الذي وصفه الرسول r) وكما وصف الله تعالى سيدنا عيسى u بالوجاهة أي له وجه وهو أوّل القوم وعظيمهم وسيدهم (وجيهاً في الدنيا والآخرة). كل حاكم عادل هو سيد قومه ورئيسهم وحاكمهم يحبهم ويحبونه فهو وجيه عند الله كما هو وجيه في الدنيا ويشفّعه الله تعالى بهم يوم القيامة. الملأ والوجهاء هم القوم المبرّزون في مجتمعاتهم كأصحاب العلم والمهن الرفيعة والسياسة ولهم رأي مسموع وشفاعة. سيد القوم وصفاً ممدوحاً لعظيم القوم و لا تقال سيد القوم إلا على كريم في باب المدح. ولكي يكون الإنسان سيّداً عليه أن: يفوق غيره بالعقل والدفع عن شعبه ويجلب لهم النفع ولا يمالئ أحداً عن شعبه ولا يضر بمصالح شعبه إنما هو سيف مسلّط على عدو شعبه. هو المعين بنفسه أي يذهب بنفسه لنصرة أو مشاركة شعبه في السراء والضراء وليس خيلاً على شعبه فأمواله مفتوحة للكل. الذي لا يغلبه غضبه فلا يحكم في ساعة غضب فهو حليم لا يحكم إلا بعد زوال غضبه. وهو الورع الحليم ولا يسارع في العقوبة وهو المقهور على نفسه وماله كما كان سيد تميم (قيس بن الأحنف) يُشتم في مجلسه فيبتسم وليس له رد فعل وكذلك سيد الأنصار سعد بن معاذ. جمع سيد الأسياد (السيد الحالي) وسادة (للأسياد المستقبلون) الذين سيصبحون ملوكاً لاحقاً ومستقبلاً. صفات الحاكم الذي يكون سيد قومه: من أكابر القوم معروف الأصل والنسب. يعل بين أفراد شعبه. لا يكذب عليهم أو يغشهم. (أول من يدخل النار ملك كاذب) أن يقضي حوائجهم العامة والخاصة. أن ينصح لهم في معيشتهم فيصلح حالهم من أسباب المعيشة. يجهد نفسه ويبذل كل وسعه في إصلاح حالهم. لا يحتجب عنهم ولا يمنع عنه قومه. أن لا يولي على قومه شرار الناس فلا يولي قاضياً ظالماً بمعرفته وعلمه وعليه حسن الاختيار فإذا علم بسوء الولاة عزلهم وولّى غيرهم ممن شهد لهم بالعدل وحسن الخلق. كل ابن آدم سيد فالرجل سيد في بيته والمرأة سيدة في بيتها (حديث شريف). وفي الآية (ألفيا سيدها لدى الباب) كانت مواصفات العزيز مع زليخا زوجته هي مواصفات السيد الكريم والزوج عندما يكون سيداً يكون: المنفق عليها من فضله، يباشر تعليمها وتربيتها وتنشئتها إذا لم تكن متعلمة فيرفعها إلى مستواه وهذا هو مفهوم التأديب وليس بالضرب، والتجاوز عن أخطائها وهفواتها ما لم تكن ماسّة بالحياء. والخطيئة ماسّة بالحياء كما فعلت زليخا فإذا كنت سيدها وليس بعلها عليك أن تبادر بالعقوبة إنما تبحث في الأسباب، فالعزيز فكّر بالأمر وأين بدأ سبب الخطيئة ورجّع الأسباب لنفسه لأنه يعلم أن له زوجة شابة وجميلة وليس لها ولد وأحضر إلى بيته شاباً جميلاً كيوسف u وقال لها أكرمي مثواه ولم يزجرها سابقاً من الجلوس مع يوسف فعلم أن السبب كان فراغ كامل وشباب متوهج فقال لها: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فقط لأنه سيدها وليس بعلها. |
منظومة جمّ
جمّ – لمّ – شديد - كثير ما ورد في القرآن الكريم يتحدث عن أسلوب غير المؤمنين في التعامل مع المال. والمال هو من الأشياء التي تحبها النفس البشرية حباً جماً ولمّاً شديداً لكن الإسلام هذّب هذه النفس المؤمنة. أما غرائز الكافرين فهي باطلة وهم يتعاملون مع المال بغرائزهم فقط كقوله تعالى (وأكلهم السحت) (وأكلهم الربا وقد نهوا عنه). فالمال عند اليهود إله يحبونه حباً جماً وليس لأحد غيرهم حق فيه. الجمّ: اجتماع الشيء في مكان واحد، تقال للماء جمّ الماء إذا اجتمع في حفرة واحدة بحيث لا يسيل ولا يحق لأحد أن ينتفع به حتى يأسن. ومنه الجمّ الغفير للناس يجتمعون في مكان واحد ، ومنه الاستجمام عندما يتعب الإنسان يذهب إلى مكان ليستجمّ ويرتاح في مكان واحد بلا حركة. حب المال حباً جماً هو الحب بحيث لا يُنفق في الخير. يجمع المال لأجل الجمع فقط وليس للإنفاق في سبيل الله وهذا الحب ينتج عنه الكنز والبخل والشح والمنع يمنعون الناس حقوقهم ويكنزونه ويبخلون به حتى يصبح شحاً. والله تعالى خاطب الكافرون بهذه الصفات (وتحبون المال حباً جما) اللمّ: جمع المال لا تبالي من أي جهة تأخذه من ربا أو اغتصاب أو استيلاء على ثروات أو أي طريق باطلة. اللمّ في حال اكتساب المال من مصادره والمؤمن لا ينبغي له جمع المال إلا من مصادر حلال. وبعد أخذه من مصادر متعددة يُجمع ولا ينفق وهذا ينافي وظيفة المال في الإسلام التي هي من أرقى العبادات. والجمّ واللمّ هي طبيعة جمع المال. الشديد: (وإنه لحب الخير لشديد) الخير هنا بمعنى المال. والشديد هي صفة الذي يجمع المال وهناك فرق بيم من يجمع المال من حرام أو حلال ومن يجمعه من حلال يتكاسل الإنسان في جميع الأمور إلا في حال جمع المال فتراه شديداً. التكاثر: التفاضل (ألهكم التكاثر) صاحب المال في الإسلام ليس وجيهاً ومن يوجهه المال فهو منافق والفرق بين الغني والفقير كالفرق بين العالم والجاهل. (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وهي غير الصدقة فالصدقة قد تكون قليلة لكن الإنفاق للجهاد ونصرة الدين بكل المال كما يجاهد بالنفس كلها في الجهاد. وكما يستعد المؤمن لإعطاء نفسه في سبيل الله يجاهد بكل ماله في سبيل الله أيضا. والغني الشاكر خير من الفقير الصابر فالغني جمع المال وأنفقه في سبيل الله (مثل سيدنا عثمان الذي أنفق ماله كله في سبيل الله) مصداقاً لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه . يحب المال لكن لا يحبه حباً غرائز يا إنما حباً يقربه من طاعة الله ورضوانه بإنفاقه في وجوهه المشروعة. المسلم يعطي ولا يأخذ (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) والمسلم لا يملك المال ولكنه مستخلف عليه لأنه مال الله أساساً. خذ حلال المال ولا تنفق على حرام ولا تبذّر. وفي الحديث الشريف: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الفرق بين الصدقة والنفقة: الصدقة هي إعطاء جزء من مالك لغيرك قد يكون قليلاً أو كثيراً والقليل يجزئ ويسمى صدقة ولو كان درهما. أما النفقة أو الإنفاق فهو أن يكون المال تحت الطلب متى شاءت لظروف أو احتاجها أحد بذلت في سبيل الله ولذا جعل الله تعالى الجزاء للمنفقين (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) . والإنفاق في سبيل الله له أعظم الأجر في الآخرة وهو من أعظم العبادات في الدنيا. والإنفاق هو الصفة المشتركة في ثلاثيات المتقين والمحسنين وأهل الليل كما وصفهم القرآن الكريم: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) وهذا هو الإنفاق، وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تدل هنا على حق الزكاة لأن نسبتها من المال معلومة بـ 2.5 %. وكذلك ورد ذكر المنفقين في ثلاثية العادل (ولأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون). فالإسلام دين إنفاق وليس دين صدقة فقط. والمال ليس مال المسلم وإنما هو مال الله استخلف المسلمين عليه. والزهد هو زهد المالكين هو أن تملك المال وتزهد فيه لا أن تكون فقيراً لا تملك شيئاً وتزهد. وقد قيل الكرم شجاعة وقول الحق شجاعة وتربية الأولاد شجاعة. |
منظومة جمال
جمال وجميل – حسن – وسامة – زينة - نضارة الجمال: هو الكمال في عضو واحد من الأعضاء قد يكون الإنسان جميلاً إذا كان أنفه جميل ولا يمنع من وجود القبح في ناحية أخرى. فالجمال عكس القبح. حُسن: إذا كان كله جميلاً أي كل ما في الإنسان جميل. والدمامة عكس الحُسن لأن الدميم ليس فيه جزء من جمال. (ولله الأسماء الحسنى) لأنها مطلقة عامة ومن صنع الله تعالى. فالجمال نسبي والحُسن عام مطلق وفي الغالب الحُسن من صنع الخالق سبحانه والجمال من فعل الإنسان (صبر جميل). زينة: هو كل ما الذي يجعل القبيح جميلاً كأدوات الزينة والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وسيم/ وسامة: هو كل أثر في الوجه تركه موسوماً محدداً، من سمة (سيماهم في وجوههم من أثر السجود). وهو شيء فيك تستلذه النفس ويميزك عن غيرك (كخال في الخد أو غمازة أو رموش العين أو شامة أو غيره) والوسمي هو الاخضرار في الأرض بعد المطر. جميل: الجمال كمال مطلوب وهو نوعان إما كمال لذاته (إنسان جميل فأمتدحه) وإما جمال يستحق الحمد (هجر جميل) ومن هنا جاء الحديث الشريف: إن الله جميل يحب الجمال. من كثرة صفاته التي يجب أن يُحمد عليها مع المدح. وصفات الحمد هي الجليلة التي يصيب الإنسان منها الخير. والجميل هو الفعل الطيب من غيرك الذي نفعك به وهذا هو الجميل الذي يحبه الله تعالى. ومن صفات الله الجميلة: المنعم، المعطي، الغفار. والأسماء الحسنى بكمالها تعتبر حسناً منقطع النظير لأنها عامة وليست خاصة. هناك ما يسمى قبح الجمال وجمال القبح: فقد يكون القبح جمالاً والجمال قبحاً. الجمال القبيح هو الجمال الذي يؤدي إلى مفسدة. والجمال المتفرّد هو أرقى أنواع الجمال كما جاء في الحديث: إن في الجمال المتفرد رجل يذكر الله في قلبه في السوق، ذاكر الله بين الغافلين والثابت بين الفارّين. والغربة جمال ما بعده جمال أن تكون وحدك على الحق والباقي كله على الباطل بل هو حسن شامل كامل مطلق. والرسول صلوات الله عليه هو أجمل من على الأرض للأسباب التالية: 1. ورفعنا لك ذكرك: لا يُقبل التوحيد ولا الشهادة إلا بذكر الرسول الكريم 2. ما خاطب الله تعالى رسوله إلا بـ (يا أيها النبي، يا أيها الرسول) وما من بشر أقسم الله تعالى به إلا )(لعمرك أنهم في سكرتهم يعمهون( 3. النهي عن زواج نسائه من بعده، والنهي عن رفع الصوت على صوته. 4. أخذ الله تعالى العهد على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إذا أدركوه. كلمة جميل في القرآن الكريم: يقال صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل. سرحوهن سراحاً جميلاً: المفروض أن يفارق المرء زوجته على حالة رضا ووفاق فقد يكون الخلاف على أمر معين ولكن على الزوجين أن لا ينسوا الفضل بينهم. الصفح الجميل: صفح بدون عتاب أو منّة. وكل سلوك المؤمن يجب أن يكون جميلاً. التوسّم: هي جماليات الأمة. فالأمة أنسابها ثابتة ولا تشرك رحيمة بعدوها، أعراضها طاهرة كما قال تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس. والتوسم نوع من أنواع الوحي وليس وحياً، كما أوحي إلى أم موسى وهو من نوع الخاطرة. فالله تعالى يعطي بعض عباده قدرة على التوسم في الأشخاص وقد قال الرسول r في الحديث: إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا: الحياة قبيحة بدون مال وبنين فتزينها بالمال والبنين. وقمة الزينة في الحياة الدنيا أن يجتمع للإنسان المال والبنون والمال دائماً يقدّم على البنين. (وأمددناكم بأموال وبنين) الجمال جزئي في عضو ما والحُسن شامل والزينة تزيين ما ليس جميلاً ليكون جميلاً والوسامة أثر من جرح أو غمزة أو شامة أو خال تزيد الجمال جمالاً ويعرف الوسيم بشيء ليس في غيره. النضارة: هي الجمال المترف عكس الجمال البدوي عينان واسعتان وفيه جفاف البادية وظروف عيشها. والنضارة هي حُسن المترفين (تعلاف في وجوههم نضرة النعيم) ويقال روض نضير بمعنى عشب أخضر مترف. ويقال غض نضير بمعنى غصن مترف أخضر بالكامل. والنضارة تطلق على الجمال عندما يكون فيه بهاء وإشراق وهو الجمال المترف. النضارة عكسها الجفاف، والزينة عكسها التعطيل، والوسامة ليس لها نقيض. الحِلية: هي من أدوات الزينة والزينة من وسائل الجمال. (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين). الجمال نوعان: مادي ومعنوي وهناك جمال قبح وقبح جمال والجمال نسبي وحتى يكون الجمال متكامل كما عند الرسول r فهو جميل حسن وحسنه لا يعتره النقص من جانب. وله أكمل الجمال والحُسن فهو حسن الخلق وحسن الخُلُق وحسن الأقوال والأفعال. فإذا توفرت كل هذه الصفات يكون الإنسان جميلاً متكامل الجمال وهذا لا ينطبق إلا على الرسول r. ومن صفات جمال الرسولصلوات الله عليه حسن الخلق: لا عيب فيه كامل متكامل (اعتدال الصورة والأعضاء) السكينة الباعثة على هيبته تبعث على طاعته والإقبال عليه. حسن القبول الجالب للقلوب فتميل القلوب إليه حتى أعداؤه لم يقدروا عليه فكان مقبولاً لدى الجميع.هذا يؤدي إلى أن الجميع من حوله يتفانون في خدمته حتى في أشد الظروف وأشد الساعات عسراً. حُسن الخُلُق وإنك لعلى خلق عظيم) أكبر تأكيد على حسن خُلق الرسول وعناصر كونه على خلق عظيم: رجاحة عقله لا يُستغفل ولا يُزدرى به ولا يقول كلاماً غير لائق. ثباته في الشدائد وصبره الثابت فلم يعرف الخوف قلبه. زهده في الدنيا والزهد هو زهد من يملك الدنيا. تواضعه للناس مع أنه سيدهم وإمامهم. الحلم والوقار ما غضب النبي لنفسه أبداً إلا أن تنتهك حرمة الله. قوة قلبه في الحروب، منتهى القوة مع منتهى الرقّة. حفظه للعهود والوفاء بها. صدق الحديث الذي كان يوجد في وجهه نضارة أوتي جوامع الكلم. |
منظومة الجنّ
الجنّ – الأبالسة – العفاريت - الشياطين الجنً عامة هو الستر ولذلك سُمّي الجنين جنيناً. الجنّ: مقابل الإنس وهو أقوام لا يُرون بالحواس والجان هو أبو الجنّ كما أن آدم هو أبو الإنس.والكلمات جني، عفريت، ابليس، شيطان كلها من مرادفات جنيّ ولكل واحدة منها معنى خاص بها. ابليس: إسم لشيطان واحد أو جنّي واحد، وكان إسمه عزازيل أطلق عليه اسم ابليس عندما طُرد من الجنة بعدما عصى الله تعالى بعدم السجود لآدم واعترض على أمر الله تعالى. والإبلاس لغة هو اليأس التّام. ويقال مبلسون أي آيسون من رحمة الله تعالى يأساً كاملاً. () شيطان: الشيطان من شطن أو شيط أي احترق من الغضب. وشيطان بمعنى من ابتعد عن الحق ابتعاداً لا عودة فيه من شطن. أو من احترق من الغضب عندما يرى المؤمنين يعبدون الله تعالى شيطان صفة تطلق على كل ذي صفة ذميمة للإنسان أو الجنّ حتى لو كان حيواناً. عفريت: هم أبطال الجنّ. كل من بلغ القمّة والإبداع في عمله يسمى عفريتاً عند الجن. كما نسمي الأبطال عند الإنس. ولهذا جاء في قصة داوود (قال عفريت من الجنّ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) العفريت يأتي بقدرات هائلة ليست بمعجزة كما فعل الذي عنده علم من الكتاب في القصة نفسها (الذي عنده علم من الكتاب استخدم ما يعرف في عصرنا الحالي بالإنتقال الضوئي). شيطان مارد: الذي ينفلت عن نظامه ويكون في عصيانه رأساً (وحفظاً من كل شيطان مارد) يطلع للسماء مرة أو مرتين متجاوزاً للتوعد فبعث الله تعالى له شهباً يحرقه. وإذا طغى الجنّ يسمى مارداً مثل الطاغية عند الإنس. شيطان مريد: هو الشيطان المستمر في العصيان (ويتبع كل شيطان مريد) وهو الذي يتلبس الإنسان لأن همّه إفساد البشر. شيطان رجيم: هو اشيطان المطرود عن الخيرات ومنازل الملأ الأعلى (فاخرج منها فإنك رجيم) (وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) (الحجر:17) الجنّ: اختلف المفسرون في معناها وقيل أن كل العوالم المستترة تسمى جنّاً حتى الملائكة. وكل ملك جنّي وليس كل جنّي ملك. والنورانيون ملائكة والأشرار شياطين وبينهما الجنّ كما قال الراغب (وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا) كما يقابل الإنس المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. الجِنّة: هم جماعة الجنّ (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) سورة الصافّات آية 158. أو من يصاب بالجنون من تأثير الجِنّ (أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) سورة سبأ آية 8 . (وقالوا معلّم مجنون) و(لشاعر مجنون) تدل على إصابة الجنّ له. الشياطين عموماً لها عدة وظائف، والجن يوسوس في الصدور والقلوب وقد ثبت علمياً وطبياً أن للقلب دماغه كما أن للرأس دماغه فالقلب ليس عضلة فقط تضخ الدم إنما له دماغه وله تناسق مع الدماغ في الرأس. الجِنّ: تعاملهم مع الإنس ممكن جداً برغم أنهما من أصلين مختلفين. خلق الله تعالى الجن من نار عندما كانت الأرض كرة ملتهبة فعاشوا فيها ثم لمًا بردت الأرض خلق الله تعالى آدم. خلق الله تعالى الجن وسخّرهم لخدمة الإنس والتلبس دليل على ضعف البشر فإذا كان الإنس قوياً وسخّر الجنً له يضعف الجن وينقاد ويخدم الإنس خدمة تامة. فإذا ضعف الإنس قوي الجنّ وأخذ يتلاعب به كما يشاء. فالخوف إذا تمكن من الإنسان صعب أن يزول إلا بالإستعاذة ولذا قدّم الله تعالى الخوف على الجوع في الآية: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات). والجن هو مخلوق موجي يستطيع أن يتحرك كيفما شاء وأينما شاء ولا يحول بينه وبين الإنسان جدار أو حائط أو سد أو غيره. (يا معشر الجنّ الإنس أن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السموات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان) والسلطان هو غاية القدرة والنفوذ. يدعونا الله تعالى في القرآن إلى اقتحام الجن ونهانا عن الإستعاذة بهم لأنهم ضعفاء أمام الإنسان القوي. الشياطين هم أشرار الجنّ والكافرون منهم. مهمة الكافرون من الشياطين إكمال مهمة ابليس، فمنهم الذين بفسدون عقيدة الإنس (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) والمهمة الثانية هي للذنوب كالخمر والميسر والفرار عند الحرب والتبذير. فالشياطين يوسوسون (وسوسة) ويُضلون (إضلال) ويُغوون (إغواء). |
منظومة جنح
جنح – مال – زاغ – زيغ - جنف – حنف – راغ – عَدَلَ – زلّ - لحد- نَكَبَ منظومة جنح هذه تشمل كل أنواع الميل وهذه المنظومة كلها صغائر تدلّ على أن الفعل المحرّم لم يُرتكب. الميل: العدول عن الوسط لأحد الجانبين والميل أنواع ميل عن الحق وميل في الحكم (ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) جنح: في الغالب هو بداية الميل وليس ميلاً كاملاً. (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) بمعنى إن أبدوا استعداداً لأ للميل، وهذه الآية تؤكد على قدسية السلام في الدين فبمجرد أن يجنحوا للسلام فعلينا أن نميل مثلهم. السلام في الإسلام فرض ما دام العدو يريد أن يسالم وأعلن نيّته في ذلك. (ليس عليكم جناح فيما عرّضتم به من خطبة النساء) أي ليس عليكم إثم ولو كان قليلاً. زاغ: هو الميل من الصواب إلى الخطأ. (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم). الزيغ: هو النقص (وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) نقص في الصواب وزاغ الميزان بمعنى نقص. جنف: خاص بالحكم عندما يكون قاضياً أو حاكماً ويميل ميلاً خفيفاً عن الحق وليس هو الحكم بالظلم (ومن خاف من موص جنفاً). والجنف ليس إثماً أنما هو ميل خفيف كأن يميل قلب الأب للذكور عن الإناث أو الميل في خصومة. حنف: ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب (حنيفاً مسلماً). وحنفاء بمعنى لا يوجد لديهم أي ميل للشرك أو الخطأ وهو عكس الزيغ. راغ: ميل لكن باحتيال وهو ميل خفيّ مموّه (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) (فراغ عليهم ضرباً باليمين) (فراغ إلى أهله) من باب اللياقة إكرام الضيف أن يميل المضيف إلى أهله بطريقة خفيّة حتى يهيأ الطعام لضيفه. ومنها راوغ والمراوغة. عَدَلَ: كل ما تفعل شيء تغيّر عنه. عدل شيء مقابل شيء وعدل بمعنى مال مع اعترافه بأن ميله ليس صحيحاً (أمن خلق السموات والأرض... قوم يعدلون) يعدلون بمعنى الإيمان مستو في قلوبهم لكن لا يعلنونه لخوفهم. والعدل غير العدول يقال عدل عدلاً وعدل عدولاً وهو الميل عن الشيء وهو يريد أن يفعله لو أُتيح له ذلك. زلّ: ميل مرغم عليه ولا يقصده كما يقال في زلّة اللسان أو زلّة القدم. ويقال في الميل عن الصواب بشكل قاهر كاستعجال أو سوء فهم(فإن زللتم من بعد ما أراكم ما تحبون) (فأزلهم الشيطان) لحد: هو الميل إلى كتمان الحق. والملحد هو الذي مال إلى كتمان التوحيد وهو يعلم أن الله واحد ألحد: الميل إلى كتمان الحق وهو أخطر أنواع الميل. وأضيف هذه الكلمات التي قد تدخل في هذه المنظومة والله أعلم وهي كلمة نكب وكلمة جائر بمعنى مائل عن الحق. نكب: تعني مال أيضاً كما في قوله تعالى (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ)سورة المؤمنون آية 74. كل منظومة الميل هذه تتحدث عن بدايات الميل. ومراتب الشعور تدرج من الإدراك إلى الوجدان إلى النزوع فالشروع ثم بداية الميل فالاستحواذ وهو الذي يعاقب الله تعالى عليه. كل فعل محرّم لا يُحاسب عليه الإنسان إلا عند النزوع فيه إلا العلاقة بالمرأة تبدأ المحاسبة عليها من ساعة الوجدان. |
منظومة جنى
جنى – حصد – خضد - قطف كل هذه المفردات جاءت في القرآن الكريم للتحصيل الزراعي. ولكل منها معنى يختلف عن الآخر. جنى: تستعمل للفواكه الموسمية(وجنى الحنتين دان). حصد: عندما يكون الزرع يابساً وتستعمل كلمة حصاد للخير وحصيد للشر (حصيداً خامدين) خضد: عندما يقطع الزرع وهو أخضر رطب (في سدر مخضود) قطف: كل ما حلو المذاق والمنظر يقال قطف العنب والعسل. (قطوفها دانية). وكل هذه المصطلحات استعملت في القرآن في الجنة وما فيها من زرع وثمار. |
منظومة جهر
جهر – أعلن – أظهر – أذّن – أفاض هذه منظومة الإعلام العلني وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات: - بدا – برز – بزغ – طلع - بث – أذاع – نشر – بسط – أشاع - جهر – أعلن – أظهر – أفاض فيه – أذّن. جهر: أظهر الشيء بقة وشدة وليس كرفع الصوت وهي مأخوذة من الجهراء أو التربة الصلبة والمكان المرتفع الصخري. وكل صوت قوي وغليظ وشديد يسمى جهراً. (ولا تجهر بصلاتك) (ولا تجهروا له بالقول) (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم). والجهر تستعمل لحاسة السمع والبصر (أرنا الله جهرة) أي أمام العالم بدون حجاب، و الجهر بالسوء من القول بمعنى أن يسمع كل الناس ولذا لم تأتي الآية بكلمة التكلم بالسوء وإنما استعملت كلمة الجهر لأن هذا لا يقدر عليه الإنسان فقد يشتم الرجل زوجته لكن لا يسمعه أحد فالمكروه في الآية الذي يجهر بالسوء من القول أو الفعل بحيث يسمعه كثير من الناس. وفي الحديث الشرف: لعن الله المجاهرين. والجهر هو أن تتعمد إعلان الفاحشة والرذيلة والجريمة والفجور في كل مجلس. (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) ففي عبادة الله الأحرى عدم الجهر والخشوع والخشية وفي حالة الدعوة إلى الله فالجهر أولى وهو مستحب لأنه من أفضل العبادات أعلن: إعلان عن شيء كان سرّاً. (وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا) سورة نوح أظهر: إظهار ما كان مخفياً لا يعرفه إلا قلة من الناس (ليظهره على الدين كله). أظهره الله تعالى بعد أن كان متوارياً. والإظهار إعلان مع انتصار. أفاض فيه: أن تتكلم بكلام أكثر مما ينبغي وتضيف أشياء غير صحيحة (إذ تفيضون فيه) تكلموا كلاماً كثيراً غير الذي حصل مثل الفيضان. أذّن وآذن: إعلان بالنداء أيها القوم أو أيها الناس. (وأذنّ في الناس بالحج يأتوك رجالا) (ثم أذّن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) وأضيف هذه الكلمات التي قد تدخل والله أعلم في هذه المنظومة وهي أصدع (وأصدع بما تؤمر) |
منظومة جاوز
جاوز – عبر – قطع – سبق - سارع عبر: هو المرور أفقياً أو عرضياً كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) أي مثلاً يكون الماء خلف المسجد والشخص عابر السبيل لا يمر إلا عبر المسجد فيسمح له بالمرور ليصل إلى الماء) وفي هذه الآية قوله تعالى (لا تقربوا) تعني أن المنهي عنه مقدس فالشدة هنا نجاسة الخمورة. وكذلك قوله لا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنى أي لا تقربوا حتى مقدمات الفعل لا الفعل فقط. جاوز: المرور طولياً (الوسطية تخلّف الطريق وراءك) (فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً) (الكهف:62) (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (الاحقاف:16) (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (يونس:90) (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) (لأعراف:138) نسبها الله تعالى لنفسه لأن موسى عليه السلام كان قد قال (كلا إن معي ربي سيهدين) وهذه آية من آيات الله في كونه فهم سبحانه يعامل العباد بما يفعلوه الآن بغض النظر عمّا فعلوه سابقاً او ما سيفعلونه لاحقاً وهذا من رحمته بهم سبحانه. ولذا جاءت الآية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مع علمه أنهم سيرتدوا كافرين من بعد أن ينجيهم الله من الغرق ومن فرعون وقومه، ولذا لم يعاتبهم الله بعد هذا في السورة. أما في الآية الأخرى (فاقتلوا أنفسكم) عاتبهم الله تعالى لما نهاهم موسى عن اتخاذهم العجل كان مرجعيتهم العليا الشرعية فأطاعوه عندما أنّبهم على طلبهم بأن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة. أما في المرة الثانية فقد كان موسى في ميقاته مع ربه فلم يكن لبني إسرائيل مرجعية شرعية ولهذا اتخذوا عجلاً جسداً له خوار. قطع: تعني الوقت المستغرق لعبور الطريق. يقال قطعت الطريق في بضع ساعات أو عصراً. (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (العنكبوت:29) قطع السبيل هنا يؤدي إلى انقطاع الناس عن السير والسفر من حيث الزمن والكيف. وقطع الطريق يستغرق وقتاً مجهولاً وفي الغالب يكون ليلاً. سبق: استباق وتعني السرعة لاكتساب الفضل كل يريد أن يصل أولاً. وكل من سبق الآخر يُمدح (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (الحديد:21) (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) (الواقعة:10) (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) (المؤمنون:61) (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يّـس:40) سارع: السباق من المسارعة والسباق من أشد أنواع السرعة. فالمسارعة هي السبق من حيث السرعة. (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) (يسارعون في الخيرات) وأضيف هذه الكلمات التي قد تدخل في هذه المنظومة وهي والله أعلم: مرّ ومرور |
منظومة الجبت
جبت – طاغوت – رذل - زنيم - سفيه الجبت والطاغوت في القرآن الكريم هما صفتنا مذمومتان ومذموم من يوصف بهما. وفي القرآن الكريم نوعان من الكلمات المذمومة: مجموعة كلمات الظلم خسيسة: (الجبت الطاغوت، الرذل، السفيه) ومجموعة مذمومة ولكنها لا تعتبر خسيسة إنما فيها استعلاء: (عُتل، ظالم، متكبر، جبّار). الجبت: كل شيء يُعبد من دون الله من صنم أو راهب أو شمس أو قمر أو إنساناً كفرعون. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) (النساء:50) الطاغوت: هو كل من هو رأس ضلالة وكل من ليس له قيمة في مكانه مثل الساحر. الطاغية من حيث فعله والطاغوت من فعل طغو (الناس جعلوه طاغوتا) مثل فرعون لو لم يدّعي الألوهية لكان طاغية. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا) سورة النساء آية 60. (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) سورة النحل آية 36 الرذل: جمعه أراذل بمعنى النفاية. كل نفاية رذالة والرذل من الناس هو الدون والذي يُعتبر نفايتهم ويحتقره الجميع. وفي الحديث: ما استرذل الله عبداً إلا حصر عنه العلم والأدب. (قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) (الشعراء:111) (فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ) سورة نوح آية 27 الزنيم: ملحق بالقوم وليس منهم أي رجل بلا أصل ألحق نفسه بقوم. (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) (القلم:13) السفيه: نوعان: سفيه بالفعل وهو الذي لا يحسن التجارة وتصريف الأموال وقد ورد ذكره في القرآن مع التبذير وهو سفيه الدنيا. وسفيه القول وهو سفيه الآخرة لأنه سفيه القول والفكر. (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سفيهتا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً) (الجـن:4) (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء:5) وكل هذه الصفات التي ذكرناها لا تكون إلا لكافر. |
منظومة جبّار
جبّار – قاهر – متكبّر – عالي – مجرم- عتلّ –عاتي - طاغية كلمة جبّار وأخواتها في القرآن الكريم كلها تدل على الظلم والإستعلاء مع القوة. جبّار: هو الذي يُجبر نقصه بإجبار الآخرين على أن يكونوا مثله وهو إنسان ناقص ونتيجة ظروف معينة صار مسلّطاً على أناس كرام شرفاء فأذلهم. أن تكون جباراً يعني أن تحمل الغير على أن يفعل أو لا يفعل لتسدّ نقصاً فيك. في صفة العبد تعني إنسان ناقص لا يملك مؤهلات يتسلط بقوته فيبدأ يظلم الآخرين ويحملهم على فعل أو عدم فعل أشياء وفق أهواءه هو (وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (ابراهيم:15). أما في صفة الله تعالى فالجبار هو الذي يجبر نقص العبد فيعفو عن المذنب ويشفي المريض وغيره (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) سورة الحشر، آية 23. قاهر: يضاف إلى صفات الجبار صفة واحدة وهي الإذلال أي يتعمد إذلال الشرفاء الكرماء الذين يشعر بالنقص أمامهم فهو يجمع لهم الإرغام مع الإذلال (وأما اليتيم فلا تقهر) سورة الضحى، ولذا جاء في الحديث: "وأعوذ بك من قهر الرجال". أما في صفة الله تعالى فقد قهر عباده بالموت والبعث. (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (الأنعام:18) متكبر: نفس صفات جبار وقاهر ويضاف إليها الإعجاب بالنفس والزهوّ والتغني بالنفس. أما في حق الله تعالى فهو استحالة أن ينقاد لغيره سبحانه. (وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ) (غافر:27) متعالي / عالي: العالي هو الذي يُعجب بنفسه ويحتقر غيره في الوقت نفسه. (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ) (المؤمنون:46) المجرم: هو الذي يفتك بغيره بحيلة بمعنى قد يزيّن لغيره أنه صديق ثم يغدر بهم فهو إذن الذي يسبب الأذى لغيره بحيلة. وهناك فرق بين مجرم وجاني فالمجرم هو الذي يسبب الأذى بحيلة أما الجاني فهو الذي يسبب الأذى لكن بدون حيلة. (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (الأنعام:123) (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ بِآياتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) (يونس:75) عتُل: كل ما مضى من الصفات ويضاف إليها أنه يستطيع أن يستحوذ على غيره استحواذاً كاملاً تاماً بحيث لا يفلتون منه. (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) (القلم:13) عاتي: من العتو وهي كل الصفات السابقة بالإضافة إلى كونه لا يُرجى صلاحه (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا) سورة الفرقان، آية 21 (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) سورة مريم، آية 8 (عتيا هنا بمعنى لا صلاح فيه) طاغية: كل ما مضى ويضاف إليها أنه برفض أي منطق حق أو برهان (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى) سورة طه، آية 43 وأضيف كلمة أشِر التي قد تدخل في هذه المنظومة والله أعلم (سيعلمون غداً من الكذّاب الأشر) |
منظومة جثّ
جثّ (اجتثّ) – قطع – قلع – نزع - صرم كل كلمات هذه المنظومة تعني القطع والقلع عموماً لكن لكل منها معنى منفرداً بها لا يكون لغيرها من الكلمات. اجتث: الجث يقال عندما تكون الشجرة بالية واهية والجذور واهنة فلم يعد لها قيمة بل المطلوب التخلص منها. ولهذا كلمة الكفر تافهة مهما كانت جذورها عيمقة لكنها واهنة والإجتثاث يكون من الجذور. أما الإسلام فهو كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) (ابراهيم:26) والإجتثاث من الجثة بمعنى الجسد بلا روح. قلعت من فوق الأرض لأن جذورها واهنة تُقتلع بلا مشقة. والإجتثاث عموماً هو قطع الشيء الواهن من الجذر الواهن. القلع: يقال للشجرة المثمرة الحيّة لنقلها إلى مكان آخر. وقوله تعالى يا سماء أقلعي بمعنى نقل المطر إلى مكان آخر. (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (هود:44) أما الإقلاع: ترك الشيء لانشغاله بشيء آخر. أما الترك فهو ترك الشيء لزهده فيه أو فشله فيه او لرداءته. قطع: نزع جذع الشجرة من فوق الجذور بحيث يبقى الجذر في الأرض. والقطع يُعدّ تخريباً. (لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) الواقعة آية 33. (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ) سورة يوسف، آية 31 النزع: يقال لشيء تلبّس بغيره مثل شجرة ملتفّة الأغصان التفّت تماماً على شجرة أخرى. ولهذا استعملت كلمة النزع مع الملك في القرآن الكريم (تنزع الملك ممن تشاء) لأن المالك حريص على ملكه حرصاً شديداً. وفي قوله (والنازعات غرقاً) لأن الكافر متمسك بحياته الدنيا وعند خروج روحه تُنزع نزعاً لحرصه عليها. وفي قصة موسى (ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) المعجزة هي سحب يده بصعوبة من جيبه. الصرم: قطع الثمر فقط. (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) (القلم:17) |
منظومة جثا
جثا – جثم – قعد – جلس – اتكأ – استند – خلد - استوى جثا: الجلوس على الركبة ولا يكون إلا من خوف أو تضرع أو تذلل. قد يكون الجثو في النار (ونذر الظالمين فيها جثيا) أو في ساعة المحشر في ساعة الحشر يؤتى بالنار فما من أحد يراها إلا يجثو على ركبتيه من الخوف. حتى الصالحون حينما يرون هول المحشر يجثون على الركب في ساعة الحساب (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) سورة الجاثية، آية 28. أو من شدة الخوف يجثو الإنسان على ركبتيه. (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً) (مريم:68) جثم: الجاثم يأخذ هيئة الجلوس ولكنه ثقيل جداً فيبدو كأنه التصق بالأرض. شديد الثقل الذي وقع قفاه أو استه على الأرض فلا يقوم لضخامته جثته. ولذا يقال جثمان لأنه صار ثقيلاً جداً. (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (لأعراف:78) جلس: إذا كان الشخص واقفاً فجلس وعكسها وقف. وهي حركة يومية كل واقف يجلس فيجلس للحكم والقضاء والعلم والراحة من وقوف طويل. قعد: عكسها قام وهو ليس حركة يومية لكنها تدل على هيئة وعمل معين. القيّم والقائم والقوام وعكسه المتخاذل والبليد. (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً) (الجـن:9) (وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة:90) والمتخلف عن الخير يقال له قاعد (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين). والقعود من التخاذل وليس للراحة (وقيل اقعدوا مع القاعدين). ويقال قام فلان للشيء إذا صار راعياً لشؤونه (يذكرون الله قياماً وقعوداً) (أي في حالتي الإنهماك بالعمل والراحة) أي في حال النشاط والعزم والجد كالمجاهد والتاجر وفي حال الراحة أو التعب والكسل والمرض والنعس. فالقيام ليس وقوفاً لكنه أن تكون مشغولاً ومنهمكاً في عمل هام مثل قيام الليل فلم يقل وقوف الليل. مثال أن يقال أناس قاموا بالحرب وآخرين قعدوا عن الجهاد. اتكأ: الإتكاء يكون للراحة والترف والسعادة ودليل الأبهة والرفعة والراحة (متكئين على فرش بطائنها من استبرق) (هم وأزواجهم على الأرائك متكئين) (مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً) (الانسان:13) استند: تقال في حال الضعف بمعنى يسند حتى لا يقع (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (المنافقون:4). والإتكاء والإستناد جلسة. والمهموم لا يتكيء إنما يجثوعلى ركبتيه. استوى: جلس متمكناً مع سيطرة كاملة (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك). استوى على العرش: الإستواء لله تعالى تأتي بمعنى استولى لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وليس فعله كفعل أي من البشر. (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً) (الفرقان:59) (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طـه:5) وأضيف كلمتي اثّاقل وثبّط إلى هذه المنظومة والله أعلم. |
منظومة جحد
جحود –كنود - كفران – نكران - خداع كل هذه الكلمات تدخل في منظومة الإنكار. جحد (الجحود): هو كل ما تنكره بلسانك ولكن القلب يثبّته (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) (وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (هود:59) الكنود: هو الإنكار بالقلب واللسان (إن الإنسان لربه لكنود) مثل قوم فرعون والشيوعيين والوثنيين وكل من ينكر وجود الخالق ونعمه والأديان. ويقال في اللغة أرض كندة أي أنها لا تصلح للزراعة مطلقاً، وأرض نكدة أي صالحة للزراعة ولكن لا يخرج زرعها إلا نكدا أي بصعوبة ومشقة. النكران: هو الإقرار بالشيء أولاً ثم إنكاره لاحقاً. (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) (وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ) (غافر:81) (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ) (الرعد:36) الكفران: الكفر والكفران يقال كفر للدين والكفران للنعمة. وهو يعني الإعتراف بالشيء مع التقليل من أهميته. وكفران النعمة هو إهمال قيمتها وعدم شكرها فكل من لا يشكر النعمة فهو كفران (فلا كفران لسعيه) (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً) (فاطر:39) ومثل الزوجة إن غضبت من زوجها لأمر ما تنسى فضله ونعمه وهو ما يسمى بكفران العشير. الخُداع: هو التظاهر بقبول النعمة ولكن في الباطن مختلف وتفعل ضده، أي إظهار غير ما يبطن. الباطن غير الظاهر مما يشوّه وجه الحياة الناصعة ويثير الخلاف. والخداع كفر وزيادة وهو صفة المنافقين (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (البقرة:9). وهو أخطر أنواع النكران فالجحود والنكران والكفران معدود أما الخداع فكثير (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقد يكون من السهل خداع الناس ممن لا يعرفون ألاعيب المخادع أما أن يخدع الله تعالى وهو أعلم بالسرائر فهذا أمر عظيم.كالمنافق يقوم للصىة إذا كان الناس ينظرون إليه لذا جاءت الآية (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) وهؤلاء المنافقون لم يعاقبهم الله تعالى ظاهراً في الحياة الدنيا لأنهم يقومون بما يتماشى مع الدين فأجرى الله تعالى عليهم أحكام الإسلام وعصم دماءهم لأنهم قالوا بلسانهم كلمة الإيمان والإسلام ولكن في الآخرة قد أعد الله تعالى لهم جهنم وساءت مصيرا (في الدرك الأسفل من النار). "بين يدي الساعة سنون خدّاعة يصدق فيها الكافر ويكذب فيها الصادق يخوّن فيها الأمين ويؤمّن الخائن.." حديث شريف. يقال خداع الضبّ أي لا يدخل الغار إذا كان فيه عقرب. |
منظومة جدث
جدث – قبر - لحد هذه الكلمات هي مرادفات كلمة القبر ومنها أيضاً: لحي – ريم – رمس ولكنها لم ترد في القرآن الكريم. القبر: هو بيت الجثة باعتبار عمقه وكل شيء يدفن دفناً عميقاً يسمى قبراً. (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) (عبس:21) الجدث: هو القبر الذي صار عمقه ذاهباً بفعل الزمن. (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) (يّـس:51) اللحد: هو الجزء من القبر الذي توضع فيه الجثة كونه مائلاً. والإلحاد هو الميل من مال عن التوحيد فهو ملحد. فالقبر عميق والجزء المائل منه هو اللحد. وتقال كلمة الضريح عندما يكون اللحد في الوسط. القبر بكل أسمائه لفظ يجد وقعاً قوياً ومخيفاً في النفس البشرية ولا يمكن أن يكون محبوباً إلا من عرف فلسفة الموت وحقيقته. والقبر قبران: قبر دنيوي: وهو مقر الجسد الفاني الطيني الذي سوف يفنى، عند الموت تنتهي العلاقة بالجسد ويصبح الجسد غير صالح لبقاء الروح فيه فتفارقه وينتهي دوره ثم يدفن ويتحلل ويعود إلى عناصره الأولى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) (ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر). وهناك فرق بين فعل قبر وأقبر: قبر تعني إذا وضعت الجثة بيدك أنت، أما أقبر تأتي بمعنى أن تهيأ له قبراً بقدرة الله المطلقة وبفعله (ثم أماته فأقبره). العبد يقبِر والله تعالى أقبر والإقبار هو من فعل الله تعالى ولا يستطيعه البشر، الله تعالى أقبر روحه فالروح خالدة فالروح موجودة قبل خلق البدن وبعد فناء البدن تسكن في الجسد الأثيري.وكل الناس خُلقوا بأرواحهم يوم خلق آدم مصداقاً لقوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى). الروح الخالدة تبقى في مكانها الذي أعدّه الله تعالى لها والموت يكون للنفس البشرية وليس للروح وبعد فناء الجسد تحل الروح في الجسد الأثيري وهو الذي رآه الرسول في ليلة الإسراء والمعراج كما في الحديث عن البخاري: أن الرسول رأى كل ذرية آدم في الإسراء والمعراج. قبر برزخي: قال رجل من الأحبار للرسول : يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض قال : في الظلمة دون الجسر فقال أشهد أنك رسول الله. والصراط هو مركز الكون والأرواح تصعد من مكانها في قبرها البرزخي. والعذاب يكون في القبر البرزخي أي في القبر الذي أقبره الله تعالى فيه. وقال ابن حزم أن مستقر الأرواح بعد الموت هو نفس مستقرها قبل خلق آدم . ومن العبادات التي يجب القيام بها من مات له ميت: غسل الميت وحفر القبر كما جاء في الحديث الشريف عن جابر: من غسّل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن كفّن ميتاً كساه الله من سندس الجنة. وعن أبي ذر قال رسول الله : زرورا القبور تذكروا بها الآخرة. والأحاديث في فضل تتبع الجنازة عديدة لما فيه من الأجر والثواب. ونهانا الرسول عن الجلوس على القبور. |
مشكر اخى الكريم
جهد كبير ورائع |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.