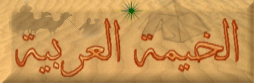
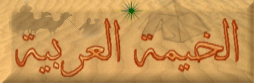 |
12ـ مَواضعُ (أَنَّ) المفْتوحةِ الهمزة وجوباً
تُفتحُ همزةُ (أنّ) وجوباً حيثُ يجبُ أن يؤوَّلَ ما بعدَها بمصدرٍ مرفوع أو منصوبٍ أو مجرور. وذلك في أحدَ عشرَ موضعاً: فيؤوَّل ما بعدها بمصدرٍ مرفوعٍ في خمسة مواضع: أ ـ أن تكون وما بعدها في موضع الفاعل، نحو: (بلغني أنك مجتهدٌ) ومنه قولهُ تعالى: {أَولم يَكْفِهم أنَّا أنزلنا عليكَ الكتاب}. ومن ذلك أن تقع بعد (لَوْ)، نحو: (لو أنك اجتهدتَ لكان خيرٌ لك)، [والتقدير: (لو ثبت اجتهادك)، فما بعد أن في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف تقديره (ثبت)] ومنه قولهُ تعال: {ولو أنهم آمنوا واتقَوْا لمثوبة من الله خيرٌ}. ومن ذلك أن تقع بعد (ما) المصدريّة الظَّرفيَّة، نحو: (لا أُكلمك ما أنك كسُولٌ)، ومنه قولُهُمْ: (لا أُكلِّمهُ ما أنَّ حراءً مكانَه) او (ما أنَّ في السماءِ نجماً). [حراء: جبل بمكة] ب ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ نائب الفاعل، نحو: (عُلمَ أنك منصرفٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {قُل: أُوحِيَ إلي أنه استمعَ نفَرٌ من الجن}. ج ـ أن تكونَ هي وما بعدها في موضع المبتدأ، نحو: (حَسَنٌ أنك مجتهدٌ)، [والتأويل: حسن اجتهادك، فحسن خبر مقدم واجتهادك مبتدأ مؤخر.] ومنهُ قولهُ تعالى: {ومن آياته أنك تَرى الأرض خاشعةً}. د ـ أن تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنًى واقعٍ مبتدأ أو اسماً لأنَّ، نحو: (حَسبُكَ أنكَ كريمٌ)، ونحو: (إن ظني أنك فاضلٌ). فإن كان المخبَرُ عنهُ اسمَ عينٍ وجب كسرُها، كما تقدَّمَ، لأنك لو قلت: (خليلٌ أنهُ كريمُ)، بفتحها، لكانَ التأويلُ: (خليلٌ كرَمُهُ)، فيكونُ المعنى ناقصاً. هـ ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ تابعٍ لمرفوعٍ، على أنه معطوفٌ عليهِ أو بَدَلٌ منه، فالأول نحو: (بلغني اجتهادُك وأنكَ حَسَنُ الخُلُق)، والثاني نحو: (يُعجبُني سعيدٌ أنهُ مجتهدٌ). وتُؤَوَّلُ بمصدرٍ منصوبٍ في ثلاثةِ مواضعَ: أ ـ أن تكون هي وما بعدها في موضع المفعول به، نحو: (علمتُ أنكَ مجتهدٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {ولا تخافون أنكم أشركتم باللهِ}. ومن ذلك أن تقع بعد القول المتَضمّنِ معنى الظنّ، كما سبق. ب ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ خبرٍ لكانَ أو إحدى أخواتها، بشرطِ أن يكون اسمُها اسمَ معنًى، نحو: (كانَ عِلمي، أو يَقيني، أنك تتَّبعُ الحقَّ). ج ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ تابعٍ لمنصوبٍ، بالعطف أو البَدَليّة فالاوَّلُ نحو: (علمتُ مجيئَكَ وأنكَ مُنصرفٌ)ومنهُ قولهُ تعالى: {اذكروا نِعمتيَ التي أنعمت عليكم، وأني فَضَّلتكم على العالمين}، والثاني نحو: (احترمتُ خالداً أنه حَسَنُ الخُلقْ" ومنه قولهُ تعالى: {واذْ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين انها لَكُم}. وتؤَوَّلُ بمصدرٍ مجرورٍ في ثلاثة مواضعَ أيضا: أ ـ أن تقعَ بعد حرف الجر، فما بعدَها في تأويل مصدرٍ مجرورٍ به، نحو: (عَجبتُ من أنكَ مُهملٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {ذلكَ بأن اللهَ هوَ الحقُّ}. [والتأويل: عجبت من إهمالك] ب ـ أن تقعَ مع ما بعدها في موضعِ المضاف إليه، نحو: (جئتُ قبلَ أنَّ الشمسَ تَطلُعُ)، ومنه قوله تعالى: {وإنه لحَقٌّ مثلما أنكم تَنطِقون}. ج ـ أن تقع هي وما بعدها في موضع تابعٍ لمجرورٍ، بالعطف او البَدَليةِ، فالأول نحو: (سُررتُ من أدَبِ خليلٍ وأنه عاقلٌ)، والثاني نحو: (عَجبتُ منهُ أنهُ مُهملٌ). 13ـ الْمَواضِعُ التي تَجوزُ فيها (إِنَّ وأَنَّ) يجوزُ الأمران، كسر همزة (إنَّ) وفتحُها، حيثُ يَصح الاعتباران: تأويلُ ما بعدها بمصدرٍ، وعدمُ تأويلهِ. وذلك في أربعة مواضع: أ ـ بعد (إذا) الفُجائيّةِ، نحو: (خرجتُ فإذا إنَّ سعيداً واقفٌ). (فالكسر هو الأصل، وهو على معنى (فإذا سعيد واقف) والفتح على تأويل ما بعدها بمصدر مبتدأمحذوف الخبر، والتأويل (فإذا وقوفه حاصل)). وقد رُوي بالوجهينِ قولُ الشاعر: وكُنْتُ أَرَى زَيْداً، كما قيلَ، سَيِّداً إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ الْقَفا واللَّهازِمِ (فالكسر على معنى: (فإذا هو عبد القفا). والفتح على معنى (فإذا عبوديته حاصلة). [اللهازم: جمع لهزمة واللهمزتان: عظمتان تحت الأذن. يريد أنه ليس سيداً، وكنى عن ذلك بأنه يُضرب على قفاه ولهزمتيه] ب ـ أن تقعَ بعدَ فاءِ الجزاءِ، نحو: (أن تجتهدْ فإنكَ تُكرَمُ). وقد قرئ بالوجهين قولهُ تعالى: {مَنْ يُحادِدِ اللهَ ورسولَهُ فانَّ لهُ نارَ جهنمَ}. وقولهُ: {مَن عملَ منكم سُوءًا بِجهالةٍ، ثمَّ نابَ من بعدهِ وأصلح، فانهُ غفورٌ رَحيمٌ}. (فالكسر على جعلها جملة الجواب. والفتح على أن ما بعدها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير في المثال: (إن تجتهد فإكرامك حاصل). والتقدير في الآية الأولى (فكون نار جهنم له أو ثابت أو حاصل) والتقدير في الآية الأخرى: {فمغفرة الله حاصلة له}. وتكون جملة المبتدأ المؤول وخبره المحذوف جواب الشرط). ج ـ أن تقعَ مع ما بعدها في موضعِ التَّعليلِ، نحو: أكرمه، انّهُ مُستحِقٌّ الإكرامِ، وقد قرئ بالوجهينِ قولهُ تعالى: {صَلِّ عليهم، إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم}. (فالكسر على أنها جملة تعليلية. والفتح على تقدير لام التعليل الجارة أي: لأنه ولأن صلاتك. والتأويل في المثال: (أكرمه لاستحقاقه الإكرام)، وفي الآية: (صل عليهم لتسكين صلاتك إياهم)، والسكن (بالتحريك) ما يسكن إليه، ويفسر أيضا بالرحمة والبركة). د ـ أن تقعَ بعدَ (لا جَرَمَ) نحو: (لا جَرَمَ انكَ على حَقٍّ). والفتح هو الكثير الغالبُ. قال تعالى: {لا جَرَمَ أنَّ اللهَ يَعلَمُ ما يُسِرُّونَ}. (ووجه الفتح أن تجعل ما بعد (أن) مؤولاً بمصدر مرفوع فاعل لجرمَ. وجرم: معناه حقَّ وثبتَ. وأصل الجرم القطع، وعلمُ الله بالأشياء مقطوعٌ به لأنه حق ثابت. و (لا) حرف نفي للجواب، يرد به كلام سابق. فكأنه قال: (لا)، أي: ليس الأمر كما زعموا، ثم قال: (جرم أن الله يعلم) أي: (حق وثبت علمه). وقال الفراء: لا جرم بمعنى (لا بد)، لكن كثر في الكلام، فصار بمنزلة اليمين، لذلك فسرها المفسرون: حقاً: وأصله من جرمت: بمعنى كسبتُ. فتكون (لا) على رأيه نافية للجنس. و (جرم) اسمها مبني على الفتح، وما بعد (أن) مؤول بمصدر على تقدير(من)، أي: لا جرم من أن الله يعلم، أي: لا بد من علمه. ووجه الكسر: أن من العرب من يجعل (لا جرم) بمنزلة القسم واليمين، نحو: (لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت). فمن جعلها يميناً كسر همزة (إن) بعدها نحو: (لا جرم إنك على حق)، وجعل جملة (إن) المكسورة واسمها وخبرها. جواب القسم. وعلى من جعلها يميناً فإعرابها كإعراب (لا بد) وقد أغنى جواب القسم عن خبرها. وقد علمت انه حيث جاز فتح (أن) وكسرها، فالكسر أولى وأكثر، لأنه الأصل، ولأنه لا تكلف فيه، إلا إذا وقعت بعد (لا جرم) فالفتح هو الغالب الكثير، وان نزّلتها منزلة اليمين، لأنها في الأصل فعل). 14ـ تخفيفُ "إنَّ وأَنَّ وكأنَّ ولكنَّ". يجوزُ أن تُخفَّفَ (إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ) بحذف النون الثانية، فيقال: (إنْ وأنْ وكأنْ ولكنْ). |
15ـ (إنْ) المخففة المكسورة
إذا خُفّفت (إنَّ) أُهمِلتْ وجوباً، إن ولِيَها فعلٌ، كقوله تعالى: {وإن نَظنكَ لَمِنَ الكاذبين}. فان ولِيَها اسمٌ فالكثيرُ الغالبُ إهمالها، نحو: (إن أنتَ لصادقٌ)، ويَقِلُّ إعمالها، نحو: (إنْ زيداً مُنطلِقٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وإنْ كُلاً لمَا ليوَفينَّهم ربكَ أعمالهم}، في قراءَة من قرأ: (إنْ ولَمَا) مخفّفتينِ. [لما: هي لام الابتداء، و (ما) زائدة للتوكيد، واللام في (ليوفينهم): هي اللام الموطئة للقسم، دخلت على جوابه، وجملة الجواب سادّة مسّد الخبر] ومتى خُففت وأُهمِلَت لزمتها اللامُ المفتوحةُ وجوباً، نحو: (إنْ سعيدٌ لمجتهد) تَفرقةً بينها وبين (إنْ) النافيةِ، كيلا يقع اللبسُ. وتُسمّى (اللامَ الفارقةَ). فان أُمِنَ اللَّبس جاز تركُها، كقوله: أَنا ابنُ أُباةِ الضَّيْمِ منْ آلِ مالِكٌ وإِنْ مالكٌ كانتْ كِرامَ الْمَعادِنِ [المعادن: الأصول] لأن المقامَ هنا مَقامُ مَدح، فيمنعُ أن تكونَ (إنْ نافيةً، وإلا انقلبَ المدحُ ذَماً). وإذا خُففت لم يَلِها من الأفعال إلا الأفعالُ الناسخةُ لحكم المبتدأ والخبر (أي التي تَنسَخُ حُكمهما من حيثُ الإعرابُ. وهي كانَ وأخواتُها، وكادَ وأخواتُها، وظنَّ وأخواتُها). وحينئذٍ تدخلُ اللامُ الفارقةُ على الجزءِ الذي كان خبراً. والأكثر أن يكونَ الفعلُ الناسخُ الذي يليها ماضياً، كقوله تعالى: {وإِنْ كانت لكبيرةً إلاّ على الذينَ هدى اللهُ}، وقوله: {قال تاللهِ إن كِدتَ لَتُردِينِ}، وقولهِ: {وإن وجدنا أكثرَهم لَفاسقينَ}. وقد يكونُ مضارعاً كقوله سبحانهُ: {وإن نظنكَ لَمِنَ الكاذبين}. ودخولُ (إنْ) المخفّفَة على غير ناسخٍ من الأفعال شاذ نادرٌ، فما وردَ منه لا يُقاسُ عليه، كقولهم: (إنْ يَزينُكَ لنَفسُكَ، وإنْ يشينُكَ لهِيَهْ). 16ـ (أنْ) المُخفَّفَةُ المفتوحة أذا خُفّفت (أن) المفتوحةُ، فمذهبُ سيبويه والكوفيين أنها مُهمَلةٌ لا تعمل شيئاً، لا في ظاهر ولا مُضمر، فهي حرفٌ مصدري كسائر الأحرف المصدرية. وتدخلُ حينئذٍ على الجملِ الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهرُ أنه الحقُّ. وهو مذهبٌ لا تكَلُّفَ فيه. واعلم أنَّ (أنَّ) المخفّفةَ، إن سبقها فعل، فلا بُدَّ أن يكونَ من أفعال اليقينِ أو ما يُنزَّلُ منزلَتها، من كل فعل قلبيٍّ، يُرادُ به الظنُّ الغالبُ الراجح. فالأول كقوله تعالى: {عَلِمَ أنْ سيكونُ منكم مَرْضى}، ومنه قول الشاعر: إذا مِتُّ فادفنِّي إِلى جَنْبِ كرْمةٍ تُرَوِّي عظامي بعْد مَوتي عُروقُها ولا تَدفِنَنِّي في الْفَلاةِ، فإنَّني أحافُ إِذا ما مِتُّ، أَن لا أذُوقُها فخوفهُ أن لا يذوقها بعدَ مماته يقينٌ عنده، مُتحققٌ لديهِ. والثاني كقوله تعالى: {وظنُّوا أنْ لا مَلجأ من اللهِ إِلاّ إليه} وقولهِ: {أيحسَبُ أن لم يَرَهُ أحدٌ}. فائدة (إذا وقعت (أن) الساكنة بعد فعل يفيد العلم واليقين، وجب أن تكون مخففة من (أن) المشددة. وأن يكون المضارع بعدها مرفوعاً، كما رأيت. ولا يجوز أن تكون (أن) الناصبة للمضارع. وان وقعت بعد فعل يدل على الظن الراجح، جاز أن تكون مخففة من (أن) المشددة فالمضارع بعدها مرفوع، وجاز أن تكون (أن) الناصبة للمضارع، فهو بعدها منصوب. وقد قريء بالوجهين قوله تعالى: {وحسبوا أن لا تكون فتنة}، بنصب (تكون) على أن (أن) هي الناصبة للمضارع، ورفعه على أنها هي المخففة من (أن) المشددة. وذلك لأن (أن) الناصبة للفعل المضارع تستعمل في مقام الرجاء وللطمع فيما بعدها، فلا يناسبها اليقين، وإنما يناسبها الظن، فلم يجز أن تقع بعد ما يفيد اليقين. و (أن) المخففة هي للتأكيد، فيناسبها اليقين. ولما كان الرجاء والطمع يناسبهما الظن، جاز أن تقع بعده (أن) الناصبة للمضارع المفيدة للرجاء والطمع. وإنما جاز أن تقع (أن) المخففة المفيدة للتأكيد. إذا كان ظناً راجحاً، لأن الظن الراجح يقرب من اليقين فينزل منزلته). واعلم أنَّ (أن) المخفّفَة لا تدخل إلا على الجمل، عند من يُهملهُا وعند من يُعمِلُها في الضمير المحذوف، إلا ما شذ من دخولها على الضمير البارز في الشعر للضّرورة، وقد علمت أنه نادر مخالفٌ للكثير المسموع من كلام العرب. والجملةُ بعدها إمَّا اسميَّةٌ، وإما فعليَّة. فان كانت جملةً اسميَّة أو فعليَّة فعلُها جامدٌ، لم تحتجْ الى فاصل بينها وبين (أنْ) فالاسمية كقوله تعالى: {وآخِرُ دعواهُم أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين}. والفعليَّةُ، التي فعلُها جامدٌ، كقوله سبحانهُ: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقولهِ: {وأن عسى أن يكونَ قد اقتَربَ أَجلُهم}. وإن كانت الجملةُ بعدها فعليّةً، فعلُها متصرّفٌ، فالأحسن والأكثر أن يُفصلَ بينَ (أنْ) والفعلِ بأحدِ خمسة أشياءَ: أ ـ قد، كقوله تعالى: {ونَعْلَمَ أنْ قد صَدقتَنا ب ـ حرف التّنفيسِ: (السينُ أو سوف) فالسينُ كقوله تعالى: {عَلِمَ أنْ سيكونُ منكم مَرضى}، وقولِ الشاعر: زَعَمَ الْفَرزْدَقُ أنْ سَيَقْتُلُ مِرْبَعاً أَبشِرْ بطول سَلاَمةٍ يا مِرْبَعُ وسوف، كقول الآخر: واعلمْ، فَعِلْمُ الْمَرء يَنْفَعُهُ، أن سَوْفَ يأْتي كُلُّ ما قُدِرا ج ـ النفي بِلَنْ أو لم أو لا، كقوله تعالى: {أيحسَبُ الإنسانُ أنْ لنْ نجمَعَ عظامَهُ} وقوله: {أيحسَبُ أنْ لم يرَهُ أحَدٌ}، وقولهِ: {أفلا يَرَوْنَ أنْ لا يرجِعُ إليهم قَوْلاً}. د ـ أداةُ الشرطِ، كقوله تعالى: {وقد نَزَّلَ عليكم في الكتاب أنْ إذا سمعتُم آياتِ الله يُكفَرُ بها ويُسْتهزأ بها، فلا تَقعُدوا مَعَهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرِهِ} وقولهِ: {وأن لوِ استقاموا على الطريقة لأسقيناهُم ماءً غَدَقاً}. هـ ـ رُبَّ كقول الشاعر: تَيَقَّنْتُ أَنْ رُبَّ امرئ، خِيلَ خائناً أَمينٌ، وخَوَّانٍ يُخالُ أَمِينا 17ـ كَأَنْ المُخَفّفة إذا خفّفت (كأن)، فالحقُّ (على ما نرى) أنها مُهمَلةٌ، لا عمل لها. وعلى هذا الكوفيون. وهو قولٌ لا تكلفَ فيه. وعلى كلِّ حالٍ فيجبُ أن يكون ما بعدها جملةً، فان كانت اسميّة لم تحتج الى فاصل بينها وبين (كأن) كقوله: وصَدْرٍ مُشْرِقِ اللّوْنِ كَأَنْ ثَدْياهُ حُقّان وإن كانت جملةً فعليّة، وجب اقترانُها بأحدِ حرفينِ: أ ـ قد، كقول الشاعر: َزفَ التّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكابَنا لما تزُلْ برحالِنا، وكَأَنْ قَدِ وقول الآخر: لا يَهُولَنَّكَ اصْطِلاءُ لظى الحرْ بِ، فمحذُورُها كَأَنْ قَد أَلَما ب ـ لم، كقوله تعالى: {كأن لم تَغْنَ بالأمسِ} 18ـ لكن المخففة إذا حُفّفت (لكنَّ) أهملت وجوباً عند الجميع، ودخلت على الجُمل الاسميّةِ والفعليّة، نحو: (جاء خالدٌ، لكنْ سعيدٌ مسافرٌ. وسافرَ عليٌّ لكنْ جاء خليلٌ) |
(لا) النافية للجنس
(لا) النافية للجنس هي التي تدلُّ على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي: يرادُ بها نفيُهُ عن جميع أفراد الجنس نصّاً؛ لا على سبيل الاحتمال. ونفيُ الخبرِ عن الجنس يَستلزمُ نفيَهُ عن جميع أفراده. وتُسمّى (لا) هذهِ (لا التّبرِئَةِ) أيضا، لأنها تُفيدُ تبرئةَ المتكلّم للجنس وتنزيهَهُ إياهُ عن الاتصاف بالخبر. وإِذْ كانت للنفي على سبيل الاستغراقِ، كان الكلامُ معها على تقدير (منْ)، بدليلٍ ظهورِها في قول الشاعر: فَقامَ يَذودُ النَّاسَ عنها بِسَيْفِهِ وقالَ: أَلاَ، لا من سَبيلٍ إلى هِندِ فاذا قلت: (لا رجل في الدار)، كان المعنى: لا من رجل فيها، أي: ليس فيها أحد من الرجال، لا واحد ولا أكثر. لذلك لا يصح أن تقول: (لا رجل في الدار، بل رجلان أو ثلاثة) مثلاً، لأن قولك: (لا رجل في الدار) نص صريح على نفي جنس الرجل فقولك بعد ذلك: (بل رجلان) تناقض. بخلاف (لا) العاملة عمل (ليس). فإنها يصح أن ينفى بها الواحد، وأن ينفى بها الجنس لا على سبيل التنصيص، بل على سبيل الاحتمال فإذا قلت: (لا رجل مسافراً) صح أن تريد أن ليس رجل واحد مسافراً، فلك أن تقول بعد ذلك: (بل رجلان) وصح أن تريد أنه ليس أحد من جنس الرجال مسافراً. وكذلك السامع له أن يفهم نفي الواحد ونفي الجنس لأنها محتملة لهما. وستقف على مزيد بيان لهذا الموضوع). وفي هذا الفصل خمسةُ مباحث: أولاً: عملُ (لا) النافيةِ للجنْسِ وشُروطِ إعمالِها تعملُ (لا) النافيةُ للجنس عملَ (إنّ)، فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبر، نحو: (لا احدَ أغيرُ من الله). وإنما عملتْ عملَها، لأنها لتأكيد النفيِ والمبالغةِ فيه، كما أنَّ (إنّ) لتأكيد الإثبات والمبالغة فيه. ويُشترطُ في إِعمالها عملَ (إنّ) أربعة شروط: أ ـ أن تكونَ نصّاً على نفيِ الجنسِ، بأن يُرادَ بها نفيُ الجنس نفياً عامّاً، لا على سبيلِ الاحتمال. (فإن لم تكن لنفي الجنس على سبيل التنصيص، بأن أريد بها نفي الواحد، أو نفي الجنس على سبيل الاحتمال، فهي مهملة. وما بعدها مبتدأ وخبر، نحو: (لا رجل مسافر) ولك أن تعملها عمل (ليس) نحو: (لا رجل مسافراً) وإرادة نفي الواحد أو الجنس بها هو أمر راجع الى المتكلم، أما السامع فله أن يفهم أحد الأمرين). ب ـ أن يكون اسمها وخبرُها نكرتين. (فان كان المسند إليه بعدها معرفة أهملت ووجب تكرارها، نحو: (لا سعيد في الدار ولا خليل)). وقد يقعُ اسمُها معرفةً مُؤَوّلةً بنكرةٍ يرادُ بها الجنسُ، كأن يكونَ الاسمُ عَلَماً مُشتهراً بصفةٍ (كحاتمٍ المُشتهرُ بالجود، وعَنترةَ المشتهر بالشجاعة، وسَحبانَ المشتهرِ بالفصاحة، ونحوهم ) فيُجعلُ العلمُ اسم جنسٍ لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهرَ بهِ ذلك العلَمُ، كما قالوا: (لكل فرعونٍ موسىً)، بتنوينِ العلَمينِ، مُراداً بهما الجنسُ، أي: (لكلِّ جبّارٍ قهّارٌ). وذلك نحو: (لا حاتم اليومَ، ولا عنترةَ، ولا سحَبانَ). والتأويلُ: (لا جَوادَ كحاتم، ولا شجاعَ كعنترةَ، ولا فصيحَ كسَحبانَ)، ومنه قولُ الراجز: لا هَيْثَمَ اللَّيلةَ للِمَطِيِّ ولا فَتى إِلاَّ ابنُ خَيبَريِّ أي: لا حاديَ حَسَنَ الحُداءِ كهيثم، ومنه قول عُمرَ في عليّ (رضي الله عنهما): (قضيّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها)، أي: هذهِ قضيّةٌ ولا فيصلَ لها يَفصِلُها. وقد يُرادُ بالعلَم واحدٌ مما سُميَ به كقول الشاعر: ونَبْكي على زَيْدٍ، ولا زَيْدَ مِثْلُهُ بَرِيءٌ منَ الحُمَّى سَليمُ الجَوانِحِ ج ـ أن لا يفصلَ بينها وبين اسمها بفاصل. (فإذا فصل بينهما بشيء، ولو بالخبر، أهملت، ووجب تكرارها، نحو: (لا في الدار رجل ولا امرأة). وكان ما بعدها مبتدأ وخبراً). د ـ أن لا يدخل عليها حرفُ جرّ. (فإن سبقها حرف جر كانت مهملة، وكان ما بعدها مجروراً به، نحو: (سافرت بلا زاد) و (فلان يخاف من لا شيء)). ثانياً: أَقسامُ اسمها وأحكامُهُ اسمُ (لا) النافيةِ للجنس على ثلاثة أقسامٍ: مفردٍ، ومضافٍ، ومشبَّه بالمضاف. فالمفرد: ما كانَ غيرَ مضافٍ ولا مشبّهٍ به. وضابطهُ أن لا يكونَ عاملاً فيما بعدهُ، كقوله تعالى: {ذلك الكتابُ لا رَيبَ}. وحُكمُهُ أن يُبنى على ما يُنصبُ به من فتحةٍ أو ياءٍ أو كسرةٍ، غيرَ مُنوَّنٍ نحو: (لا رجلَ في الدار، ولا رجالَ فيها، ولا رجلين عندَنا، ولا مذمومينَ في المدرسة، ولا مذموماتٍ محبوباتٌ) ويجوز في جمع المؤنّثِ السالم بناؤُه أيضاً على الفتح، نحو: (لا مجتهداتَ مذموماتٌ) وقد رُوِيَ بالوجهينِ قول الشاعر: لا سابِغات، ولا جَأْواءَ باسِلَةً تَقِي المَنُونَ، لَدَى استِيفاءِ آجالِ [السابغات: الدروع التامات الطويلات، من سبغ الثوب والشيء إذا طال والجأواء: الكتيبة من الجيش، وأصلها فعلاء من الجي أو الجؤوة. وهي حمرة تضرب الى السواد، سميت بذلك يعلو لونها من السواد لكثرة الدروع. والباسلة: الكريمة اللقاء] وقولُ الآخر: أَوْدَى الشبابُ الذي مَجدٌ عواقبُهُ فيهِ نَلَدُّ، ولا لَذَّاتِ لِلشيبِ وقد بُنيَ لِتركيبهِ مع (لا) كتركيبِ (خمسةَ عشرَ). وحكمُ اسمها المضافِ أن يكون مُعرباً منصوباً، نحو: (لا رجلَ سُوءٍ عندنا. ولا رَجلَيْ شرٍّ محبوبانِ. ولا مهمِلي واجباتهم محبوبون. ولا أخا جهلٍ مُكرَّمٌ. ولا تاركاتِ واجبٍ مُكرَّماتٌ). والشبيهُ بالمضافِ: هو ما اتصلَ به شيءٌ من تمامِ معناه. وضابطُهُ أن يكون عاملاً فيما بعده بأن يكون ما بعده فاعلاً له، نحو: (لا قبيحاً خُلقُه حاضرٌ)، أو نائبَ فاعلٍ، نحو: (لا مذموماً فعلُه عندنا)، أو مفعولاً، نحو: (لا فاعلاً شراً ممدوحٌ)، أو ظرفاً يُتعلّقُ به، نحو: (لا مسافراً اليومَ حاضرٌ) أو جاراً ومجروراً يتعلقانِ به، نحو: (لا راغباً في الشر بيننا)، أو تمييزاً له، نحو: (لا عشرين دِرهماً لك). وحكمُهُ أنه مُعربٌ أيضاً، كما رأيتَ. يتبع في هذا الفصل |
3ـ أحوالُ اسمِها وخَبرِها
وقد يُحذَفُ اسمُ (لا) النافية للجنس، نحو: (لا عليكَ)، أي: لا بأسَ، أو لا جناحَ عليك. وذلك نادرٌ. والخبرُ إِن جُهِلَ وجبَ ذكرُهُ، كحديث: (لا أحدَ أغيرُ من الله) . وإذا عُلمَ فحذفُه كثيرٌ، نحو: (لا بأسَ)، أي لا بأس عليك، ومنه قوله تعالى: {قالوا لا ضَيرَ، إنّا إلى ربنا مُنقلبون}، أي: لا ضَيرَ علينا، وقوله: {ولو تَرى إِذْ فَزِعوا، فلا فَوْتَ}، أي: فلا فَوتَ لهمْ. وبَنو تَميمٍ والطائِيونَ من العربِ يَلتزمون حذفَهُ إذا عُلم. والحجازيُّون يُجيزون إثباتَهُ. وحذفُه عندهم أكثرُ. ومن حذفه قوله تعالى: {لا إلهَ إلاّ اللهُ} أي: لا إلهَ موجود. ويكونُ خبرُ (لا) مُفرداً (أي: ليس جملةً ولا شِبهَها)، كحديث: (لا فقرَ أشدُّ من الجهلِ، ولا مال أعزُّ من العقل، ولا وَحشةَ أشدُّ من العُجبِ) وجملةً فعليةً، نحو: (لا رجلَ سوءٍ يُعاشَرُ)، وجملةً اسميةً نحو: (لا رَضيعَ نَفسٍ خُلقهُ محمودٌ)، وشبهَ جملة (بأن يكون محذوفاً مدلولاً عليه بظرفٍ أو مجرورٍ بحرف جرٍّ يَتعلقانِ به، فيُغنيانِ عنه) كحديث: (لا عقلَ كالتدبير، ولا ورَعَ كالكَفّ، ولا حَسَبَ كحُسنِ الخلُق) وحديث: (لا إيمانَ لِمنْ لا أمانةَ لهُ، ولا دينَ لِمن لا عَهدَ له). واعلم أنَّ النحاة اعتبروا أنَّ (لا) النافيةَ للجنس واسمَها في محلّ رفع بالابتداء، فأجازوا رفعَ التابعِ لاسمِها، نحو: (لا رجلَ في الدار وامرأةٌ) و (لا رجلَ سفيهٌ عندنا). (فالمعطوف والنعت رفعا على أنهما تابعان لمحل (لا واسمها)، لأن محلهما الرفع بالابتداء. وقد اضطرهم الى هذا التكلف أنه سمع من العرب رفع التابع بعد اسمها فتأولوا رفعه على ما ذكرنا). 4ـ أحكامُ (لا) إذا تَكَرَّرَت إذا تكرَّرت (لا) في الكلام، جاز لك أن تُعمِلَ الأولى والثانية معاً كإنَّ، وأن تُعمِلَهما، كليسَ، وأن تُهمِلهما، وأن تُعملَ الأولى كإن أو كليْس وتُهمِلَ الأخرى، وأن تُعمِلَ الثانية كإنَّ أو كليس وتُهملَ الأولى. ولذا يجوز في نحو: (لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ) خمسةُ أوجهٍ: أ ـ بناءُ الاسمين، على أنها عاملةٌ عملَ (إنَّ) نحو: (لا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللهِ). ب ـ رفعُهُما، على أنها عاملةَ عملَ (ليس)، أو على أنها مُهملةٌ، فما بعدها مبتدأٌ وخبر، (لا حولٌ ولا قوَّةٌ إلاّ بالله) ومنه قول الشاعر: وما هَجرْتُكِ، حَتَّى قُلتِ مُعْلِنَةً لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَملُ ج ـ بناءُ الأوَّلِ على الفتح ورفعُ الثاني، نحو: (لا حولَ ولا قوَّةٌ إلاّ باللهِ)، ومنهُ قولُ الشاعر: هذا، لَعَمْرُكُم، الصَّغارُ بِعَيْنِهِ لا أُمَّ لي، إنْ كانَ ذاكَ، ولا أبُ د ـ رفعُ الأولِ وبناءُ الثاني على الفتح، نحو: (لا حولٌ ولا قوةَ إلا باللهِ)، ومنه قول الشاعر: فلا لَغْوٌ ولا تَأْثيمَ فيها وما فاهُوا بهِ أَبداً مُقتمٌ هـ ـ بناءُ الأولِ على الفتح ونصبُ الثاني، بالعطف على محلّ اسم (لا)، نحو: (لا حولَ ولا قوةً إلاّ باللهِ) ومنه قولُ الشاعر: لا نَسَبَ اليَومَ ولا خُلةً اتسَعَ الخرْقُ على الرَّاقع 5ـ أحكامُ نَعْتِ اسمِ (لا) إذا نُعتَ اسمُ (لا) النافيةِ للجنس، فإمَّا أن يكون مُعرَباً، وإمّا أن يكون مبنياً. فإن كان مُعرباً، جاز في نعتهِ وجهانِ: النصب والرفعُ، نحو: (لا طالبَ علمٍ كسولاً، أو كسولٌ، ولا طالباً علماً كسولاً، أو كسولٌ، عندنا). والنصبُ أولى، والرفعُ على أنه نعتٌ لمحلّ (لا واسمها). لأنّ محلها الرفعُ بالابتداء، كما سبقَ. وإن كان مبنياً فله ثلاثُ أحوالٍ: أ ـ أن يُنعتَ بمفردٍ مُتَّصلٌ به، فيجوز في النعتِ ثلاثةُ أوجه: النَّصب والبناءُ كمنعوتهِ، والرفعُ، نحو: (لا رجلَ قبيحاً، أو قبيحَ، أو قبيحٌ، عندنا). والنصبُ أولى. وبناؤُهُ لمجاورته منعوتَهُ المبنيَّ. ب ـ أن يُنعتَ بمفردٍ مفصولٍ بينه وبينهُ بفاصلٍ، فيمتنعُ بناءُ النعت، لِفَقدِ المجاورةِ التي أباحت بناءَه وهو مُتصِل بمنعوتهِ. ويجوز فيه النصبُ والرفع، نحو: (لا تلميذَ في المدرسةِ كسولاً، أو كسولٌ). ج ـ أن يُنعتَ بمضافٍ أو مُشبَّهٍ به، فيجوزُ في النَّعت النصب والرفع، ويمتنعُ البناءُ، لأن المضافَ والشبيهَ به لا يُبنيانِ مع (لا). فالنعتُ المضاف نحو: (لا رجلَ ذات شرّ، أو ذو شرّ، في المدرسة)، والنعتُ المشبَّهُ به نحو: (لا رجلَ راغباً في الشر، أو راغبٌ فيه، عندنا). تم الجزء الثاني بحمد الله |
الباب التاسع: منصوبات الأسماء منصوبات الأسماء أربعة عشر: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى، وخبر الفعل الناقص، وخبر أحرف (ليس)، واسم (إن) أو إحدى أخواتها، واسم (لا) النافية للجنس، والتابع للمنصوب. المفعولُ به المفعولُ به: هو اسمٌ دلَّ على شيءٍ وقع عليه فعلُ الفاعلِ، إثباتاً أو نفياً، ولا تُغيَّر لأجله صورةُ الفعل، فالأولُ نحو: (برَيتُ القلمَ)، والثاني، نحو: (ما بَرَيتُ القلمَ). وقد يَتعدَّدُ، المفعولُ به، في الكلام، إن كان الفعل متعدِّياً إلى أكثرَ من مفعول به واحدٍ، نحو: (أعطيتُ الفقيرَ دِرهماً، ظننتُ الأمرَ واقعاً، أعلمتُ سعيداً الأمر جَليّاً). (وقد سبق الكلام على الفعل المتعدي بأقسامه وأحكامه في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجعه). ويتَعَلَّقُ بالمفعول به أحد عشرَ مبحثاً: 1- أَقسامُ المفعولِ بهِ المفعولُ بهِ قسمانِ: صريحٌ وغيرُ صريح. والصّريحُ قسمان: ظاهرٌ، نحو: (فتحَ خالدٌ الحِيرة)، وضميرٌ متَّصلٌ نحو: (أكرمتُكَ وأكرمتهم)، أو منفصلٌ، نحو {إيَّاكَ نعبدُ، وإِيَّاك نستعين}، ونحو: (إيَّاهُ أُريد). وغيرُ الصريحِ ثلاثةُ أقسام: مُؤوَّلٌ بمصدر بعدَ حرفٍ مصدَريٍّ، نحو: (علِمتُ أنكَ مجتهدٌ، وجملةٌ مُؤوَّلة بمفردٍ، نحو: (ظننتك تجتهد) [أنك مجتهد: مؤول بمصدر منصوب مفعول به لعلمت. والتأويل: علمت اجتهادك] [ وفي ظننتك تجتهد: الكاف: مفعول ظننت الأول. وجملة (تجتهد) في محل نصب مفعوله الثاني. والتأويل: ظننتك مجتهداً]. وجارٌّ ومجرور، نحو: (أمْسكْتُ بيدِكَ) [يدك: مجرور بالباء، وهو في محل نصب مفعول به غير صريح لأمسكت] وقد يَسقُطُ حرفُ الجرِّ فينتصبُ المجرورُ على أنه مفعولٌ به. ويُسمّى: (المنصوبَ على نزعِ الخافضِ) فهو يَرجعُ إلى أصلهِ من النصب، كقول الشاعر: تَمُرُّونَ الدِّيارَ، ولم تَعوجُوا، كلامُكُمُ عَلَيَّ إِذاً حَرَامُ (وقد تقدم لهذا البحث فَضْلُ بيانٍ في الجزء الأول من هذا الكتاب، في الكلام على الفعل اللازم، فراجعه). 2- أَحكامُ المفعول بهِ للمفعول به أربعةُ أحكام: أ- أنهُ يجبْ نصبُهُ. ب- أنه يجوزُ حذفُهُ لدليلٍ، نحو: (رَعَتِ الماشيةُ)، ويقالُ: (هل رأيتَ خليلاً؟)، فتقولُ: (رأيتُ)، قال تعالى: {ما وَدَّعَكَ ربُّكَ وما قَلى}، وقال: {ما أنزلنا عليكَ القُرآن لتشقى، إلا تذكرةً لِمنْ يخشى}. [أي رعت الماشية العشب] و [رأيتُ: أي رأيتهُ والضمير يعود الى خليل] و [وما قلى: أي ما قلاك، أي أبغضك] و [ يخشى: أي يخشى الله] وقد يُنَزَّلُ المتعدِّي منزلة اللازمِ لعَدَم تعلُّقِ غرضٍ بالمفعول بهِ، فلا يُذكرُ له مفعولٌ ولا يُقدَّرُ، كقوله تعالى: {هل يَستوي الذينَ يعلمونَ والذينَ لا يعلمونَ}. وما نصبَ مفعولين من أفعال القلوب، جازَ فيه حذفُ مفعوليه معاً، وحذفُ أحدهما لدليلٍ. فمن حذفِ أحدهما قولُ عَنترةَ. وَلَقدْ نزَلْتِ، فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ أي: فلا تَظُني غيرَهُ واقعاً. ومن حذفهما معاً قولهُ تعالى: {أين شُرَكائيَ الذين كنتم تَزعمونَ؟} أي تزعمونهم شُرَكائي، ومن ذلك قولهم: (مَنْ يَسمَعْ يَخَلْ)، أي: يَخَلْ ما يَسمعُهُ حقاً. (وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب مزيد إيضاح لهذا البحث في الكلام على أفعال القلوب، فارجع إليه). ج- أنه يجوزُ أن يُحذَفَ فعلُهُ لدليل، كقوله تعالى: {ماذا أنزلَ ربُّكم؟ قالوا خيراً}، أي: أنزلَ خيراً، ويقال لك: (مَنْ أُكرِمُ؟)، فتقول: (العلماءَ)، أي: أكرمِ العلماءَ. ويجبُ حذفهُ في الأمثال ونحوها مِما اشتهرَ بحذف الفعل، نحو: (الكلابَ على البَقَرِ)، أي: أرسلِ الكلابَ، ونحو: أمرَ مُبكياتِكَ، لا أمرَ مضحِكاتكَ، أي: الزَمْ واقبَلْ، ونحو: (كلَّ شيءٍ ولا شَتيمةَ حُرّ)، أي: ائتِ كلَّ شيءٍ، ولا تأتي شتيمة حُرٍّ، ونحو: (أهلاً وسهلاً)، أي: جئتَ أهلا ونزلتَ سهلا. ومن ذلكَ حذفهُ في أَبواب التحذير والإغراءِ والاختصاص والاشتغال والنَّعتِ المقطوع. وسيأتي بيانُ ذلك في مواضعه. د- أن الأصلَ فيه أن يتأخرَ عن الفعلِ والفاعلِ. وقد يتقدَّمُ على الفاعلِ، أو على الفعل والفاعل معاً، كما سيأتي. |
3- تَقديمُ المفعولِ بهِ وتأخيرُهُ
الأصل في الفاعل أن يَتَّصل بفعله، لأنهُ كالجزءِ منه، ثُم يأتي بعدَهُ المفعولُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ. وقد يَتقدَّمُ المفعولُ على الفعل والفاعل معاً. وكلُّ ذلك إمَّا جائزٌ، وإمَّا واجبٌ، وإمَّا مُمتنع. تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر يجوزُ تقديمُ المفعولِ به على الفاعلِ وتأخيرُه عنه في نحو: (كتبَ زُهيرٌ الدرسَ، وكتبَ الدرسَ زُهيرٌ). ويجب تقديمُ أَحدِهما على الآخر في خمس مسائل: أ- إذا خُشيَ الالتباسُ والوقوعُ في الشكِّ، بسبب خفاء الإعراب مع عدَمِ القرينةِ، فلا يُعلَمُ الفاعلُ من المفعول، فيجبُ تقديمُ الفاعل، نحو: (عَلّمَ موسى عيسى، وأكرمَ ابني أخي. وغلَب هذا ذاك). فإن أُمِنَ اللّبسُ لقرينةٍ دالّةٍ، جازَ تقديمُ المفعولِ، نحو: (أكرمتْ موسى سَلمى، وأَضنتْ سُعاد الحُمّى). ب- أن يتصلَ بالفاعلِ ضميرٌ يعودُ إلى المفعول، فيجبُ تأخيرُ الفاعل وتقديمُ المفعولِ، نحو: (أكرمَ سعيداً غلامُهُ). ومنهُ قولهُ تعالى: {وإذْ ابتلى إبراهيمَ رَبُّهُ بكلماتٍ}، وقولهُ: {يومَ لا ينفع الظّالمينَ مَعذِرتُهم}. ولا يجوزُ أن يقال: (أكرم غلامُهُ سعيداً)، لئلا يلزمَ عَودُ الضمير على مُتأخر لفظاً ورتبةً، وذلك محظورٌ. وأما قولُ الشاعر: وَلَوْ أَنَّ مَجداً أَخلَدَ الدَّهْرَ واحِداً مِنَ النَّاسِ، أَبقى مَجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِما وقول الآخر: كسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثوابَ سُؤدُدٍ وَرَقَّىَ نَدَاهُ ذَا النَّدَى في ذُرَى الْمَجْدِ فضَرُورةٌ، إن جازتْ في الشعر، على قبُحها، لم تَجزْ في النّثر. فإنِ اتّصل بالمفعول ضميرٌ يعودُ على الفاعل، جازَ تقديمهُ وتأخيرُهُ فتقول: (أكرمَ الأستاذُ تلميذَهُ. وأَكرمَ تلميذَهُ الأستاذُ)، لأنَّ الفاعلَ رتبتُهُ التقديمُ، سواءٌ أَتقدّمَ أَم تأخّر. ج- أَن يكون الفاعلُ والمفعولُ ضميرينِ، ولا حصرَ في أَحدهما، فيجبُ تقديمُ الفاعل وتأخيرُ المفعول به، نحو: (أَكرمتُه). د- أَن يكون أَحدُهما ضميراً متصلاً، والآخر اسماً ظاهراً، فيجبُ تقديمُ الضمير منهما، فيُقدّمُ الفاعلُ في نحو: (أكرمتُ علياً)، ويُقدّمُ المفعولُ في نحو: (أكرَمني علي)، وجوباً. (ولك في المثال الأول تقديمُ المفعول على الفعل والفاعل معاً. نحو: (علياُ أكرمتُ). ولك في المثال الآخر تقديم (عليّ) على الفعل والمفعول به، نحو: (عليٌ أكرمني)، غير أنه يكون حينئذ مبتدأ، على رأي البصريين، ويكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه. فلا يكون الكلام، والحالة هذه، من هذا الباب، بل يكون من المسألة الثالثة، لأن الفاعل والمفعول كليهما حينئذ ضميران). هـ- أَن يكون أَحدُهما محصوراً فيه الفعلُ بإلا أَو إنما، فيجبُ تأخيرُ ما حُصِرَ فيه الفعلُ، مفعولاً أو فاعلاً، فالمفعولُ المحصورُ نحو (ما أَكرمَ سعيدٌ إلا خالداً)، والفاعلُ المحصورُ نحو: (ما أكرمَ سعيداً إلا خالدٌ. وإنما أَكرمَ سعيداً خالدٌ). (ومعنى الحصر في المفعول أن فعل الفاعل محصور وقوعه على هذا المفعول دون غيره. وذلك يكون ردّاً على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره، أو عليه وعلى غيره. ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوعه من هذا الفاعل دون غيره. وذلك يكون رداً على ن اعتقد أن الفاعل غيره، أو هو وغيره). تقديم المفعول على الفعل والفاعل معاً يجوزُ تقديمُ المفعول به على الفعل والفاعل معاً في نحو: "عليّاً أَكرمتُ. وأَكرمتُ عليّاً"، ومنه قولهُ تعالى: {فَفريقاً كذَّبتم وفَريقاً تقتلونَ}. ويجبُ تقديمهُ عليهما في أَربعَ مَسائلَ: أ- أَن يكونَ اسمَ شرطٍ، كقولهِ تعالى: {من يُضلِل اللهُ فما لهُ من هادٍ}، ونحو: (أَيَّهُمْ تُكرِمْ أُكرِمْ)، أَو مضافاً لاسمِ شرطٍ، نحو: (هدْيَ من تَتبعْ يَتبعْ بَنوكَ). ب- أَن يكونَ اسمَ استفهامٍ، كقولهِ تعالى: {فأيَّ آياتِ اللهِ تُنكرِونَ؟}، ونحو: (من أَكرمتَ؟ وما فعلتَ؟ وكمْ كتاباً اشتريتَ؟) أَو مُضافاً لاسم استفهامِ، نحو: كتابَ من أَخذتَ؟). وأَجاز بعضُ العلماء تأخيرَ اسم الاستفهام، إذا لم يكن الاستفهامُ ابتداءً، بل قُصِدَ الاستثبات من الأمر، كأن يُقالَ: (فعلتُ كذا وكذا)، فتستثبِتُ الأمرَ بقولكَ: (فعلتَ ماذا؟). وما قولُهم ببعيدٍ من الصواب. ج- أَن يكون (كمْ) أَو (كأيِّنْ) الخَبريَّتينِ، نحو: (كم كتابٍ مَلَكتُ!)، ونحو: (كأيِّنْ من عِلمٍ حَوَيتُ!)، أَو مضافاً إلى (كم) الخبريَّةِ نحو: ( ذَنبَ كم مُذْنِبٍ غَفرتُ!). (أما "كأين" فلا تضاف ولا يضاف إليها. وإنما وجب تقديم المفعول به إن كان واحداً مما تقدم، لأنّ هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوباً، فلا يجوز تأخيرها). د- أَن ينصبهُ جوابُ (أَما)، وليسَ لجوابها منصوبٌ مُقدَمٌ غيرُهُ، كقولهِ تعالى: {فأمّا اليتيم فلا تَقهرْ، وأَمَّا السائلَ فلا تَنهرْ}. (وإنما وجب تقديمه، والحالة هذه، ليكون فاصلاً بين (أما) وجوابها، فان كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه، نحو: (أما اليوم فافعل ما بدا لك). تقديم أحد المفعولين على الآخر إذا تعدَّدَت المفاعيلُ في الكلام، فلبعضها الأصالةُ في التقدُّم على بعضٍ، إمّا بكونه مبتدأً في الأصل كما في باب (ظنَّ)، وإمّا بكونهِ فاعلاً في المعنى، كما في باب "أَعطى". (فمفعولا (ظنّ) وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر، فإذا قلت: (علمت الله رحيماً). فالأصل: (اللهُ رحيمٌ). ومفعولا (أعطى) وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ وخبراً، غير أن المفعول الأول فاعل في المعنى، فإذا قلت: (ألبستُ الفقير ثوباً). فالفقير: فاعل في المعنى، لأنه لبس الثوب). فإذا كان الفعل ناصباً لمفعولين، فالأصلُ تقديمُ المفعولِ الأوَّل، لأنّ أصله المبتدأُ، في باب (ظَنَّ)، ولأنهُ فاعلٌ في المعنى في باب (أَعطى)، نحو: "ظننتُ البدرَ طالعاً، ونحو: (أعطيتُ سعيداً الكتابَ). ويجوز العكسُ إِن أُمِنَ اللَّبْسُ، نحو، (ظننتُ طالعاً البدرَ)، ونحو: (أَعطيتُ الكتابَ سعيداً). ويجب تقديم أَحدهما على الآخر في أربع مسائلَ: أ- أَن لا يُؤْمنَ اللّبْسُ، فيجبُ تقديمُ ما حقّهُ التقديمُ، وهو المفعولُ الأول، نحو: (أَعطيتكَ أَخاكَ)، إن كان المخاطَبُ هو المُعطى الآخذَ، وأخوهُ هو المعطى المأخوذ، ونحو: (ظننت سعيداً خالداً)، إن كان سعيدٌ هو المظنونَ أنه خالدٌ. وإلا عكستَ. ب- أن يكونَ أحدُهما اسماً ظاهراً، والآخر ضميراً، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ، وتأخيرُ ما هو ظاهرٌ، نحو: (أعطيتُكَ درهماً) و (الدرهمَ أعطيتُهُ سعيداً). ج- أن يكون أحدُهما محصوراً فيه الفعلُ، فيجبُ تأخير المحصور، سواءٌ أكان المفعولَ الأول أم الثاني، نحو: (ما أعطيت سعيداً إلا دِرهماً) و (ما أعطيتُ الدرهمَ إلا سعيداً). د- أن يكونَ المفعولَ الأولُ مشتملاً على ضمير يعودُ إلى المفعول الثاني، فيجب تأخيرُ الأول وتقديم الثاني، نحو: (أعطِ القوسَ باريَها). (فلو قُدِّم المفعولُ الأول لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، لأن المفعول الثاني رتبته التأخير عن المفعول الأول. أما أن كان المفعول الثاني مشتملاً على ضمير يعود الى المفعول الأول، نحو: (أعطيت التلميذَ كتابه)، فيجوز تقديمه على المفعول الأول، نحو: (أعطيتُ كتابه التلميذَ) لأن المفعول الأول، وان تأخر لفظاً، فهو متقدم رتبة). |
4ـ المُشَبَّهُ بالْمَفعول به
إن كان معمولُ الصفةِ المُشبَّهة معرفةً، فحقُّهُ الرفعُ، لأنه فاعلٌ لها، نحو: (عليٌّ حَسَنٌ خُلقُهُ). غيرَ أنهم إذا قصدوا المبالغةَ حوَّلوا الإسنادَ عن فاعلها إلى ضميرٍ يسْتَتِرُ فيها يعود الى ما قبلها، ونَصبوا ما كان فاعلاً، تشبيهاً له بالمفعول به، فقالوا: (علي حَسَنٌ خُلقَهُ)، بنصبِ الخُلُق على التَّشبيه بالمفعول به، وليس مفعولاً به، لأنّ الصفةَ المشبَّهة قاصرةٌ غيرُ متعديةٍ، ولا تمييزاً، لأنه معرفةٌ بالإضافة إلى الضمير. والتمييزُ لا يكونُ إلا نكرةً. [ علي: مبتدأ، وحسنٌ: خبره، وخُلُقُه: فاعل لحسن. ويجوز أن يكون (حسن) خبراً مقدماً، وخلقه مبتدأ مؤخراً، والجملة خبر عن علي] 5- التَّحْذيرُ التَّحذيرُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوف يُفيدُ التَّنبيهَ والتّحذيرَ. ويُقدّرُ بما يُناسبُ المقامَ: كاحذَرْ، وباعِدْ، وتَجنَّبْ، و (قِ) وتَوَقَّ، ونحوها. وفائدتُهُ تنبيهُ المخاطبِ على أمرٍ مكروهٍ ليجتنبَهُ. ويكونُ التحذيرُ تارةً بلفظِ (إيّاكَ) وفروعهِ، من كلّ ضميرٍ منصوبٍ متصل للخطاب، نحو: (إياكَ والكَذِبَ*1، إِياكَ إياكَ والشرّ*2َ، إياكما من النفاقِ*3 إياكم الضَّلالَ*4، إياكنَّ والرَّذيلةَ. *1ـ إياك: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره (باعد، أوقِِ، أو احذر). والكذب: معطوف على (إياك)، أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً تقديره: احذر أو توقّ. وتقدير الكلام من جهة المعنى: باعد نفسك من الكذب وباعد الكذب من نفسك. *2ـ إياك الثانية: تأكيد للأولى. *3ـ إياكما: مفعول لفعل محذوف تقديره: باعدا. من النفاق: متعلق بالفعل المقدّر. *4ـ التقدير: أحذركم الضلال، فإياكم والضلال: مفعولان لفعل مقدر ينصب المفعولين. ويكونُ تارةً بدونه، نحو: (نفسَكَ والشرّ، الأسدَ الأَسدَ). وقد يكونُ بـ (إيّاه، وفروعهما، إذا عُطفَ على المُحذّر، كقوله: فَلا تَصْحَبْ أَخَا الجَهْلِ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ [الأسدَ الأَسدَ: التقدير: احذر الأسد، والثانية توكيد.] وقد يُرفعُ المكرّرُ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحو: "الأسدُ الأسدُ" أي: هذا الأسدُ. وقد يُحذَفُ المحذورُ منه، بعد (إياك) وفروعهِ، اعتماداً على القرينة، كأنْ يُقال: "سأفعلُ كذا" فتقولُ: "إياكَ"، أَي: "إياك أَن تفعله". وما كان من التّحذير بغير "إياك" وفروعهِ، جاز فيه ذكرُ المُحذَّر والمحذَّر منه معاً، نحو:"رجلَكَ والحجرَ" وجازَ حذفُ المحذّر وذكرُ المحذّر منه وحدَهُ، نحو: "الأسدَ الاسدَ". ومنه قولهُ تعالى: {ناقةَ اللهِ وسُقياها}. 6- الإِغراءُ الإِغراءُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ يُفيدُ الترغيبَ والتشويقَ والإِغراءَ. ويقدَّرُ بما يُناسبُ المقامَ: كالزَمْ واطلُبْ وافعلْ، ونحوها. وقائدتُه تنبيهُ المخاطَبِ على أمرٍ محمودٍ ليفعلُه، نحو: (الاجتهادَ الاجتهادَ) مو (الصِدقَ وكرَمَ الخلقِ). ويجبُ في هذا البابِ حذفُ العاملِ إن كُرّرَ المُغرَى به، أو عُطِفَ عليهِ، فالأولُ نحو: "النَجدةَ النَّجدةَ". ومنه قول الشاعر: أَخاكَ أَخَاكَ، إنَّ مَنْ لا أَخا لَهُ كساعٍ إلى الهَيْجا بِغَيْرِ سِلاَحِ وإِنَّ ابْنَ عَمِّ المَرْءِ فاعلَمْ، جَناحُهُ وهَلْ يَنْهَضُ البازِي بِغَيْرِ جَنَاحِ والثاني نحو: (لمُروءةَ والنّجدةَ). ويجوزُ ذِكرُ عاملهِ وحذفه إن لم يُكرّر ولم يُعطَفْ عليه، نحو: (الإِقدامَ، الخيرَ). ومنه: (الصّلاةَ جامعةً). فإن أظهرتَ العاملَ فقلتَ: (اِلزمِ الإقدام، افعل الخيرَ، أُحضُرِ الصلاة)، جازَ. وقد يُرفعُ المكرَّرُ، في الإغراءِ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، كقوله: إِنَّ قَوْماً مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وأَشبا هُ عُميْرٍ، ومِنْهُمُ السَّفَّاحُ لَجَدِيرُونَ بالوَفاءِ إِذَا قا لَ أَخُو النَّجْدةِ. السِّلاَحُ السِّلاَحُ |
7- الاختِصاصُ
الاختصاصُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ وجوباً تقديرُهُ: (أَخصُّ، أو أعْني). ولا يكونُ هذا الاسمُ ضميرٍ لبيان المرادِ منه، وقَصرِ الحكمِ الذي للضمير عليه، نحو: (نحنُ - العرَبَ - نُكرِمُ الضّيفَ). ويُسمّى الاسمَ المُختصّ. (فنحن: مبتدأ، وجملة نكرم الضيف: خبره. والعربَ: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره: (أخصّ). وجملة الفعل المحذوف معترضة بين المبتدأ وخبره. وليس المراد الإخبار عن (نحن) بالعرب، بل المراد أن إكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم. فإن ذُكرَ الاسمُ بعد الضمير للإخبار به عنه، لا لبيان المراد منه، فهو مرفوع لأنه يكون حينئذ خبراً للمبتدأ. كأن تقول: (نحنُ المجتهدون) أو (نحن السابقون). ومن النصب على الاختصاص قولُ الناس: (نحنُ - الواضعين أسماءنا أدناه - نشهد بكذا وكذا). فنحن: مبتدأ، خبره جملة (نشهد) والواضعين: مفعول به لفعل محذوف تقديره: (نخصّ، أو نعني)). ويجبُ أن يكونَ مُعرّفاً بأل، نحو: (نحنُ - العربَ - أوفى الناسِ بالعُهود)، أو مضافاً لمعرفةٍ، كحديث: (نحنُ - مَعاشرَ الأنبياء - لا نورثُ ما تركناهُ صدَقةٌ)، أو عَلَماً، وهو قليلٌ، كقول الراجز: (بنا - تَميماً - يُكشَفُ الضَّبابُ). أما المضافُ إلى العَلَمِ فيكونَ على غيرِ قِلّةٍ، كقولهِ: (نحنُ - بَني ضَبَّةَ أصحابَ الجَمَل). ولا يكونُ نكرةً ولا ضميراً ولا اسمَ إشارة ولا اسمَ موصولٍ. وأكثرُ الأسماءِ دخولاً في هذا البابِ (بنو فلان، ومعشر (مضافاً)، وأهلُ البيتِ، وآلُ فلانٍ). واعلمْ أن الأكثر في المختصِّ أن يَلي ضميرَ المتكلِّمِ، كما رأيتَ. وقد يلي ضميرَ الخطاب، نحو: (بكَ - اللهَ. أرجو نجاحَ القصدِ) و (سُبحانَكَ - اللهَ – العظيمَ). ولا يكون بعدَ ضميرِ غيبة. وقد يكون الاختصاصُ بلَفظ (أَيُّها وأَيَّتُها)، فيُستعملان كما يستعملان في النّداءِ، فيبنيان على الضمِّ، ويكونانِ في محلِّ نصبٍ بأخُص محذوفاً وجوباً، ويكونُ ما بعدَهما اسماُ مُحَلًّى بألْ، لازمَ الرفعِ على أنه صفةٌ لِلَفظهما، أو بدلٌ منه، أو عطفُ بيانٍ لهُ. ولا يجوزُ نصبه على أنه تابعٌ لمحلّهما من الإعراب. وذلك نحو: (أَنا أفعلُ الخيرَ، أيُّها الرجلُ، ونحن نفعلُ المعروفَ، أيُّها القومُ). ومنه قولهم: (أَللهمَّ اغفر لنا، أَيَّتُها العَصابةُ). (ويراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص، وإن كان ظاهره النداء. والمعنى: (أنا أفعل الخير مخصوصاً من بين الرجال، ونحن نفعل المعروف مخصوصين من بين القوم, واللهمّ اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب). ولم ترد بالرجل إلا نفسك: ولم يريدوا بالرجال والعصابة إلا أنفسهم. وجملة (أخص) المقدّرة بعد (أيها رأيتها) في محل نصب على الحال). 8- الاشتغالُ الاشتغالُ: أن يَتقدَّمَ اسمٌ على من حقِّهِ أن يَنصِبَه، لولا اشتغالهُ عنه بالعمل في ضميرهِ، نحو: (خالدٌ أَكرمتُهُ). (إذا قلت: (خالداً أكرمتُ)، فخالداً: مفعول به لأكرمَ. فان قلتَ: (خالدٌ أكرمته)، فخالدٌ حقه أن يكون مفعولاً به لأكرم أيضاً، لكنّ الفعلَ هنا اشتغل عن العمل في ضميره، وهو الهاء. وهذا هو معنى الاشتغال). والأفضلُ في الاسم المتقدمِ الرفعُ على الابتداء، كما رأيتَ. الجملةُ بعدَهُ خبرهُ. ويجوز نصبُهُ نحو: (خالداً رأيتهُ). [خالداً: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وتقديره: (رأيت) وجملة (رأيته): مفسرة للجملة المقدرة، ولا محل لها من الإعراب] وناصبُهُ فعلٌ وجوباً، فلا يجوزُ إظهارهُ. ويُقدَّرُ المحذوفُ من لفظِ المذكور. إلا أن يكونَ المذكورُ فعلاً لازماً متعدياً بحرف الجر، نحو: (العاجزَ أخذتُ بيدهِ) و (بيروتَ مررتُ بها)، فَيُقدّرُ من معناهُ. (فتقدير المحذوف: (رأيت). في نحو (خالداً رأيته). وتقديره: (أعنت، أو ساعدت، في نحو: (العاجزَ أخذت بيده). وتقديره: (جاوزت) في نحو: (بيروتَ مررت بها)). وقد يَعرِضُ للاسمِ المُشتَغَلِ عنه ما يوجبُ نصبَهُ أو يُرَجّحُهُ، وما يوجبُ رفعَهُ أو يُرَجّحُهُ. فيجبُ نصبُهُ إذا وقعَ بعدَ أدواتِ التّحضيضِ والشرطِ والاستفهامِ غير الهمزةِ، نحو: (هلاّ الخيرَ فعلتَهُ. إنْ علياً لقيتَهُ فسَلّمْ عليهِ, هل خالداً أَكرمتَهُ؟). (غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون إلا في الشعر. إلا أن تكون أداة الشرط (أن) والفعل بعدها ماض، أو (إذا) مطلقاً، نحو: (إذا عليّاً لقيته، أو تلقاه فسلم عليه). وفي حكم (إذا). في جواز الاشتغال بعدها في النثر، (لو ولولا). ويُرجَّحُ نصبُهُ في خمسِ صُوَر: 1- أن يقعَ بعد الاسمِ أمرٌ، نحو: (خالداً أَكرِمْهُ) و (عليّاً لِيُكرِمْهُ سعيدٌ). 2- أن يقعَ بعدَهُ نهيٌ، نحو: (الكريمَ لا تُهِنهُ). 3- أن يقعَ بعدَهُ فعلُ دُعائي، نحو: (اللهمَّ أمرِيَ يَسّرّهُ، وعَمَلي لا تُعَسّرْهُ). وقد يكونُ الدعاءُ بصورةِ الخبرِ، نحو: (سليماً غفرَ اللهُ لهُ، وخالداً هداهُ اللهُ) (فالكلام هنا خبري لفظاً، إنشائي دعائي معنى. لأنّ المعنى: اغفر اللهم لسليم، واهدِ خالداً. وإنما ترجح النصب في هذه الصور لأنك إن رفعت الاسم كان خبره جملة إنشائية طلبية، والجملة الطلبية يضعف الإخبار بها). 4- أن يقعَ الإسمُ بعدَ همزة الاستفهام، كقوله تعالى: {أَبشَراً مِنّا واحداً نَتَّبعُهُ؟}. (وانما ترجح النصب بعدها لأن الغالب ان يليها فعلٌ، ونصبُ الاسم يوجبُ تقديرَ فعل بعدها). 5- أن يقعَ جواباً لمُستفهَمٍ عنه منصوبٍ، كقولك: (عليّاً أَكرمتُهُ)، في جواب من قال: (مَنْ أَكرمتَ؟). (وإنما ترجح النصب لأنّ الكلام في الحقيقة مبنيّ على ما قبله من الاستفهام). ويجبُ رفعُهُ في ثلاثة مواضعَ: 1- أن يقعَ بعدَ (إذا الفجائيَّةِ) نحو: (خرجت فإذا الجوُّ يَملَؤُهُ الضَّبابُ). (وذلك لأن (إذا) هذه لم يؤوّلها العربُ إلا مبتدأ، كقوله تعالى: {ونزعَ يده فإذا هي بيضاء للناظرين}، أو خبراً، كقوله سبحانه: {فإذا لهم مكرٌ في آياتنا}. فلو نُصب الاسمُ بعدها، لكان على تقدير فعل بعدها، وهي لا تدخل على الأفعال). 2- أن يقعَ بعدَ واو الحال، نحو: (جئتُ والفرسُ يَركبُهُ أَخوكَ). 3- أن يقعَ قبلَ أدوات الاستفهام، أو الشرط، أو التحضيص، أو ما النافية، أو لامِ الابتداء، أو ما التَّعجبيةِ، أو كم الخبرية، أو (إنَّ) وأَخواتها، نحو: (زُهيرٌ هل أَكرمتَهُ؟، سعيدٌ فأكرِمه، خالدٌ هلاَّ دعوتهُ، الشرُّ ما فعلتُهُ، الخيرُ لأنا أَفعلُهُ، الخلُق الحَسَنُ ما أَطيبَهُ!، زُهيرٌ كم أكرمتُهُ!، أُسامةُ إني أَحِبُّهُ). (فالاسم في ذلك كله مبتدأ. والجملة بعده خبره. وإنما لم يجز نصبه بفعل محذوف مفسر بالمذكور. لأن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها. وما لا يعمل لا يفسر عاملاً). ويُرَجَّحُ الرفعُ، إذا لم يكن ما يوجبُ نصبَهُ، أو يرَجِّحُه، أو يوجبُ رفعَه، نحو: "خالدٌ أكرمتُهُ". لأنهُ إذا دار الأمر بينَ التقديرِ وعدَمِهِ فتركهُ أولى. |
9- التَّنازُعُ
التَّنازُعُ: أن يَتوجهَ عاملانِ مُتقدمانِ، أو أكثرُ، إلى معمول واحدٍ مُتأخرٍ أو أكثر، كقوله تعالى: {آتوني أُفرغْ عليه قِطراً}. (آتوا: فعل أمر يتعدى الى مفعولين. ومفعوله الأول هو الياء، ضميرُ المتكلم. وهو يطلب (قطراً) ليكون مفعوله الثاني.و (أفرغ) : فعل مضارع متعد الى مفعول واحد. وهو يطلب (قطراً) ليكون ذلك المفعول. فأنت ترى أنّ (قطراً) قد تنازعه عاملانِ، كلاهما يطلبه ليكون مفعولاً به له، لأنّ التقدير: {آتوني قطراً أفرغه عليه}. وهذا هو معنى التنازع). ولكَ أن تُعمِلَ في الاسم المذكور أيَّ العاملَينِ شئتَ. فإن أعملت الثاني فَلقُربهِ، وإن أعملت الأولَ فلسبَقهِ. فإن أَعملتَ الأوَّلَ في الظاهرِ أَعملتَ الثانيَ في ضميرهِ، مرفوعاً كان أم غيرَهُ، نحو: (قامَ، وقعدا، أخواك. اجتهدَ، فأكرمتُهما، أخواك.وقفَ، فسلمتُ عليهما، أخواك. أكرمتُ، فَسُرّا، أخَويْكَ. أكرمتُ، فشكرَ لي، خالداً). ومن النُّحاة من أجاز حذفه، إن كان غيرَ ضميرِ رفعٍ، لأنهُ فضلةٌ، وعليه قول الشاعر: بِعُكاظَ يُعْشي النَّاظِريـ ـنَ، إذا هُمُ لَمَحُوا، شُعاعُهْ [شُعاعه: فاعل (يُعشي) وقد حذف مفعول (لمحوا) ولم يأتِ به ضميراً. ولو أضمره لقال: (لمحوه). وذلك أن كلا من (يعشي ولمحوا) يطلب (شعاعه) ليعمل فيه. فالأول يطلبه لأنه فاعلٌ له. والآخر يطلبه لأنه مفعوله فأعملَ الأول، وأهمل الآخر؛ ولم يعمله في ضميره والمعنى: يُعشي شعاعه الناظرين، إذا لمحوه، أي يبهرهم، فلا يستطيعون إدامة النظر إليه] وأن أعملتَ الثانيَ في الظاهر، أعملتَ الأولَ في ضميرهِ، إن كان مرفوعاً نحو: (قاما، وقعدَ أخواك. اجتهدا، فأكرمتُ أخوَيْك) وَقَفا، فسَلَّمتُ على أخويكَ". ومنه قولُ الشاعر: جَفَوْني، ولم أَجفُ الأَخِلاَّءَ، إِنَّني لِغَيْرِ جَميلٍ مِنْ خَلِيلَي مُهْمِلُ وإن كان ضميرُهُ غير مرفوعٍ حذفتَهُ، نحو: (أكرمت، فَسُرَّ أخواك. أكرمتُ، فشكرَ لي خالدٌ. أكرمتُ، وأكرَمني سعيدٌ. مررتُ، ومَرَّ بي علىُّ). ولا يقال: (أكرمتهما، فَسُرَّ أخواكَ. أكرمتُهُ، فشكرَ لي خالد. أكرمتُهُ، وأكرمني سعيدٌ. مررتُ به، ومرَّ بي عليَّ). وأمّا قول الشاعر: إذا كُنْتَ تُرْضِيهِ، وَيُرْضيكَ صاحبٌ جِهاراً، فَكُنْ في الْغَيْبِ أَحفَظَ للعَهْدِ وَأَلْغِ أَحاديثَ الْوُشاة، فَقَلَّما يُحاوِلُ واشٍ غَيْرَ هِجْرانِ ذِي وُدِّ بإظهار الضمير المنصوب في (تُرضيه)، فضرورةٌ لا يحسُنُ ارتكابها عند الجمهور. وكان حقُّهُ أن يقول: (إذا كنت تُرضي، ويُرضيكَ صاحبٌ). وأجازَ ذلك بعضُ مُحَقّقي النّحاة. (وذهب الكسائيّ ومن تابعه الى أنه أذا أعملت الثاني في الظاهر، لم تُضمر الفاعلَ في الأول بل يكون فاعله محذوفاً لدلالة ما بعده عليه (لأنه يُجيز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل). فإذا قلت: (أكرمني فسرّني زهيرُ)، فإن جعلت زهيراً فاعلاً لسرّ، كان فاعل (أكرمَ) (على رأى سيبويه والجمهور) ضميراً مستتراً يعود إليه. وعلى رأي الكسائي ومن وافقه يكون فاعل (أكرم) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه. ويظهر اثر الخلاف في التثنية والجمع، فعلى رأي سيبويه يجب أن تقول: (إن أعملت الثاني): (أكرماني، فسرَّني صديقايَ. وأكرموني، فسرَّني أصدقائي). وتقول على مذهب الكسائي ومن تابعه: (أكرمني، فسرَّني صديقايَ. وأكرمني، فسرَّني أصدقائي). فيكون الاسم الظاهر فاعلاً للثاني. ويكون فاعل الأول محذوفاً. وما قاله الكسائي ليس ببعيدٌ، لان العرب تستغني في كلامها عما يُعلم لو حُذف، ولو كان عمدة. ولهذا شواهدُ من كلامهم. أما لو أعملت الأول في الاسم الظاهر، فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني، نحو: (أكرمني، فسرَّاني، صديقايَ، وأكرمني، فسرّوني، أصدقائي). والذي دعا الكسائيّ الى ما ذهب إليه، انه لو لم يحذف الفاعل، لوجب أن يكون ضميراً عائداً على الاسم الظاهر المتأخر لفظاً ورتبة، وذلك قبيح. وقال سيبويه: ان عود الضمير على المتأخر أهون من حذف الفاعل، وهو عمدة، والحقّ أنَّ لكل وجهاً، وانّ الإضمار وتركه على حد سواء. وقد ورد في كلامهم ما يؤيج ما ذهب اليه الفريقان. فقول الشاعر: جفوني ولم اجف الأخلاء... شاهدٌ لسيبويه: وقول الآخر: تعفق بالارطى لها وأرادها رجالٌ، فبذَّت نبلَهم وكَليبٌ [ تعفق بالأرطي: لاذ بها والتجأ إليها. والأرطي: نوع من الشجر. والضمير في لها يعود الى بقرة الوحش. و (نبلهم) : مفعوله. وليس هو الفاعل، كما قال من فسر البيت من أصحاب الشروح والحواشي النحوية. و (الكليب): الكلاب، جمع كلب. وهو معطوف على رجال. والمعنى أن رجالاً لاذوا بالأرطي مستترين بها، وأرادوا صيد هذه البقرة الوحشية هم وكلابهم فلم يفلحوا، لأنها غلبت كلابهم ونبالهم] (شاهدٌ للكسائي: فهو لا يُضمر في واحد من الفعلين. ولو اضمر في الأول واعمل الثاني لقال: (تعفقوا بالارطى وأرادها رجال). ولو اضمر في الثاني واعمل الأول، لقال: (تعفق بالارطى ورادوها رجال)). واعلم أنهُ لا يقعُ التنازعُ إلا بينَ فعلينِ مُتصرّفينِ، او اسمينِ يُشبهانِهما، أو فعلٍ متصرفٍ واسمٍ يُشبهُه. فالأول نحو: "جاءَني، وأكرمتُ خالداً"، والثاني كقول الشاعر: عُهِدْتَ مُغِيثاً مُغنِياً مَنْ أَجَرْتَهُ فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلاَّ فِناءَكَ مَوْئِلا والثالثُ كقوله تعالى: {هاؤُمُ اقرَأُوا كتابِيَهْ}. ولا يقعُ بينَ حرفين ولا بينَ حرفٍ وغيره، ولا بينَ جامدينِ، ولا بينَ جامدٍ وغيره. وقد يُذكَرُ الثاني لمجرَّدِ التَّقويةِ والتأكيد، فلا عَمَلَ له، وإنَّما العمل للأوَّلِ. ولا يكونُ الكلامُ حينئذٍ من باب التنازع، كقول الشاعر: فَهَيْهَاتَ، هَيْهَاتَ، الْعَقِيقُ وَمَنْ بهِ وهَيْهَاتَ خِلٌّ بالْعَقيقِ نُواصِلُهْ وقول الآخر: فأَينَ إلى أَينَ النَّجَاةُ ببَغْلَتِي أَتاكَ، أَتاكَ، اللاَّحِقُونَ، احْبِسِ احْبِسِ (ولو كان من باب التنازع لقال: (أتوك أتاك اللاحقون)؛ بإعمال الثاني في الظاهر والإضمار في الأول، أو (أتاك أتوك اللاحقون) بالإضمار في الأول وإعمال الثاني في الظاهر). |
10- القوْلُ المتَضَمِّنُ مَعْنَى الظنِّ
قد يتضمنُ القول معنى الظن، فينصبُ المبتدأ والخبر مفعولينِ، كما تنصبهُما (ظنَّ). وذلك بشرطِ أن يكون الفعل مضارعاً للمخاطَب مسبوقاً باستفهامٍ، وأن لا يُفصَلَ بينَ الفعلِ والاستفهام بغير ظرفٍ، أو جار ومجرورٍ، أو معمولِ الفعل، كقول الشاعر: مَتَى تَقُولُ الْقُلُصَ الرَّواسِما يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسمٍ وَالْقاسِما [ القُلص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، والرواسم: جمع راسمة؛ وهي الناقة التي تترك أثراً في الأرض بسيرها، والرسيم: ضرب من السير] ومثالُ الفصل بينهما بظرفٍ زمانيّ أو مكانيّ: (أيومَ الخميس تقولُ عليّاً مسافراً أوَ عندَ سعيدٍ تَقولُهُ نازلاً)، قال الشاعر: أَبَعْدَ بُعْدٍ تَقولُ الدَّارَ جامعةً شَمْلي بهمْ؟ أَمْ تَقول البُعْدَ مَحْتوما؟! ومثالُ ما فُصِلَ فيه بينهما بالجارّ والمجرور: (أبا الكلامِ تقول الأمّةَ بالغةً مجدَ آبائها الأوَّلينَ؟). ومثالُ الفصلِ بمعمول الفعل قولُ الشاعر: أجُهَّالاً تَقُولُ بني لُؤَيِّ؟ لَعَمْرُ أَبِيكَ، أَمْ مُتَجاهِلينا؟ فإن فُقد شرطٌ من هذه الشروطِ الأربعة، تَعيّنَ الرفعُ عند عامة العربِ، إلا بني سلَيمٍ، فهم ينصبون بالقول مفعولينِ بلا شرطٍ. ولا يجب في القول المُتَضمّنِ معنى الظن، المُستوفي الشروط، أن ينصب المفعولين، بل يجوز رفعُهما على أنهما مبتدأ وخبر، كما كانا. وإن لم يتضَمنِ القولُ معنى الظن فهو مُتعد إلى واحد. ومفعولهُ إمّا مفرد (أي غير جملةٍ)، وإمّا جملةٌ محكيّة. فالمفرد على نوعينِ: مفردٍ في معنى الجملةِ، نحو: (قلت شعراً، أو خطبةً، أَو قصيدة أَو حديثاً)، ومفردٍ يُرادُ به مُجردُ اللفظِ، مثلُ: (رأيتُ رجلاً يقولون له خليلاً) (أي يُسمُّونه بهذا الاسم): وأمَّا الجملة المحكِيَّة بالقول، فتكونُ في موضع نصب على أنها مفعوله، نحو: (قلتُ: لا إلهَ إلا اللهُ). وهمزةُ (إنَّ) تكسرُ بعد القول العَري عن الظن، وتُفتح بعد القول المَتضمّن معناهُ. كما سبق في مبحث (أن). 11- الإِلغاءُ والتَّعْليقُ في أَفعال الْقُلُوب الإلغاءُ: إِبطال عملِ الفعلِ القلبيِّ الناصبِ للمبتدأ والخبر لا لمانعٍ، فيعودان مرفوعينِ على الابتداءِ والخبرّةِ، مثل: (خالدٌ كريم ظننت). والإلغاء جائز في أَفعالِ القلوب إِذا لم تَسبقْ مفعولَيها. فإن تَوسطت بينهما فإعمالُها وإلغاؤها سِيّانِ. تقول: (خليلاً ظننت مجتهداً) و (خليلٌ ظننتُ مجتهد). وإن تأخرت عنهما جاز أن تَعمَل وإلغاؤها أَحسن، تقول: (المطر نازل حَسِبتُ)، و (الشمس طالعةً خلت). فإن تقدَّمت مفعولَيها، فالفصيح الكثيرُ إعمالها، وعليهِ أكثرُ النُّحاةِ، تقول: (رأيتُ الحقَّ أَبلجَ). ويجوزُ إهمالُها على قِلةٍ وضعفٍ، وعليه بعضُ النُّحاةِ، ومنه قولُ الشاعر: أَرْجُو وآمُلُ أنْ تَدْنو مَوَدَّتُها وما إخالُ لدَيْنا منْك تنويلُ وقول الآخر: كَذَاكَ أُدِّبْتُ، حتَّى صارَ مِنْ خُلقِي أَنِّي وَجَدْتُ مِلاكُ الشِّيمةِ الأَدَبُ والتعليقُ: إِبطالُ عملِ الفعل القلبيِّ لفظاً لا محلاً، لمانع، فتكونُ الجملةُ بعده في موضع نصبٍ على أَنها سادَّةٌ مَسدَّ مفعوليهِ، مثل: (علمتُ لخَالد شجاعٌ). فيجبُ تعليقُ الفعلِ، إذا كان هناك مانعٌ من إعماله. وذلك: إذا وقع بَعدَهُ أحدُ أربعةِ أَشياءَ: 1- ما وإنْ ولا النافياتُ نحو: (علمتُ: ما زُهيرٌ كسولاً. وظَننتُ: إنْ فاطمة مُهملة. ودخلتُ: لا رجلَ سُوءٍ موجودٌ. وحَسِبتُ. لا أُسامةُ بطيءٌ، ولا سُعادُ)، قال تعالى: {لَقد علمتَ، ما هؤلاءِ يَنطقونَ}. 2- لامُ الابتداءِ، مثلُ علمتُ: (لأخوكَ مجتهدٌ. وعلمتُ: إنَّ أخاكَ لمجتهدٌ). قال تعالى: {ولقد علموا: لِمَنِ اشتراهُ مالَهُ في الآخرةِ من خلاقٍ}. 3- لامُ القسمِ، كقول الشاعر: وَلَقَدْ عَلِمْتُ: لَتأْتِيَنَّ مَنِيَّتي إنَّ الْمَنَايَا لا تَطِيشُ سِهَامُها 4ـ الاستفهام، سواء أكان بالحرف، كقوله تعالى: {وإن أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما توعدون} أم بالاسم، كقوله عز وجلّ { لنعلم أي الحزبين أحصى لِما لبثوا أمداً}، وقوله { لتعلمن أيناّ أشدُ عذابا}. وسواء أكان الاستفهام مبتدأ، كما في هذه الآيات، أم خبراً، مثل: (علمتُ: متى السفر؟*1)، أم مضافاً الى المبتدأ، مثل: (علمتُ فرسُ أيهم تسبق؟) أم الى الخبر، مثل: (علمتُ: ابنُ من هذا؟*2). وقد يُعلقُ الفعلُ المتعدي، من غير هذه الأفعالِ، عن العمل، كقوله تعالى: {فَليَنظُر: أيُّها أزكى طعاماً؟*3}، وقوله: {ويَستنبئُونَكَ: أحقّ هُوَ؟*4}. وقد اختُصَّ ما يتصرّفُ من أفعال القُلوب بالإلغاءِ والتَّعليقِ. فلا يكونانِ في (هَبْ وتَعلَمْ)، لأنهما جامدانِ. [*1ـ متى: اسم استفهام. وهي ظرف زمان في موضع رفع على أنه خبر مقدم والسفر مبتدأ مؤخر. *2ـ ابن خبر مقدم. ومن: مضاف إليه. وذا مبتدأ مؤخر. *3ـ اسم الاستفهام ـ وهو أي ـ مبتدأ. وأزكى: خبره، والجملة في محل نصب لأنها مفعول ينظر، وقد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام. *4ـ حق: خبر مقدم، وهو: مبتدأ مؤخر، والجملة مفعول ثان ليستنبئ. وهي في موضع نصب، ومفعوله الأول ضمير المخاطب. ] وقد علمت أن الإلغاء جائز عند وجودِ سبيلهِ، وأن المُلغى لا عملَ له البتَةَ، وإنَّ المعلَّقَ، إن لم يعملْ لفظاً فهو يعمل النصبَ في مَحلِّ الجملةِ، فيجوزُ العطفُ بالنصب على محلها، فنقولُ: "علمتْ لخالد شجاعُ وسعيداً كريماً"، بالعطف على مَحلّ "خالد وسعيد"، لأنهما مفعولان للفعل المعلّق عن نصبهما بلام الابتداء. ويجوز رفعُهما بالعطف على اللفظ، قال الشاعر: وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ. ما الْبُكا ولا مُوجِعاتُ الْقَلْبِ؟ حَتَّى تَوَلَّتِ يُروَى بنصب موجعات، عطفاً على محل (ما البكا). ويجوزُ الرفعُ عطفاً على البكا. والجملةُ بعدَ الفعلِ المُعلَّقِ عن العمل في موضع نصبٍ على المفعولية. وهي سادّةٌ مَسدَّ المفعولينِ، إن كان يتعدّى إلى اثنينِ ولم ينصب الأوّلَ. فإن نصبَهُ سدَّت مسدّ الثاني، مثلُ: (علمتكَ أيَّ رجلٍ أنتَ؟). وإن كان يتعدّى إلى واحدٍ سدّت مسدّهُ، مثل: (لا تأتِ أمراً لم تعرفْ ما هُوَ؟). وإن كان يتعدَّى بحرف الجرّ، سقطَ حرفُ الجرّ وكانت الجملة منصوبة محلاًّ بإسقاط الجارِّ (وهو ما يسمُّونهُ النصبَ على نَزع الخافض)، مثل: (فكَّرت أصحيحٌ هذا أم لا؟)، لأن فكَّرَ يتعدَّى بفي، تقول: (فكَّرْتُ في الأمر). |
المفعولُ المطلقُ
المفعولُ المطلَقُ: مَصدرٌ يُذكرُ بعد فعلٍ من لفظهِ تأكيداً لمعناهُ، أو بياناً لِعَددِهِ، أو بياناً لنوعهِ، أو بَدَلاً من التلفُّظِ بفعلهِ. فالأول نحو: {وكلّم اللهُ مُوسى تكليماً}. والثاني نحو: (وقفتُ وقفتينِ). والثالثُ نحو: (سرتُ سيرَ العُقلاءِ). والرابعُ نحو: (صَبراً على الشدائد). واعلم أنّ ما يُذكرُ بدلاً من فعلهِ لا يُرادُ به تأكيدٌ ولا بيان عددٍ أو نوع. وفي هذا المبحث ستَّةَ مَباحث. 1- الْمَصْدَرُ المُبْهَمُ وَالْمَصْدَرُ المُخْتَصُّ المصدرُ نوعانِ: مُبهمٌ ومُختَص. فالمُبهم: ما يُساوي معنى فعلهِ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ، وإنما يُذكرُ لمجرّد التأكيد، (قمتُ قياماً. وضربتُ اللصّ ضرباً)، أو بدَلاً من التّلفّظِ بفعلهِ، نحو: (إيماناً لا كُفْراً)، ونحو: (سَمعاً وطاعةً)، إذِ المعنى: (آمِنْ ولا تكْفُرْ، وأَسمعُ وأُطيعُ). ومن ثمَّ لا يجوزُ تثنيتُهُ ولا جمعهُ، لأنَّ المؤكدَ بمنزلةِ تكرير الفعلِ، والبدل من فعلهِ بمنزلةِ الفعلِ نفسهِ، فعُومِلَ مُعاملتَهُ في عدَمِ التثنيةِ والجمعِ. والمختصُّ: ما زادَ على فعلهِ بإفادتهِ نوعاً أو عدداً، نحو: (سرتُ سَيرَ العُقلاءِ. وضربتُ اللصَّ ضرْبَتينِ، أو ضَرَباتٍ). والمُفيدُ عَدَداً يُثنّى ويُجمَعُ بلا خلافٍ. وأمّا المُفيدُ نوعاً، فالحقُّ أن يُثنَّى ويُجمَعُ قياساً على ما سُمعَ منهُ: كالعقولِ والألبابِ والحُلُوم وغيرها فيَصحُّ أن يُقالَ: (قمتُ قِيامَينِ)، وأنتَ تُريدُ نوعينِ من القيام. ويَختصُّ المصدرُ بألْ العهديَّةِ، نحو: (قمتُ القيامَ)، أي: (القيامَ الذي تَعهَدُ)، وبأل الجنسيّةِ، نحو: (جلستُ الجلوسَ)، تُريدُ الجنسَ والتنكير، وبوصَفهِ، نحو: (سعيتُ في حاجتك سعياً عظيماً)، وبإضافته، نحو: (سرتُ سيرَ الصالحينَ). [والأصل: (سرت سيراً مثل سير الصالحين)، حُذِف المصدر ـ الذي هو المفعول المطلق ـ ثم صفته، فقام مقام المصدر المضاف الى (مثل) فأُعرِب مفعولاً مطلقاً] 2- الْمَصْدَرُ المُتَصَرِّفُ والْمَصْدَرُ عَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ المصدرُ المتصرّف: ما يجوزُ أن يكونَ منصوباً على المصدريّة، وأن ينصرف عنها إلى وقوعهِ فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، أو مبتدأ، أو خبراً، أو مفعولاً بهِ، أو غيرَ ذلك. وهو جميعُ المصادر، إلا قليلاً جِدًّا منها. وهو ما سيُذكر. وغيرُ المتصرّفِ: ما يُلازمُ النصبَ على المصدريَّة، أي المفعوليّة المطلقةِ؛ لا يَنصرف عنها إلى غيرها من موقاع الإعراب، وذلك نحو: (سبحان ومَعاذَ ولَبيّكَ وسَعدَيكَ وحنَانَيكَ ودوَاليكَ وحَذارَيك). وسيأتي الكلام على هذه المصادر. 3- النائبُ عن المَصْدَر ينوب عن المصدر - فيُعطَى حكمَه في كونهِ منصوباً على أنه مفعولٌ مُطلَقٌ - اثنا عَشرَ شيئاً: 1- اسم المصدرِ، نحو: (أعطيتُك عَطاءً)، و (اغتسلتُ غُسلاً) و (كلّمتكَ كلاماً) و (سلّمتُ سلاماً). 2- صفتهُ، نحو: (سرت أحسنَ السيرِ) و {اذكروا الله كثيراً}. [واذكروا الله كثيراً: أي اذكروا الله ذكراً كثيراً: حُذف المصدر فقامت صفته مقامه] 3- ضميرُهُ العائدُ اليهِ، نحو: (اجتهدتُ اجتهاداً لم يجتهدهُ غيري). ومنه قَولهُ تعالى: {فإني أعذِّبُهُ عذاباً لا أعَذبُهُ أحداً من العالمينَ}. [ أي: لم يجتهد الاجتهاد المذكور. فالضمير عائد الى المصدر المذكور، وهو في محل نصب على أنه مفعول مطلق] ؛ و [ لا أعذب العذاب المذكور] 4- مرادفُهُ - بأن يكون من غير لفظهِ، معَ تَقارُب المعنى - نحو: (شَنِئْتُ الكسلانَ بُغضاً). و (قمت وقُوفاً) و (رُضتُه إذلالاً) و (أعجبني الشيء حُباً)، وقال الشاعر: يُعْجبُهُ السَّخُونُ والبَرُودُ والتَّمْرُ، حُبًّا ما لَهُ مَزِيدُ [السخون: مرقٌ يُسخن، والبُرود: خبزٌ يُبرد بالماء] 5- مصدر يُلاقيهِ في الاشتقاقِ، كقولهِ تعالى: {واللهُ أنبتَكم من الأرض نبَاتاً}، وقولهِ: {تَبتَّلْ إليهِ تَبتيلاً}. 6- ما يَدلُّ على نوعه، نحو: (رجعَ القهقرَى) و (قعدَ القُرفُصاءَ) و (جلسَ الاحتباءَ) و (اشتمل الصّمّاءَ). [الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه] 7- ما يدلُّ على عدده نحو: (أنذرتُك ثلاثاً)، ومنه قولهُ تعالى: {فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما ثمانينَ جلدةً}. 8- ما يدلُّ على آلته التي يكونُ بها، نحو: (ضربتُ اللصَّ سَوطاً، أو عصاً، ورشقتُ العدوَّ سهماً، أو رَصاصةً أو قذيفةً). وهو يَطّردُ في جميع أسماءِ آلاتِ الفعلِ. فلو قلتَ: (ضربتُه خشبةً، أو رميتُه كرسيّاً)، لم يَجُز لأنهما لم يُعهَدا للضرب والرمي. 9- (ما) و (أَيُّ) الإستفهاميَّتان، نحو: (ما أكرمتَ خالداً؟) و (أَيَّ عيشٍ تعيش؟)، ومنه قوله تعالى: {وسيعلمُ الذين ظَلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون}. [ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق مقدم لأكرمت. والمستفهم عنه المصدر. والمعنى: أي إكرام أكرمت خالداً؟] 10- (ما ومهما وأَيُّ) الشَّرطيّاتُ: (ما تجلسْ أجلسْ) و (مهما تقِفْ أَقِفْ) و (أَيَّ سَيرٍ تَسِرْ أَسِرْ). [ الثلاثة أسماء شرط جازمة تجزم فعلين. وهن في محل نصب مفعول مطلق للأفعال. والمعنى: أي جلوس تجلس أجلس] 11- لفظ كل وبعضٍ وأي الكماليّة، مضافاتٍ إلى المصدرِ، نحو: {فلا تَميلوا كلَّ المَيلِ} و (سَعَيتُ بعضَ السعيِ) و(اجتهدتُ أيَّ اجتهادٍ). (وهذا في الحقيقة من صفة المصدر عنه، لان التقدير: (فلا تميلوا ميلاً كلّ الميل. وسعيت سعياً بعضَ السعي. واجتهدت اجتهاداً أيّ اجتهاد). وسميت (أيّ) هذه بالكمالية، لأنها تدل على معنى الكمال. وهي إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها، نحو: (خالدٌ رجلٌ أيّ رجلٍ) أي: هو كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالاً منها، نحو: (مررت بعبد اللهِ أيّ رجل). ولا تُستعمل إلا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث، تشبيهاً لها بالصفات المشتقات. ولا تطابقه في غيرهما). 12- اسمُ الإشارةِ مُشاراً به إلى المصدر، سواءٌ أَأُتبعَ بالمصدر، نحو: (قلتُ ذلكَ القولَ) أم لا، كأن يُقال: ( هل اجتهدت اجتهاداً حسناً؟) فتقول: (اجتهدت ذلك). |
تابع للمفعول المطلق
4- عاملُ الْمَفْعول المُطْلَق يعملُ في المفعولِ المُطلقِ أحدُ ثلاثةِ عواملَ: الفعلُ التام المتصرّفُ، نحو: "أتقِنْ عملَك إتقاناً"، والصفةُ المُشتقّةُ منهُ، نحو: (رأيتُهُ مُسرعاً إسراعاً عظيماً)، ومصدرُه، نحو: (فرحتُ باجتهادك اجتهاداً حسناً)، ومنه قوله تعالى: {إنَّ جهنمَ جزاؤُكم جزاءً مَوفوراً}. 5- أَحكامُ المفعولِ المطلَق للمفعول المطلق ثلاثةُ أَحكام: 1- أنهُ يجبُ نصبُه. 2- أنهُ يجبُ أن يقعَ بعدَ العامل، إن كان للتأكيد. فإن كان للنَّوع أو العدَدِ، جاز أن يُذكرَ بعدَه أو قبله، إلا إن كان استفهاماً أو شرطاً، فيجبُ تَقدمُه على عاملهِ، كما رأيتَ في أمثلتهما التي تقدّمت. وذلكَ لأنَّ لأسماءِ لاستفهام والشرط صدرَ الكلام. 3- أنهُ يجوزُ أن يُحذَفَ عاملُهُ، إن كان نَوعيّاً أو عدديّاً، لقرينةٍ دالّةٍ عليه، تقولُ: (ما جلستَ)، فيقالُ في الجواب: (بَلى جُلوساً طويلاً، أَو جَلستينِ)، ويُقالُ: (إنك لا تعتني بعملك)، فتقولُ: (بلى اعتناءً عظيماً)، ويقال: (أيَّ سيرٍ سرتَ؟)، فتقول: (سيرَ الصالحينَ)، وتقول: لِمنْ تأهَّبَ للحجَّ: (حَجّاً مبروراً)، ولِمن قَدِمَ من سفَر: (قُدوماً مُباركاً) و (خيرَ مَقدَمٍ)، ولِمن يُعِدُ ولا يَفي: (مَواعيدَ عُرقوبٍ)* من ذلك قولهم: (غضَب الخيل على اللُّجم). *ـ [عرقوب: رجلٌ يُضرب به المثل بالإخلاف بالوعد: وذلك أنه وعد وعداً فأخلف فضرب به المثل لذلك. يُقال: إنه أتاه أخٌ له يسأله شيئاً، فقال عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع قال: إذا أبلح. فلما أبلح قال: إذا أزهى. فلما أزهى قال: إذا أرطب. فلما أرطب قال: إذا صار تمراً. فلما صار تمراً أخذه من الليل ولم يعطه شيئاً] وأمّا المصدرُ المؤكدَ فلا يجوزُ حذفُ عامله، على الأصحَ من مذاهب النحاة، لأنه إنما جيء به للتَّقوية والتأكيد. وحذفُ عامله يُنافي هذا الغرض. وما جِيء به من المصادر نائباً عن فعله (أي بدلاً من ذكر فعله)، لم يجُز ذركُ عامله، بل يحذفُ وجوباً، نحو: (سَقياً لكَ ورَعياً؛ ؛ صبراً على الشدائد؛ أتَوانياً وقد جَدَّ قُرناؤكَ؟؛ حمداً وشكراً لا كفراً؛ عجباً لك؛ تبّاً للخائنينَ؛ وَيْحَكَ. 6- الْمَصدَرُ النائبُ عن فعلهِ المصدرُ النائبُ عن فعله: ما يُذكرُ بَدلاً من التلفظ بفعله. وهو على سبعةِ أنواعٍ: أ- مصدرٌ يَقعُ مَوقعَ الأمر، نحو: (صبراً على الأذَى في المجد). ب- مصدرٌ يقعُ موقعَ النَّهي، نحو: (اجتهاداً لا كسلاً، جِداً لا تَوانياً؛ مَهلاً لا عجلةً؛ سُكوتاً لا كلاماً؛ صَبراً لا جَزَعاً). وهو لا يقع إلاّ تابعاً لمصدر يُرادُ به الأمر كما رأيت. ج- مصدرٌ يقعُ موقعَ الدعاءِ، نحو: (سَقياً لك ورَعياً؛ تَعساً للخائن؛ بُعداً للظالم، سُحقاً للَّئيم؛ جَدعاً للخبيثِ؛ رحمةً للبائس؛ عذاباً للكاذب؛ شقاءً للمهمل؛ بُؤْساً للكسلان؛ خَيبةً للفاسق؛ تَبّاً للواشي؛ نُكساً للمتكبِّر). ومنعَ سيبويه أن يُقاسَ على ما وَرَدَ من هذه الألفاظ. وأجاز الأخفش القياسَ عليها. وهو ما يظهرُ أنه الحقُّ. (ولا تُستعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح الكلام. فان أضفتها فالنصبُ حتمٌ واجب، نحو: (بُعدَ الظالم وسُحقَهُ). ولا يجوز الرفع لأنّ المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبرَ له وان لم تُضفها فلك أن تنصبها، ولك أن ترفعها على الابتداء، نحو: عذاباً له، وعذابٌ له). والنصب أولى. وما عُرَّف منها بأل فالأفضل فيه الرفع على الابتداء، نحو: (الخيبةُ للمفسد)). ومما يُستعمَلُ للدُّعاءِ مَصادرُ قد أُهملت أفعلها في الاستعمال، وهي: (ويلَهُ، وويَبَهُ، ووَيْحَهُ، ووَيسَهُ). وهي منصوبةٌ بفعلها المُهمَل، أو بفعل من معناها. ((ويل وويب): كلمتا تهديد تقالانِ عند الشتم والتوبيخ. و (ويح وويس) : كلمتا رحمة تقالان عند الإنكار الذي لا يراد به توبيخ ولا شتم؛ وإنما يراد به التنبيه على الخطأ. ثم كثرت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت كالتعجب، يقولها الإنسان لمن يجب ولمن يبغض. ومتى أضفتها لزمتِ النصب، ولا يجوز فيها الرفع، لان المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبر له. وان لم تُضفها فلك أن ترفعها، ولك أن تنصبها. نحو: (ويلٌ له وويحٌ له، وويلاً له وويحاً له) والرفع أولى). د- مصدرٌ يقعُ بعدَ الاستفهام موقعَ التوبيخ، أو التعجُّب، أو التوَجعِ، فالأول نحو: (أجُرأةً على المعاصي؟)، والثاني كقول الشاعر: أَشوْقاً؟ وَلَمَّا يَمْضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ المطِيُّ بِنَا عَشْرَا والثالث كقول الآخر: أَسِجْناً وقتْلاً واشتياقاً وغُرْبَةً وَنَأيَ حَبيبٍ؟ إنَّ ذا لَعَظيم وقد يكونُ الاستفهامُ مُقدَّراً، كقوله: خُمُولاً وإِهْمالاً؟ وَغَيْرُك مُولَعٌ بِتَثْبيتِ أَركانِ السِّيادَةِ والْمَجْدِ أي : أخمولاً؟ وهو هنا للتوبيخ. هـ- مَصادرُ مسموعةٌ كثرَ استعمالُها، ودلَّتِ القرائنُ على عاملها، حتى صارت كالأمثال، نحو: (سَمعاً وطاعةً؛ حمداً لله وشُكراً؛ عَجَباً؛ عجَباً لكَ؛، ويُقالُ: أتفعلُ هذا؟ فتقول: (أفعلُهُ، وكراهةً ومَسَرَّةً)، أو (لا أفعلُهُ ولا كَيْداً ولا همّاً) و (لافعلنَّهُ ورَغماً وهواناً). وإذا أفرَدْتَ (حمداً وشكراً) جاز إظهارُ الفعل، نحو: (أحمدُ اللهَ حمداً) و (أشكرُ اللهَ شًكراً). أمّا (لا كُفراً) فلا يُستعمل إلا معَ (حمداً وشكراً). ومن هذه المصادر (سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ). ومعنى (سبحانَ الله). تَنزيهاً للهِ وبراءَةً له مما لا يليقُ به. وعمى (مَعاذَ اللهِ) : عياذاً باللهِ، أي: أعوذُ به. ولا يُستعملان إلا مُضافينِ. و- المصدرُ الواقعُ تفصيلاً لمُجمَلٍ قبلَهُ، وتَبييناً لعاقبتهِ ونتيجتهِ كقوله تعالى: {فَشُدُّوا الوَثاقَ، فإمّا مَنّاً بعدُ، وإمّا فِداءً} ز- المصدرُ المؤكّدُ لمضمونِ الجملة قبلهُ. سواءٌ أَجيءَ بهِ لمجرَّد التأكيدِ (أيٍ: لا لدفعِ احتمال المجازِ، بسبب أنَّ الكلامَ لا يحتملُ غيرَ الحقيقةِ) نحو: (لكَ عليَّ الوفاءُ بالعهد حَقّاً)، أم للتأكيد الدافعِ إرادةَ المجاز نحو (هو أَخي حقّاً). فإنَّ قولكَ: (هو أَخي) يحتملُ أنك أردتَ الأخوَّة المجازيَّةَ، وقولكَ: "حقّاً، رفعَ هذا الاحتمال. ومن المصدر المؤكّدِ لمضمونِ الجملةِ قولهم: (لا أفعله بَتّاً وبَتاتاً وبَتَّةً والبَتَّةَ). |
المفعولُ لهُ
المفعولُ لهُ (ويُسمّى المفعولَ لأجلهِ، والمفعولَ من أجلهِ): هو مصدرٌ قَلبيٌّ يُذكرُ عِلّةً لحدَثٍ شاركهُ في الزمانِ والفاعلِ، نحو: (رغبةً) من قولكَ (اغتربتُ رَغبةً في العلم). (فالرغبة: مصدر قلبي، بين العلة التي من أجلها اغتربت، فان سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم, وقد شارك الحدثُ (وهو: اغتربت) المصدرَ (وهو: رغبة) في الزمان والفاعل. فإن زمانهما واحد وهو الماضي. وفاعلهما واحد وهو المتكلم. والمراد بالصدر القلبي: ما كان مصدراً لفعل من الأفعال التي منشؤُها الحواسّ الباطنة: كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل. ونحوهما. ويقابل أفعال الجوارح (أي الحواسّ الظاهرة وما يتصل بها) كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة، ونحوها). وفي هذا المبحث مبحثانِ: 1- شُروطُ نَصْبِ المفعولِ لأَجلهِ عَرفتَ، ممّا عَرَّفنا به المفعولَ لأجلهِ، أنه يُشترَطُ فيه خمسةُ شروطٍ. فإنْ فُقِدَ شرطٌ منها لم يَجُز نصبُهُ. فليسَ كلُّ ما يُذكر بياناً لسبب حُدوثِ الفعلِ يُنصَب على أنه مفعولٌ له. وهكاَ تفصيلَ شروط نصبه: أ ـ أن يكونَ مصدراً. (فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه كقوله تعالى: {والأرض وضعها للأنام}). ب- أن يكون المصدر قلبياً. (أي: من أفعال النفس الباطنة، فإن كان المصدر غير قلبي لم يجز نصبه، نحو: (جئت للقراءة)). ج ود- أن يكونَ المصدرُ القلبيُّ مُتَّحداً معَ الفعل في الزمان، وفي الفاعل. (أي: يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحداً، وفاعلهما واحداً. فإن اختلفا زماناً أو فعلاً لم يجز نصب المصدر. فالأول نحو: (سافرت للعمل). فإن زمان السفر ماضٍ وزمان العلم مستقبل والثاني نحو: (أحببتك لتعظيمك العلم). إذ أن فاعل المحبة هو المتكلم وفاعل التعظيم هو المخاطب. ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر: كجئت حباً للعلم، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر: كأمسكته خوفاً من فراره. أو بالعكس، كأدبته إصلاحاً له). 5- أن يكون هذا المصدرُ القلبي المُتَّحدُ معَ الفعل في الزمان والفاعل، عِلَّةً لحُصولِ الفعلِ، بحيثُ يَصِحُّ أن يقعَ جواباً لقولكَ: (لِمَ فعلتَ؟). (فإن قلت: (جئت رغبة في العلم)، فقولك: (رغبة في العلم) بمنزلة جواب لقول قائل: (لم جئت؟). فان لم يذكر بياناً لسبب حدوث الفعل، لم يكن مفعولاً لأجله، بل يكون كما يطلبه العامل الذي يتعلق به. فيكون مفعولاً مطلقاً في نحو: (عظمت العلماء تعظيماً)، ومفعولاً به في نحو (علمتُ الجبن معرةً)، ومبتدأ في نحو: (البخل داء)، وخبراً في نحو: (أدوى الأدواء الجهل)، ومجروراً في نحو: (أي داء أدوى من البخل)، وهلم جراً). ومثال ما اجتمعت فيهِ الشروطُ قولهُ تعالى: {ولا تقتلوا أولادَكم خشيةَ إملاقٍ، نحن نرزُقُهم وإيَّاكم}. فإن فُقدَ شرطٌ من هذه الشروطِ، وجب جرُّ المصدرِ بحرف جر يفيدُ التعليلَ، كاللامِ ومن وفي، فاللامُ نحو: (جئت للكتابةِ)، ومن، كقولهِ تعالى: {ولا تَقتُلوا أولادَكم من إملاقٍ* نحن نَرزُقكم وإيّاهم}،وفي، كحديثِ: (دخلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَستها، لا هي أطعمتها، ولا هيَ تركتها تأكلُ من خَشاشِ الأرض). [هذه الآية في سورة الأنعام 151؛ والآية التي قبلها في سورة الإسراء31. والفرق بين الآيتين: أن الأولى تنهاهم عن قتل أولادهم خوف فقر ربما يكون. والأخرى تنهاهم عن قتلهم لفقرٍ واقعٍ بالفعل. ولذلك قدم رزق أولادهم على رزقهم في الآية الأولى، ليبين لهم أنه قد ضمن رزقهم فلا يقتلوهم خشية الفقر. وقدم في الآية الثانية رزقهم على رزق أولادهم، لأن الفقر واقع بالآباء فعلاً. فهون الأمر عليهم بأن يرزقهم ويدافع عنهم الفقر. فلا يتخذوا الفقر الحاضر ذريعة للفتك بأولادهم.] 2- أَحكامُ الْمَفْعولِ لَهُ للمفعولِ من أجلهِ ثلاثةُ أحكام: أ- يُنصَبُ، إذا استوفى شروطَ نصبهِ، على أنهُ مفعولٌ لأجله صريحٌ. وإن ذُكرَ للتعليل، ولم يَستوف الشروطَ، جُرَّ بحرف الجرِّ المُفيدِ للتَّعليل، كما تقدَّمَ، واعتُبِرَ أنهُ في محلّ نصبٍ على أنه مفعولٌ لأجلهِ غيرُ صريحٍ، وقد اجتمع المنصوبان، الصريحُ وغيرُ الصريح، في قوله تعالى: {يجعلون أصابعَهم في آذانهم من الصّواعق حَذَرَ الموت}، وفي قول الشاعر: يُغضِي حَياءً، ويُغضَى من مَهابتِهِ فَلا يُكَلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتسِمُ (فقوله تعالى: {من الصواعق} في موضع نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح. وقوله: {حذر} مفعول لأجله صريح. وقول الشاعر: (حياء) مفعول لأجله صريح. وقوله: (من مهابته) في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح. ونائب فاعل (يغضى) ضمير مستتر يعود على مصدره المقدّر. والتقدير: (يغضى الإغضاءُ). ولا يجوز أن يكون (من مهابته) في موضع نائب الفاعل، لأن المفعول له لا يُقام مُقامَ الفاعل، لئلا تزول دلالته على العلة. وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل (في الجزء الثاني) أن المجرور بحرف الجر لا ينوب عن الفاعل؛ أن جُرّ بحرف جر يفيد التعليل). 2- يجوزُ تقديمُ المفعولِ لأجلهِ على عامله، سواءٌ أَنُصبَ أم جُرَّ بحرف الجرَّ، نحو: (رغبةً في العلم أتيتُ) و (للتِّجارةِ سافرتُ). 3- لا يجبُ نصبُ المصدر المُستوفي شروطَ نصبهِ، بل يجوزُ نصبُهُ وجرُّهُ. وهو في ذلك على ثلاثِ صوَر: أ ـ أن يَتجرَّدَ من (أَل) والإضافة، فالأكثر نصبُهُ، نحو: (وقفَ الناسُ احتراماً للعالِم). وقد يُجَرُّ على قلَّةٍ، كقوله: مَنْ أَمَّكُمْ، لِرَغْبَةٍ فِيكْم، جُبِرْ ومَنْ تَكونُوا ناصِريهِ يَنْتَصِرْ ب- أن يقترنَ بأل، فالأكثرُ جرهُ بحرفِ الجر، نحو: (سافرتُ للرغبة في العلم). وقد يُنصَبُ على قلةِ كقولهِ: لا أَقْعُدُ، الجُبْنَ، عنِ الْهَيْجاء وَلَوْ: تَوَالتْ زُمَرُ الأَعداءِ ج- أن يُضافَ، فالأمرانِ سواءٌ، نصبُهُ وجرُّه بحرف الجرّ، تقول: (تركتُ المنكَرَ خَشيةَ اللهِ، أو لخشيةِ الله، أو من خشيةِ اللهِ). ومن النصب قولهُ تعالى: {يُنفقونَ أموالَهُمُ ابتغاءَ مَرضاةِ اللهِ}، وقولُ الشاعر: وَأَغْفِرُ عَوْراءَ الْكريمِ ادِّخارَهُ وأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئيمِ تَكرُّما ومن الجرِّ قوله سبحانَهُ: {وإنَّ منها لمَا يَهبِط من خشيةِ اللهِ}. |
المفعولُ فيه
وهو المُسَمَّى ظَرْفاً المفعولُ فيه (ويُسمّى ظرفاً): هو اسمٌ يَنتصبُ على تقدير (في)، يُذكرُ لبيانِ زمان الفعل أو مكانهِ. (أما إذا لم يكن على تقدير (في) فلا يكون ظرفاً، بل يكون كسائر الأسماء، على حسب ما يطلبه العامل. فيكون مبتدأ وخبراً، نحو: (يومنا يومٌ سعيد)، وفاعلاً، نحو: (جاء يومُ الجمعة)، ومفعولاً به، نحو: (لا تضيع أيامَ شبابك). ويكون غير ذلك، وسيأتي بيانه. والظرف، في الأصل، ما كان وعاء لشيء. وتسمى الأواني ظروفاً، لأنها أوعية لما يجعل فيها. وسميت الأزمنة والأمكنة (ظروفاً). لأنّ الأفعال تحصل فيها، فصارت كالأوعية لها). وهو قسمانِ: ظرفُ زمانٍ، وظرفُ مكان. فظرفُ الزمان: ما يَدْلُّ على وقتٍ وقعَ فيه الحدثُ نحو: (سافرتُ ليلاً). وظرفُ المكان: ما يدلُّ على مكانٍ وقعَ فيه الحدثُ، نحو: (وقفتُ تحتَ عَلَمِ العلم). والظرفُ، سواءٌ أكانَ زمانياً أم مكانياً، إما مُبهَمٌ أو محدودٌ (ويقال للمحدود: المُؤقَتُ والمختصُّ أيضاً)، وإما مُتصرّفٌ أو غيرُ مُتصرفٍ. وفي هذا الباب ثمانيةُ مباحثَ: 1- الظَّرفُ المُبْهَمُ والظَّرفُ الْمَحْدُود المُبهَمُ من ظروفِ الزمانِ: ما دلَّ على قَدْرٍ من الزمان غير مُعيَّنٍ، نحو: (أبدٍ وأمدٍ وحينٍ ووقتٍ وزمانٍ). والمحدودُ منها (أو المُؤقَّتُ أو المختصُّ): ما دلَّ على وقتٍ مُقدَّرٍ مُعَيَّنٍ محدودٍ، نحو: (ساعةٍ ويومٍ وليلةٍ وأُسبوعٍ وشهرٍ وسنةٍ وعامٍ). ومنه أسماءُ الشهور والفُصولِ وأيام الأسبوع وما أُضيفَ من الظروف المُبهَمةِ إلى ما يزيلُ إبهامَهُ وشُيوعَهُ: كزمانِ الرَّبيعِ ووقتِ الصيف. والمُبهمُ من ظروف المكان: ما دلَّ على مكانٍ غيرِ مُعيَّنٍ (أي: ليس له صورةٌ تدرَكُ بالحسِّ الظاهر، ولا حُدودٌ لصورةٍ) كالجهاتِ الستَّ، وهيَ: ((أمامٌ (ومثلُها قُدَّامٌ) ووراءٌ (ومثلها خَلفٌ) ويَمينٌ، ويَسار (ومثلُها شمال) وفَوق وتحت))، وكأسماءِ المقادير المكانيّة: كمِيلٍ وفَرسخٍ وبَريدٍ وقَصبةٍ وكيلومترٍ، ونحوها، وكجانبٍ ومكانٍ وناحيةٍ، ونحوِها. ومن المُبهَمِ ما يكونُ مُبهمَ المكانِ والمسافةِ معاً: كالجهاتِ الستْ، وجانبٍ وجهةٍ وناحيةٍ. ومنه ما يكونُ مُبهمَ المكانِ مُعينَ المسافةِ: كأسماءِ المقادير، فهي شبيهةٌ بالمُبهم من جهةِ أنها ليست أشياءَ مُعيَّنةً في الواقع، ومحدودةٌ من حيثُ أنها مُعيّنةُ المقدار. (فمكان الجهات الست غير معين لعدم لزومها بقعة بخصوصها، لأنها أمور اعتبارية أي: باعتبار الكائن في المكان، فقد يكون خلفك أماماً لغيرك؛ وقد تتحول فينعكس الأمر. وهكذا مقدارها، أي مسافتها ليس له أمد معلوم. فخلفك مثلاً اسم لما وراء ظهرك الى ما لا نهاية. أما أسماءُ المقادير فهي، وان كانت معلومة المسافة والمقدار. لا تلزم بقعة بعينها، فإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين). والمختص منها (أو المحدودُ): ما دلَّ على مكانٍ معيَّنٍ، أي: له صورة محدودةٌ، محصورةٌ: كدارٍ ومدرسةٍ ومكتبٍ ومسجدٍ وبلدٍ. ومنهُ أسماءُ البلادِ والقُرَى والجبال والأنهارِ والبحار. 2- الظَّرْفُ المُتَصرِّفُ والظَّرفُ غَيْرُ المُتَصَرِّفِ الظّرفُ المتصرفُ: ما يُستعملُ ظرفاً وغيرَ ظرفٍ. فهو يُفارق الظرفيّة إلى حالةٍ لا تُشبهُها: كأن يُستعملَ مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً به، أو نحوَ ذلك، نحو: (شهرٍ ويومٍ وسنةٍ وليل)، ونحوها. فمِثالُها ظرفاً: (سرتُ يوماً أو شهراً أو سنةً أو ليلاً). ومثالُها غيرَ ظرف: (السنةُ اثنا عَشرَ شهراً. والشهرُ ثلاثون يوماً والليلُ طويل. وسرَّني يومُ قدومِكَ. وانتظرتُ ساعةَ لقائك. ويومُ الجمعة يومٌ مُباركٌ). والظرفُ غيرُ المُتصرفِ نوعانِ: النّوعُ الأولُ: ما يُلازمُ النصبَ على الظرفيّةِ أبدا، فلا يُستعمَلُ إلا ظرفاً منصوباً، نحو: (قَط وعوْضُ وبَينا وبينما وإذا وأَيَّانَ وأنّى وذا صَباحٍ وذاتَ ليلةِ). ومنه ما رُكِّبَ من الظروف: كصباحَ مساءَ وليلَ ليلَ. النوع الثاني: ما يَلزَمُ النصبَ على الظرفيّة أو الجرِّ بمن أو إلى أو حتى أو مُذ أو مُنذُ، نحو: (قَبل وبَعدَ وفوق وتحت ولدَى وَلدُنْ وعندَ ومتى وأينَ وهُنا وثَمَّ وحيث والآن). ((وتُجرّ (قبل وبعد) بمن، من حروف الجر. وتُجر (فوق وتحت) بمن والى. وتجر (لدى ولدن وعند) بمن. وتجر (متى) بالى وحتى. وتجر (أين وهنا وثم وحيث) بمن والى. وقد تجر (حيث) بفي أيضاً. وتجر (الآن) بمن والى ومذ ومنذ. وسيأتي شرح ذلك). 3- نَصْبُ الظَّرْفِ يُنصَبُ الظّرفُ الزَّماني مُطلقاً، سواءٌ أكانَ مُبهَماً أم محدوداً، أي: (مُختصاً)، نحو: (سرتُ حيناً، وسافرتُ ليلةً)، على شرط أن يَتضمنَ معنى (في). (فان لم يتضمن معناها، نحو: (جاءَ يومُ الخميس. ويومُ الجمعة يومٌ مبارك. واحترم ليلةَ القدر)، وجب أن تكون على حسب العوامل). ولا يُنصَبُ من ظروف المكان إلا شيئانِ: أ- ما كان منها مُبهَماً، أو شِبهَهُ، مُتَضمّناً معنى (في)، فالأول نحو: (وقفتُ أمامَ المِنبر)، والثاني نحو: (سرتُ فرسخاً). (فإن لم يتضمن معناها نحو: (الميل ثلث الفرسخ، والكيلومترُ ألفُ متر). وجب أن يكون على حسب العوامل). ب- ما كان منها مُشتقّاً، سواءٌ أكان مُبهماً أَم محدوداً، على شرطِ أن يُنصَب بفعلهِ المُشتقّ منهُ، نحو: (جلستُ مجلسَ أَهل الفضل. وذهبتُ مذهبَ ذَوِي العقلِ). فإن كان من غيرِ ما اشتُقَّ منهُ عاملُهُ وجبَ جَرُّهُ نحو: (أَقمتُ في مجلسك. وسرتُ في مذهبكَ). وأَمّا قولُهم: (هو مني مَقعَدَ القابلةِ. وفلانٌ مَزجَرَ الكلبِ. وهذا الأمرُ مُناطَ الثُّرَيّا)، فسماعِيٌّ لا يقاس عليه. (والتقدير: (مستقرَّ مقعد القابلة ومزجرَ الكلب ومناطَ الثريا). فمقعد ومزجر ومناط: منصوبات بمستقر، وهن غير مشتقات منه، فكان نصبهنّ بعامل من غير مادّة اشتقاقهنَّ شاذّاً). وما كان من ظروف المكان محدوداً، غيرَ مُشتقٍ، لم يجُز نصبُه، بل يجب جَرُّهُ بِفِي، نحو: (جلستُ في الدارِ. وأَقمتُ في البلد. وصلَّيتُ في المسجد). إلاَّ إذا وقعَ بعدَ (دخلَ ونَزَلَ وسكنَ) أَو ما يُشتقُّ منها، فيجوزُ نصبُهُ، نحو: (دخلتُ المدينةَ. ونزَلتُ البلَدَ. وسكنتُ الشامَ). (وبعض النحاة ينصب مثل هذا على الظرفية والمحققون ينصبونه على التوسع، في الكلام بإسقاط الخافض، لا على الظرفية، فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة، بإجراء الفعل اللازم مُجرى المتعدي. وذلك لانّ ما يجوز نصبه من الظروف غيرُ المشتقة يُنصب بكل فعل، ومثل هذا لا ينصب إلا بعوامل خاصة، فلا يقال: (نمت الدارَ، ولا صليتُ المسجدَ، ولا أقمتُ البلدَ) كما يقال: (نمت عندك. وصليت أمام المنبر. وأقمتُ يمينَ الصف)). |
تابع موضوع الظرف
4- ناصب الظَّرْف (أي العاملُ فيه) ناصبُ الظَّرفِ (أي العاملُ فيه النصبَ): هوَ الحدَثُ الواقع فيه من فعلٍ أو شِبههِ. وهو إمّا ظاهرٌ، نحو: (جلستُ أمام المِنبَرِ. وصُمتُ يومَ الخميسِ. وأنا واقفٌ لديك. وخالدٌ مسافرٌ يومَ السبتِ). وإمّا مُقدَّرٌ جوازاً، نحو: (فرسخينِ)، جواباً لمن قال لكَ: (كم سرتَ؟)، ونحو: (ساعتينِ)، لمن قال لك: (كم مشيتَ؟). وإمّا مُقدَّرٌ وجوباً، نحو: (أنا عندَك). والتَّقديرُ: (أنا كائنٌ عندَك). 5- مُتَعَلَّق الظَّرف كلُّ ما نُصبَ من الظروف يحتاجُ إلى ما يتعلّقُ بهِ، من فعلٍ أو شِبهه، كما يحتاجُ حرفْ الجر إلى ذلك. ومُتعلَّقُهُ إمّا مذكورٌ، نحو: (غبتُ شهراً. وجلستُ تحت الشجرة). وإمّا محذوف جوازاً أو وجوباً. فيُحذَفُ جوازاً، إنْ كان كوناً خاصاً، ودلَّ عليه دليلٌ، نحو: (عندَ العلماءِ)، في جواب من قال: أينَ أجلسُ؟). ويُحذَفُ وجوباً في ثلاثِ مسائلٌ: 1- أن يكون كوناً عامّاً يَصلُحُ لأن يُرادَ به كلُّ حَدَثٍ: كموجودٍ وكائن وحاصل. ويكونُ المتعلَّق المقدَّرُ إمّا خبراً، نحو: (العصفورُ فوقَ الغصنِ. والجنةُ تحت أقدامِ الأمهاتِ) وإمّا صفةً، نحو: (مررتُ برجل عندَ المدرسةِ). وإمّا حالاً، نحو: (رأيتُ الهلالَ بين السحابِ". وإمّا صِلةً للموصولِ، نحو: (حَضَرَ مَنْ عندَهُ الخبرُ اليقينُ). غيرَ أنَّ مُتعلّق الصلةِ يجبُ أن يُقدَّرَ فعلاً، كحصَل ويَحصلُ، وكان ويكون، ووُجِد ويُوجَدُ، لوجوبِ كونِها جملةً. 2- أن يكونَ الظرفُ منصوباً على الاشتغال، بأن يشتغلَ عنهُ العاملُ المتأخرُ بالعمل في ضميره، نحو: (يوم الخميس صُمتُ فيه. ووقت الفجر سافرتُ فيه). (فيوم ووقت: منصوبان على الظرفية بفعل محذوف، لاشتغال الفعل المذكور عن العمل فيهما بالعمل في ضميرهما. والفعل المحذوف مقدَّر من لفظ الفعل المذكور غير أنه يجوز التصريح به؛ كما علمت في باب الاشتغال). 3- أن يكون المتعلَّقُ مسموعاً بالحذف، فلا يجوزُ ذكرُهُ، كقولهم: (حينئذٍ الآنَ)، أي: (كان ذلك حينئذٍ، فاسمعِ الآنَ). (فحينئذ والآن: منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوباً؛ لأنه سُمع هكذا محذوفاً. وهذا كلام يقال لمن ذكر أمراً قد تقادمَ زمانه لينصرف عنه الى ما يعنيه الآن). 6- نائبُ الظَّرْفِ ينوبُ عن الظّرفِ - فيُنصَبُ على أنهُ مَفعولٌ فيهِ - أحد ستةِ أشياءَ: 1- المُضافُ إلى الظرفِ، ممّا دَلَّ على كُليّةٍ أو بعضيّة، نحو: (مشيتُ كلَّ النهارِ، أو كلَّ الفَرْسخِ، أو جميعَهُما أو عامّتهُما، أو بَعضَهما، أو نصفَهُما، أو رُبعَهُما). 2- صِفتُهُ، نحو: (وقفتُ طويلاً من الوقت وجلستُ شرقيَّ الدار). 3- اسم الإشارة، نحو: (مشيتُ هذا اليومَ مشياً مُتعِباً. وانتبذت تلكَ الناحية). 4- العدَدُ الممَيّزُ بالظرفِ، أو المضافُ إليه، نحو: (سافرتُ ثلاثين يوماً. وسرتُ أربعين فرسخاً. ولزمتُ الدارَ ستةَ أيام، وسرت ثلاثة فراسخَ). 5- المصدرُ المتضمنُ الظّرفِ، وذلك بأن يكون الظرف مضافاً إلى مصدر، فيُحذَفُ الظّرفُ المضاف، ويقوم المصدرُ (وهو المضاف إِليه) مَقامَهُ، نحو: (سافرتُ وقتَ طلوعِ الشمس).وأكثرُ ما يُفعلُ ذلك بظروف الزمان، بشرط أن تُعيَّن وقتاً أو مقداراً. فما يُعيّن وقتاً مثل: (قَدِمتُ قدومَ الرَّكبِ. وكان ذلك خُفُوقَ النّجمِ. وجئتكَ صلاةَ العصرِ)، وما يُعيّنُ مقداراً مثل: (انتظرتُكَ كتابةَ صفحتينِ، أو قراءَةَ ثلاثِ صفحاتٍ. ونمتُ ذهابَكَ إلى دارِكَ ورُجوعَكَ منها. ونَزَلَ المطرُ ركعتينِ من الصلاة. وأقمت في البلد راحةَ المسافرِ). وقد يكون ذلك في ظروف المكان، نحو: (جلستُ قربَكَ. وذهبتُ نحوَ المسجدِ). 6- ألفاظٌ مسموعةٌ توسعُوا فيها، فنصبوها نصبَ ظروفِ الزمانِ، على تضمينها معنى (في)، نحو: (أحقّاً أنك ذاهبٌ؟). والأصل (أفي حَقّ؟). وقد نُطِقَ بفي في قوله: أَفي الْحَقِّ أَني مُغْرَمٌ بِكِ هائِمٌ وأَنَّكِ لا خَلٌّ هَواكِ وَلا خَمْرُ [حقاً: منصوب على الظرفية. والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. والمصدر المؤول بأن: مبتدأ مؤخر. وهكذا ما سيأتي من الأمثلة.] ونحو: (غيرَ شَك أني على حقٍّ. وجهَدَ رأيي أنكَ مُصيبٌ. وظَنّ مني أنكَ قادمٌ). فائدة اعلمُ أنَّ ضميرَ الظّرفِ لا يُنصَبُ على الظرفيّة، بل يجبُ جرهُ بفي نحو (يومَ الخميسِ صُمتُ فيه)، ولا يُقالُ: (صُمتُهُ)، إلا إذا لم تضمّنهُ معنى (في)، فلكَ أن تنصبه بإسقاط الجارِّ على أنهُ مفعولٌ به تَوَسُّعاً، نحو: (إذ جاءَ يومُ الخميسِ صُمتُهُ"، ومنه قول الشاعر: (ويومٍ شَهِدناهُ سُليماً وعامراً). (فقد جعل الضمير في (شهدناه) مفعولاً به على التوسع بإسقاط حرف الجر. والأصل "ويوم شهدنا فيه عامراً وسليماً)). 7- الظَّرفُ المُعْرَب والظَّرفُ الْمَبْنِي الظروفُ كلها مُعرَبةٌ مُتغيرةُ الآخر، إلا ألفاظاً محصورةً، منها ما هو للزمان، ومنها ما هو للمكان، ومنها ما يُستعمَلُ لهما. فالظُروفُ المبنيّةُ المختصَّةُ بالزمانِ: إذا ومتى وأيانَ وإذْ وأمسِ والآن ومُذ ومُنذُ وقَطُّ وعَوْضُ وبَينا وبَينما ورَيْثُ ورَيْثما وكيفَ وكيفما ولمَّا. ومنها ما رُكِّبَ من ظروف الزمان، نحو: (زُرنا صبَاحَ مساءَ، وَليل لَيلَ، ونهارَ نهارَ، ويومَ يومَ). والمعنى: كلَّ صباحٍ، وكلَّ مساءٍ، وكلَّ نهارٍ، وكلّ يومٍ. والظروفُ المبنيّةُ المختصة بالمكانِ هي: (حيثُ وهُنا وثَمَّ وأينَ). ومنها ما قُطعَ عن الإضافةِ لفظاً من أسماءِ الجهاتِ الستّ. والظروف المبنيّةُ المشتركةُ بينَ الزمانِ والمكانِ هي: (أنّى وَلدَى ولَدُنْ). ومنها (قبلُ وبعدُ)، في بعض الأحوال. وسيأتي شرحُ ذلكَ كلّه. |
8- شَرْح الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ وبَيانٌ أَحكامِها
1- قَط: ظرفٌ للماضي على سبيل الاستغراق، يَستغرقُ ما مضى من الزَّمان، واشتقاقُهُ من (قَطَطتُهُ) - أي قطعته - فمعنى (ما فعلتُهُ قطُّ): ما فعلتُهُ فيما انقطعَ من عُمري. ويُؤتى به بعدَ النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاءِ الماضي، أو الاستفهامِ عنها. ومن الخطأ أن يقال: (لا أفعلُهُ قَطُّ)، لأنَّ الفعلَ هنا مُستقبَلٌ، و (قطّ) ظرفٌ للماضي. 2- عَوْضٌ: ظرفٌ للمستقبَلِ، على سبيل الاستغراق أيضاً، يستغرقُ جميعَ ما يُستقبلُ من الزمان. والمشهورُ بناؤهُ على الضمِّ. ويجوزُ فيه البناءُ على الفتح والكسر أيضاً. فإن أُضيفَ فهو مُعرَبٌ، نحو: (لا أفعلهُ عَوضَ العائضين). وهو منقولٌ عن العَوْضِ بمعنى الدَّهر. والعَوْضُ في الأصل: مصدرُ عاضهُ من الشيءِ يَعوضُهُ عَوْضاً وعِوَضاً وعِياضاً، إذا أعطاهُ عِوَضاً، أي خلفاً. سُميَ الدهرُ بذلك، لأنه كلما مضى منهُ جُزءٌ عُوَّضَ منه آخر، فلا ينقطعُ. ويُؤتى بعَوْضُ بعد النّفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاءِ المستقبَلِ، أو الاستفهام عن جميع أجزائهِ. فإذا قلت: (لا أفعلُهُ عَوْضُ)، كان المعنى: لا أفعلهُ في زمنِ من الأزمنةِ المُستقبلة. وقد يُستَعملُ للزمانِ الماضي. 3- بَيْنا وبَينما: ظرفان للزمانِ الماضي. وأصلهما: (بينَ)، أشبِعت فتحةُ النون، فكان منها (بيْنا). فالألفُ زائدةٌ، كزيادة (ما) في (بَيْنما). وهما تلزَمانِ الجُملَ الاسمية كثيراً، والفعليّةَ قليلاً. ومن العلماءِ من يَضيفُهما إلى الجملة بعدَهما. ومنهم من يكفُّهُما عن الإضافة بسببِ ما لحقهما من الزيادة. وهو الأقربُ، لبُعدهِ من التكلُّف. وأصلُ (بَينَ) للمكانِ: وقد تكونُ للزَّمان، نحو: (جئتُ بينَ الظهر والعصر). ومنه حديثُ: (ساعةُ الجُمعةِ بينَ خروجِ الإمامِ وانقضاءِ الصلاة). وإذا لحقتها الألف أو "ما" الزَّائدتانِ، اختصّتْ بالزمان، كما تقدَّم. 4- إذا: ظرفٌ للمستقبَل غالباً، مَتَضمنٌ معنى الشرطِ غالباً. ويختصّ بالدخول على الجملِ الفعليّة. ويكونُ الفعلُ معه ماضيَ اللَّفظِ مُستقبَلَ المعنى كثيراً؛ ومضارعاً دونَ ذلك. وقد اجتمعا في قول الشاعر: والنَّفْسُ راغبةٌ إِذا رَغَّبْتَها وَإِذَا تُرَدُّ إِلى قليلٍ تَقْنَعُ وقد يكونُ للزمان الماضي، كقوله تعالى: {وإذا رأَوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها}. وقد يتجرَّدُ للظرفية المحض، غيرَ مُتَضمنٍ معنى الشرط، كقوله تعالى: {والليل إذا يَغشَى، والنهارِ إذا تَجلّى}، وقولهِ: {واللَّيلِ إذا سَجى. 5- أَيَّانَ: ظرفٌ للمستقبل. يكونُ اسمَ استفهام، فَيُطلَبُ به تعيينُ الزَّمانِ المستقبل خاصةً. وأكثرُ ما يكونُ في مواضع التَّفخيم، كقوله تعالى: {يَسألُ أَيانَ يومُ الدِّين؟}. ومعناهُ: أَيُّ حينٍ؟ وأصلُهُ: (أيُّ آنٍ) فَخُفِّفَ، وصارَ اللفظانِ واحداً. وقد يتضمّنُ معنى الشّرط، فيجزمُ الفعلين، نحو: ( أيَّانَ تجتهدْ تَجدْ نجاح). 6- أنّى: ظرفٌ للمكان. يكونُ اسمَ شرطٍ بمعنى (أَينَ)، نحو: (أنّى تَجلسْ أجلسْ)، واسمَ استفهامٍ عن المكان، بمعنى (من أينَ؟)، كقوله تعالى: {يا مريمُ أنّى لكِ هذا؟} أي: (من أينَ)، ويكون بمعنى "كيفَ؟، كقوله سبحانهُ: {أنّى يُحيي هذهِ اللهُ بعدَ موتها؟} أي: (كيفَ يُحييها؟). ويكونُ ظرفَ زمانٍ بمعنى (متى؟)، للاستفهام، نحو: (أنّى جئتَ؟). 7- قَبلُ وبعدُ: ظرفانِ للزمانِ، يُنصبَانِ على الظّرفيّة أو يُجرَّانِ بمن، نحو: (جئتُ قبلَ الظهر، أو بعدَهُ، أو من قبلهِ، أو بعدهِ). وقد يكونانِ للمكان نحو: (داري قبلَ دارِك، أو بعدَها). وهما مُعْرَبان بالنّصبِ أو مجروران بمن. ويُبنيانِ في بعض الأحوال وذلك إذا قطعا عن الإضافة لفظاً لا معنًى - بحيثُ يَبقى المضافُ إليه في النية والتّقدير - كقوله تعالى: {للهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ}، أي: من قَبلِ الغلَبةِ ومن بعدها. فإن قُطِعا عن الإضافة لفظاً ومعنًى لقصدِ التّنكير - بحيثُ لا يُنوَى المضافُ إليه ولا يُلاحَظُ في الذهن - كانا مُعرَبين، نحو: (فعلتُ ذلكَ قبلاً، أو بعداً)، تَعني زماناً سابقاً أو لاحقاً، ومنه قول الشاعر: فَساغَ لِيَ الشَّرابُ، وكُنْتُ قَبْلاً أكادُ أَغَصُّ بالماءِ الْفُرَاتِ (واليك توضيح هذا البحث: إذا أردت قبليّةً أو بعديةً معينتين، عينتَ ذلك بالإضافة، نحو: (جئت قبل الشمس أو بعدها)، أو بحذف المضاف إليه وبناء (قبل وبعد) على الضم، نحو: (جئتك قبلُ أو بعدُ، أو من قبلُ أو من بعدُ)، تعني بذلك: قبل شيء معين أو بعده. فالظرف هنا، وان قُطع عن الإضافة لفظاً، لم يُقطع عنها معنى، لأنه في نية الإضافة. وان أردت قبليَّة أو بعديه غير معينتين، قلت: (جئتك قبلاً، أو بعداً، أو من قبلٍ أو من بعدِ). بقطعهما عن الإضافة لفظاً ومعنى وتنوينهما، قصداً الى معنى التنكير والإبهام). 8- لَدَى ولَدُنْ: ظرفانِ للمكان والزمان، بمعنى: (عن)، مَبنيّانِ على السكون. والغالبُ في (لَدُنْ) أن تُجرَّ بمن، نحو: {وعلَّمناهُ من لَدُنّا علماً}. وقد تُنصَبُ مَحلاًّ على الظرفيّة الزمانية، نحو: (سافرتُ لَدُنْ طُلوعِ الشمسِ)، أو المكانيّة، نحو: (جلستُ لَدُنْك). وإذا أُضيفت إلى ياء المتكلم لَزمتها نونُ الوقاية، نحو: (لَدُنِّي). وهي تَضافُ إلى المفرد، كما رأيتَ، وإلى الجملة، نحو: "انتظرتُك من لَدُنْ طلعت الشمسُ إلى أن غَربتْ". وإن وقعت بعدَها (غُدْوَةٌ) نحو: جئتُك لَدُن غُدْوَة) جاز جرها بالإضافة إلى (لَدُنْ). وجاز نصبُها على التَّمييز، أو على أنها خبرٌ لكان المُقدَّرة معَ اسمها. والتقديرُ: (لَدُنْ كان الوقتُ غُدوةً) وجاز رفعُها على أنها فاعلٌ لفعل محذوف. والتقديرُ: (لَدُنْ كانت غدوةٌ) أي: (وُجِدتْ). فكان هنا تامّة. والغالبُ على (لَدَى) النّصبُ محلاً على الظرفيّة الزمانيّة، نحو: (جئتُ لَدَى طُلوعِ الشمس)، أو المكانيّة، نحو: (جلست لَديكَ). وقد تُجرُّ بمن، نحو: (حَضَرتُ من لَدَى الأستاذ). ولا تقعُ (لَدُنْ) عمدةً في الكلام، فلا يُقالُ: (لدُنهُ عِلم)، بخلافِ (لَدَى) فتقعُ، نحو: (ولَدَينا مَزيدٌ). وكذلك (عند) تقعُ عُمدة، نحو: (عندَك حُسنُ تدبيرٍ). ولا تكون (لَدى وَلدُنْ) إلا للحاضر. فلا يُقال: (لديَّ كتابٌ نافعُ)، إلا إذا كان حاضراً. أمّا (عند) فتكون للحاضر والغائب. ولا تُجرُّ (لَدَى ولَدُنْ وعند) بحرف جرّ غيرِ (من)، فمن الخطأ أن يُقال: (ذهبتُ إلى عندهِ). وكثيرٌ من الناس يُخطئُون في ذلك. والصوابُ أن يقال: (ذهبتُ إليه، أو إلى حضرتهِ). وإذا اتصلَ الضميرُ بِلَدَى انقلبت ألفها ياءً، نحو: (لَدَيه ولديهم ولدينا). يتبع في هذا المجال |
تابع لما قبله
9- مَتى: ظرفٌ للزمان، مبني على السكون. وهو يكون اسمَ استفهامٍ، منصوباً محلاً على الظرفيّة، نحو: (متى جئتَ؟)، ومجروراً بإلى أو حتى، نحو: (إلى متى يرتَعُ الغاوي في غيَّه؟ وحَتّى متى يبقى الضّال في ضلالهِ؟). ويكونُ اسمَ شرطٍ، نحو: (متى تُتقنْ عملَكَ تبلغْ أملَكَ). ومتى تضمّنت (متى) معنى الشرط لَزِمتِ النصبَ على الظرفية، فلا تُستعملُ مجرورةٌ. 10- أينَ: ظرفٌ للمكانِ، مبنيٌّ على الفتح. وهو يكونُ اسمَ استفهامٍ، منصوباً على الظرفيّة، فَيُسأل به عن المكان الذي حلَّ فيه الشيءُ، نحو: (أينَ خالدٌ؟ وأينَ كنتَ؟). ومجروراً بمن، فيُسألُ به عن مكانِ بُروزِ الشيءِ، نحو: (من أَينَ جِئتَ؟)، ومجروراً بإلى، فيُسألُ به عن مكان انتهاءٍ الشيءِ. نحو: (إلى أينَ تذهبُ؟). ويكونُ اسمَ شرطٍ. وحينئذٍ يَلزَمُ النصبَ على الظرفيّة، نحو: (أينَ تَجلسْ أجلسْ) وكثيراً ما تلحقُهُ (ما) الزائدةُ للتّوكيد، نحو: {أينما تكونوا يُدرِكُكُمُ الموتُ}. 11- هنا وثَمَّ: اسما إشارةٍ للمكان. فهُنا: يُشار به إلى المكان القريب وثَمَّ: يُشار به إلى البعيد. والأول مبني على السكون. والآخرُ مبنيّ على الفتح. وقد تلحقُهُ التاءُ لتأنيث الكلمة، نحو: (ثَمَّةَ). ومَوضعُها النصبُ على الظرفية. وقد يُجرَّان بمن وبإلى. 12- حيثُ: ظرفٌ للمكان، مبنيٌّ على الضمِّ، نحو: (إجلِسْ حيثُ يجلسُ أهلُ الفضلِ)، ومنهم من يقول، (حَوْثُ). وهي ملازمةٌ الإضافةَ إلى الجملة. والأكثرُ إضافتُها إلى الجملة الفعليّة، كما مُثِّلَ. ومن إضافتها إلى الاسميةِ أن تقولَ: (إجلِسْ حيثُ خالدٌ جالسٌ). ولا تُضاف إلى المفردِ. فإن جاءَ بعدَها مفردٌ رُفعَ على أنهُ مبتدأ خبرُهُ محذوف، نحو: (إجلسْ حيثُ خالدٌ)، أي: (حيث خالدٌ جالس). وقد تُجرُّ بمن أو إلى، نحو: (إرجِعُ من حيثُ أتيتَ إلى حيثُ كنتَ). وأقلُّ من ذلك جرُّها بالباءِ أو بفي. وإذا لحقتها (ما) الزائدة كانت اسمَ شرطٍ، نحو: (حيثُما تذهبْ أذهبْ). 13- الآن: ظرفُ زمانٍ للوقت الذي أنت فيهِ، مبني على الفتح. ويجوز أن يدخلهُ من حروفِ الجرَّ (من وإلى وحتى ومُذْ ومُنذُ)، مبنياً مَعَهنَّ على الفتح. ويكون في موضعِ الجرِّ. 14- أمسِ: له حالتان: إحداهما أن تكون معرفةً، فتُبنى على الكسر، وقد تُبنى على الفتح نادراً. ويُرادُ بها اليومُ الذي قبلَ يومكَ الذي أنت فيه، نحو: (جئتُ أمسِ). وتكونُ في موضع نصب على الظرفيّة الزمانية. وقد تخرجُ عن النصب على الظرفية، فتجرُّ بمن أو مُذْ أو منذُ. وتكونُ فاعلاً أو مفعولاً به أو غيرَهما. ولا تخرجُ في ذلك كلهِ عن بنائها على الكسر قال الشاعر: أَلَيْومَ أَعلمُ ما يَجِيءُ بهِ وَمَضى بِفَصلِ قَضائهِ أَمْسِ ومن العرب من يُعربها إعرابَ ما لا ينصرفُ وعليه قولهُ: إني رَأَيتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا عَجائِزاً مِثْلَ السَّعالِي خَمْساً وقول الآخر: اعتَصِمْ بالرَّجاءِ إِنْ عَنَّ يَأسُ وَتَناسَ الَّذي تَضَمَّنَ أَمْسُ ومنعُها من الصّرف هو للتعريف والعَدْل، لأنها معدولةٌ عن الأمس. كما أنَّ (سحَرَ) معدولٌ عن السَّحَر. كما سبقَ في إعراب ما لا ينصرف. والحالةُ الثانيةُ أن تدخلَ عليها (أل)، فتُعرَبُ بالإجماع، ولا يُرادُ بها حينئذٍ أمس بعينهِ، وإنما يُرادُ بها يومٌ من الأيام التي قبل يومك. وهي تتصرّفُ من حيثُ موقعُها في الإعراب تَصرُّفَ (أمس). 15- دُون: ظرفٌ للمكان. وهو نقيضُ (فوْق)، نحو (هو دونَه)، أي: أحُّط منه رتبةً، أو منزلةً، أو مكاناً. وتقولُ: (قعدَ خالدٌ دونَ سعيدٍ) أي: في مكانٍ مُنخفض عن مكانه. وتقولُ: (هذا دُونَ ذاك)، أي: هو مُتسفّلٌ عنه. ويأتي بمعنى (أمام) نحو: (الشيء دونَك)، أي: (أمامَكَ) وبمعنى (وراءه)، نحو: (قعدَ دُونَ الصَّفِّ)، أي: وراءَه. وهو منصوبٌ على الظرفيةِ المكانيّة، كما رأيتَ. وقد يأتي بمعنى (رديءِ وَخسيسٍ) فلا يكون ظرفاً، نحو: (هذا شيءٌ دُونٌ) أي: خسيسٌ حقيرٌ. وهو حينئذٍ يتصرَّفُ بوجوهِ الإعرابِ. وتقولُ: (هذا رجلٌ من دُونٍ. وهذا شيءٌ من دونِ). هذا أكثرُ كلامِ العرب، ويجوز حذفُ (من)، كما تقدَّمَ وتُجعَلُ (دون) هي النّعت. وهو مُعرَبٌ. لكنَّه يُبنى في بعض الأحوال، وذلكَ إذا قطع عن الإضافةِ لفظاً ومعنى، نحو: "جلستُ دونُ"، بالبناءِ على الضم. ويكونُ في موضع نصب. 16- رَيْثَ : ظرفٌ للزمان منقول عن المصدر. وهو مصدر (راثَ يَريثُ رَيْثاً)، إذا أبطأ، ثُمَّ ضُمنَ معنى الزمان. ويُرادُ به المقدارُ منه، نحو: (انتظرتُه رَيثَ صَلَّى. وانتظرني رَيثَ أجيءُ)، أي: قدْرَ مُدَّةِ صلاتهِ، وقدرَ مدة مجيئي. ولا يَليهِ إلا الفعلُ، مُصدَّراً بما أو أنْ المصدريتين، أو مُجرَّداً عنهما فالأول نحو: (انتظرني رَيثما أحضُرُ. وانتظرتُهُ رَيثَ أن صَلّى)، فيكون حينئذ مضافاً إلى المصدر المُؤوّل بِهما والثاني تقدّم مثاله. وإذا لم يُصَدّر الفعلُ بهما، أُضيفَ ( رَيْث) إلى الجملة. 1 |
17- معَ:
ظرفٌ لمكانِ الاجتماع ولزمانهِ، فالأول نحو: (أنا معكَ)، والثاني نحو: (جئتُ معَ العصر). وهو مُعرَب منصوب وقد يُبنى على السكون. (وذلك في لغة غُنْمٍ ورَبيعة)، فيكون في محلِّ نصبٍ. وإذا وَلِيَهُ ساكنُ حُرِّكَ بالكسر، على هذه اللغة، تَخلصاً من التقاءِ الساكنينِ، نحو: (جئتُ معِ القومِ). وأكثرُ ما يُستعملُ مضافاً، كما رأيتَ. وقد يُفرَدُ عن الإضافة، فالأكثر حينئذٍ أن يقعَ حالاً، نحو: "جئنا معاً" أي: جميعاً، أو مجتمعينِ. وقد يقعُ في موضع الخبر، نحو: "سعيدٌ وخالدٌ معاً"، فيكونُ ظرفاً متعلقاً بالخبر. والفرقُ بين "مع"، إذا أُفردت، وبينَ "جميعاً" أنكَ إذا قلتَ: "جاءُوا معاً"، كان الوقتُ واحداً. وإذا قلتَ: "جاءوا جميعاً"، احتمل أن يكونَ الوقتُ واحداً، واحتملَ أنهم جاءُوا مُتفرِّقينَ في أوقات مختلفة. 18- كيفَ: اسمُ استفهام. وهي ظرفٌ للزمان عندَ سيبويهِ، في موضع نصبٍ دائماً، وهي مُتعلقةٌ إما بخبرٍ، نحو: (كيفَ أنت؟ وكيفَ أصبحَ القومُ؟)، وإمّا بحالٍ، نحو: (كيفَ جاءَ خالدٌ؟). والتقديرُ عندهُ: (في أي حالٍ، أي على أي حالٍ؟). والمُعتمَدُ أنها للاستفهامِ المجرّدِ عن معنى الظرفيّة، فتكون هي الخبرَ أو الحال، لا المتعلّقَ المقدّر. وتكون أيضاً ثانيَ مفعولَيْ "ظنّ" وأخواتها، لأنه في الأصل خبرٌ، نحو: "كيفَ ظننتَ الأمرَ؟". وقد تكون اسمَ شرطٍ فيجزمُ فعلين، عندَ الكوفيين، نحو: (كيفَ تجلسْ أجلسْ، وكيفما تكنْ أكنْ). وهي، عند البصريين، اسمُ شرطٍ غيرُ جازم. 19- إذْ: ظرفٌ للزمانِ الماضي، نحو: (جئتُ إذْ طلعت الشمسُ). وقد تكونُ ظرفاً للمستقبَل، كقوله تعالى: {فسوف يعلمونَ إذِ الأغلال في أعناقهم}. وهي مبنيةٌ على السكون في محل نصبٍ على الظرفية. وقد تقعُ موقعَ المضاف إليه، فتُضافُ إلى اسمِ زمانٍ، كقولهِ تعالى: {رَبَّنا لا تزغْ قُلوبَنا بعدَ إذْ هَدَيتنا}. وقد تقعُ موقعَ المفعولِ به (أو البدل منه). فالأولُ كقوله سبحانه: {واذكرُوا إذ كنتم قليلاً}. والثاني كقولهِ: {واذكرْ في الكتاب مريمَ، إذ انتبذتْ من أهلها مكاناً شرقيّاً}. وهي تلزمُ الإضافةَ إلى الجُمل، كما رأيتَ. فالجملةُ بعدها مضافة إليها. وقد يُحذف جزء الجملة التي تضافُ إليها، كقول الشاعر: هَلْ تَرجِعَنَّ لَيالٍ قَدْ مَضَيْنَ لَنا وَالْعَيْشُ مُنَقَلِبٌ إذْ ذَاكَ أَفْناناً وقد تُحذَفُ الجملةُ كلُّها، ويُعوَض عنها بتنوينِ (إذ) تنوين العِوَض، كقوله تعالى: {فلَولا إذْ بلغتِ الرُّوحُ الحُلْقُومَ، وأنتم حينئذٍ تَنظُرونَ} أي: وأنتم حينَ إذْ بلغت الروحُ الحُلقوم تَنظرون. 20- لمَّا: ظرفٌ للزمانِ الماضي، بمعنى (حينٍ) أو (إذْ). وهي تقتضي جملتينِ فعلاهما ماضيانِ. ومحلها النصبُ على الظرفية لجوابها. وهي مضافة إلى جملةِ فعلِها الأول والمُحقّقون من العلماءِ يَرَوْنَ أنها حرفٌ لربطِ جُملتيها. وسمّوها حرفَ وُجودٍ لوجودِ. أي: هو للدَّلالة على وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرِهِ. وسترى توضيحَ ذلك في كتاب الحروف. إن شاءَ الله. 21- مُذ ومُنذُ: ظرفانِ للزّمان. و (مُذْ) مُخفَّفةٌ من (منذُ). و (منذُ) أصلُها (من) الجارَّةُ و (إذ) الظرفيّةُ، لذلك كُسرت مِيمُها في بعض اللُّغاتِ باعتبار الأصلِ. وإن وَلِيهما جملةٌ فعليّةٌ، أو اسميّةٌ، كانا مُضافينِ إليها، وكانت الجملةٌ بعدَهما في موضع جَرّ بالإضافةِ إليهما، نحو: (ما تركتُ خدمةَ الأمةِ مُنذُ نَشأتُ. وما زلتُ طَلاباً للمجد مُذْ أنا يافِعٌ). وإن وَلِيَهما مُفردٌ جاز رفعُهُ على أنهُ فاعلٌ لفعلٍ محذوف، نحو: (ما رأيتكَ منذ يومُ الخميسِ، أو مُذْ يومانِ). والتقديرُ: منذ كان أو مضى يوم الخميسِ، أو يومانِ. فالجملةُ المركبةُ من الفعل المحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالإضافة إلى مذ أو منذُ. و لكَ أن تَجُرّهُ على أنهما حرفا جرٍّ، شبيهانِ بالزائدِ، نحو: (ما رأَيتك مذْ يومٍ أو منذُ يومينِ). 22- عَلُ: ظرفٌ للمكان بمعنى (فَوقُ). ولا يستعملُ إلا بمن ولا يضافُ لفظاً على الصّحيح، فلا يُقالُ: (أخذتُهُ من عَلِ الخزانة)، كما يقال: (أخذتهُ من عُلوها ومن فوقها). وأجاز قومٌ إضافتهُ. |
المفعول معه
المفعولُ مَعَهُ: اسمٌ فضلةٌ وقعَ بعد واوٍ، بمعنى (مع) مسبوقةً بجملةٍ، ليدُلَّ على شيءٍ حصلَ الفعلُ بمُصاحبتِه (أي: معهُ)، بلا قصدٍ إلى إشراكِهِ في حكم ما قبلهُ، نحو: (مَشيتُ والنّهرَ). وفي هذا المبحث ثلاثة مباحثَ: 1- شُرُوطُ النصْبِ عَلى المعِيَّة يشترط: في نصبِ ما بعد الواو، على أنه مفعولٌ معهُ، ثلاثةُ شُرُوط: أ- أَن يكون فضلةً (أَيْ: بحيثُ يصحُّ انعقادُ الجملةِ بدونه). (فان كان الاسم التالي للواو عمدة، نحو: (اشترك سعيدٌ وخليلٌ)، لم يجز نصبه على المعية، بل يجب عطفه على ما قبله، فتكون الواو عاطفة. وإنما كان (خليل) هنا عمدة، لوجوب عطفه على (سعيد) الذي هو عمدة. والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وإنما وجب عطفه لأنّ فعل الاشتراك لا يقع إلا من متعدد. فبالعطف يكون الاشتراك مسنداً إليهما معاً. فلو نصبته لكان فضلة، ولم يكن له حظّ في الاشتراك حاصلاً من واحد، وهذا ممتنع). ب- أن يكونَ ما قبلَهُ جملةً. (فان سبقه مفرد، نحو: (كلّ امرئ وشأنهُ)، كان معطوفاً على ما قبله. وكل: مبتدأ. وامرئ: مضاف إليه. وشأنه: معطوف على كل. والخبر محذوف وجوباً. كما تقدم نظيره في باب (المبتدأ والخبر). والتقدير: كل امرئ وشأنهُ مُقترنانِ. ولك أن تنصب (كل)، على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: (دع أو اترك)، فتعطف (شأنه) حينئذ عليه منصوباً). ج- أن تكونَ الواوُ، التي تسبقُهُ، بمعنى (مَعَ). (فان تعين أن تكون الواو للعطف، لعدم صحة المعية، نحو: (جاء خالدٌ وسعيدٌ قبله، أو بعده)، فلم يكن ما بعدها مفعولا معه، لأن الواو هنا ليست بمعنى (مع)، إذ لو قلت: (جاء خالد مع سعيد قبله، أو بعده) كان الكلام ظاهر الفساد. وإن تعين أن تكون واوً الحال فكذلك، نحو: (جاء علي والشمسُ طالعة)). ومثالُ ما اجتمعت فيه الشُّروطُ: (سارَ علي والجبلَ. وما لكَ وسعيداً*؟ وما أنت وسليماً.* [ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ولك: متعلق بالخبر المحذوف. والتقدير: ما حاصل لك، و(سعيداً): مفعول معه.] [ما: استفهامية في محل رفع خبر مقدم، وأنت: مبتدأ مؤخر. (سليماً: مفعول معه)] 2- أَحكامُ ما بعدَ الواوِ للاسمِ الواقعِ بعد الواو أربعةُ أحكام: وجوبُ النّصبِ على المعيّةِ، ووجوبُ العطفِ، ورُجحانُ النصبِ، ورجحانُ العطف. فيجب النصبُ على المعيّةِ (بمعنى أنه لا يجوزُ العطف) إذا لزمَ من العطف فسادٌ في المعنى، نحو: (سافرَ خليلٌ والليلَ. ورجعَ سعيدٌ والشمسَ) ومنه قولهُ تعالى: {فأجمِعُوا أمرَكم وشُرَكاءَكم}، وقولهُ: {والذين تَبَوَّؤُا الدارَ والإيمانَ}. (وإنما امتنع العطف، لأنه يلزم منه عطف الليل على خليل، وعطف الشمس على سعيد، فيكونان مسنداً إليهما، لأن العطف على نية تكرير العامل، والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظاً ومعنى، كما لا يخفى، فيكون المعنى: (سافر خليل وسافر الليل، ورجع سعيد ورجعت الشمس) وهذا ظاهر الفساد. ولو عطفتَ (شركاءكم)، في الآية الأولى، على (أمركم) لم يجز، لأنه يقال: (أجمع أمرَهُ وعلى أمره)، كما يقال: (عزمه وعزم عليه)، كلاهما بمعنى واحد. ولا يقال: (أجمع الشركاء أو عزم عليهم). بل يقال: (جمعهم). فلو عطفت كان المعنى: (اعزموا على أمركم واعزموا على شركائكم)... وذلك واضح البطلان. ولو عطفتَ الإيمانَ على الدار، في الآية الأخرى، لفسد المعنى، لأنّ الدار. أن تُتَبَوَّأ - أي تُسكن - فالإيمان لا يُتَبوأ. فما بعد الواو، في الآيتين، منصوب على أنه مفعول معه. فالواو واو المعية. ويجوز أن تكون الواو في الآيتين، عاطفة وما بعدها مفعول به لفعل محذوف تقديره في الآية الأولى: (ادعوا واجمعوا)- فعل أمر من الجمع - وفي الثانية: (أخلصوا) - فعل ماض من الإخلاص - فيكون الكلام من عطف جملة على جملة، لا من عطف مفرد على مفرد. ويجوز أن يكون شركاءَكم معطوفاً على (أمركم) على تضمين (أجمعوا) معنى (هيئوا). وأن يكون الإيمان معطوفاً على تضمين (تبوؤا) معنى (لزموا). والتضمين في العربية باب واسع). ويجبُ العطفُ (بمعنى أنه يمتنع النصبُ على المعيّة) إذا لم يَستكمل شروطَ نصبهِ الثلاثةَ المتقدمةَ. ويرَجّحُ النصبُ على المعيّة، مَعَ جواز العطفِ، على ضَعفٍ، في موضعين: أ- أن يلزمَ من العطف ضعفٌ في التركيب، كأن يلزمَ منه العطفُ على الضمير المُتّصلِ المرفوعِ البارز، أو المستتر، من غير فصلٍ بالضمير المنفصل، أو بفاصلٍ، أيِّ فاصلٍ، نحو: (جئتُ وخالداً. واذهبْ وسليماً). ويَضعُفُ أن يُقالَ: "جئتُ وخالدٌ. واذهبْ وسليم). (أي بعطف (خالد) على التاء في (جئت)، وعطف (سليم) على الضمير المستتر في (اذهب). والضعف إنما هو من جهة الصناعة النحوية الثابتة أصولها باستقراء كلام العرب. وذلك أن العرب لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز أو المستتر، إلا أن يفصل بينهما بفاصل ضميراً منفصلاً يؤكد به الضميرُ المتصل أو المستتر، نحو: (جئت أنا وخالد. واذهب أنت وسعيد)). أما العطفُ على الضمير المنصوب المتّصل، فجائزٌ بلا خلافٍ، نحو: (أَكرمتكَ وزُهيراً). وأما العطفُ على الضمير المجرور، من غير إعادة الجارّ، فقد منعه جمهور النُّحاةِ، فلا يقالُ على رأيهم: (أحسنتُ إليك وأبيك)، بل: (أحسنتُ إليك وأباكَ)، بالنصب على المعيّة. فإن أعدتَ الجار جازَ، نحو: (أحسنتُ إليك وإلى أبيك). والحقُّ أنه جائز. وعلى ذلك الكسائيُّ وابنُ مالكٍ وغيرُهما. وجعلوا منه قولهُ تعالى: {وكُفرٌ بهِ والمسجدِ الحرام} وقد قرئَ في السبعِ: {واتقوا اللهَ الذي تساءَلونَ بهِ والأرحامِ}، بجرّ (الأرحامِ) عطفاً على الهاء في (به)، قرأ ذلك حمزةُ، أحدُ القُرَّاءِ السبعة. لكنَّ الأكثرَ والأفصحَ إعادةُ الجارَ، إذا أُريد العطفُ. كما تقدّم. ب- أن تكونَ المعيّةُ مقصودةً من المتكلم، فتَفوتُ بالعطف، نحو: (لا يَغُرَّكَ الغِنى والبَطَرَ. ولا يعجِبْكَ الأكل والشبَعَ. ولا تهوَ رغَدَ العيشِ والذُّلَّ)، فإن المعنى المراد، كما ترى، ليسَ النهيَ عن الأمرينِ. وإنما هو الأول مجتمعاً مع الآخر. ومنه قول الشاعر: فَكونوا أَنتُمُ وبَنِي أَبيكمْ مَكانَ الكِلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحالِ (فليس مراده: كونوا أنتم وليكن بنو أبيكم، وإنما يريد: كونوا أنتم مع بني أبيكم. فالنصب على المعية فيما تقدم راجح قوي، لتعيينه المعنى المراد، وفي العطف ضعف من جهة المعنى). والمُحقّقُون يوجبون، في مثل ذلك النصبَ على المعيّة، ولا يُجوّزون العطف. وهو الحقُّ، لأنَّ العطفَ يفيدُ التشريكَ في الحكم. والتشريكُ هنا غير مقصود. ويرَجْحُ العطفُ متى أمكنَ بغيرِ ضعفٍ من جهة التركيب، ولا من جهة المعنى، نحو: (سار الأميرُ والجيشُ. وسرتُ أنا وخالدٌ. وما أنتَ وسعيدٌ؟)، قال تعالى: {يا آدمُ اسكن أنتَ وزوجُكَ الجنة}. ومتى ترجحَ العطفُ ضَعُفَ النصبُ على المعيّة، ومتى ترجحَ النصبُ على المعيّة ضعُفَ العطفُ. خلاصة وتحقيق (وخلاصة البحث: أن ما بعد الواو، تارة لا يصح تشريكه في حكم ما قبله، نحو: (سار علي والجبل) فيجب نصبه على المعية. وتارة يصح تشريكه فيمنع من العطف مانع، نحو: (جئت وسعيداً)، فيترجح نصبه على المعية. وتارة يجب تشريكه، نحو: (تصالح سعيد وخالد) فيجب العطف. وتارة يجوز تشريكه بلا مانع، نحو: (سافرت أنا وخليل)، فيختار فيه العطف على نصبه على المعية، وتارة لا يكون التشريك مقصوداً، وإنما يكون المقصود هو المعية، فيكون الكلام على نية الإعراض عن تشريك ما بعد الواو في حكم ما قبلها الى مجرّد معنى المصاحبة. فيرجح النصب على المعية على العطف، نحو: (لا تسافر أنت وخالدً)، إذا أردت نهيه عن السفر مع خالد، لا نهيه ونهيَ خالدٍ عن السفر. وقد ذكرنا آنفاً بضعة أمثلة على ذلك. فان قصدت إلى نهيهما كليهما عن السفر، ترجح العطف. نحو: (لا تسافر أنت وخالد). والنفس تواقة إلى إيجاب النصب على المعية فيما لم يُقصد به إلى التشريك في الحكم، والى إيجاب العطف فيما يُقصد به الى التشريك فيه، مراعاةً لجانب المعنى الذي يريده المتكلم. ونرى أن إجازتهم العطف في الصورة الأولى، والنصب على المعية في الصورة الثانية (على ضعف فيهما) إنما هي من حيث الصناعة اللفظية، بمعنى أنه لا يمنع من ذلك مانع من حيث القواعد النحوية. وأنت خبير بما في ذلك من التهويش على السامع والتلبيس عليه. فاحفظ هذا التحقيق واعمل به). |
3ـ العاملُ في الْمَفْعولِ مَعَهُ
يَنصبُ المفعولَ معهُ ما تقدَّمَ عليه من فعلٍ أو اسمٍ يُشبهُ الفعلَ. فالفعلُ نحو: (سرتُ والليلَ)، والاسمُ الذي يُشبهُهُ، نحو: (أنا ذاهبٌ وخالداً). "وحسبُكَ وسعيداً ما فعلتُما). وقد يكونُ العاملُ مقدّراً، وذلكَ بعدَ (ما وكيفَ) الاستفهاميّتينِ، نحو: (ما أنتَ وخالداً. وما لك وسعيداً. وكيفَ أنتَ والسفرَ غداً. والتقدير: (ما تكون وخالداً؟ وما حاصل لكَ وسعيداً؟ وكيف تكونُ والسفرَ غداً). واعلم أنه لا يجوزُ أن يتقدّمَ المفعولُ معهُ على عاملهِ، ولا على مُصاحبهِ، فلا يقال: (والجبلَ سارَ عليٌّ) ولا (سارَ والجبلَ عليٌّ). |
( الحال )
الحالُ: وصفٌ فضلةٌ يُذكرُ لبيانِ هيئَةِ الاسمِ الذي يكونُ الوصفُ له، نحو: (رجعَ الجندُ ظافراً. وأدَّبْ ولدَكَ صغيراً. ومررتُ بهند راكبةً. وهذا خالدٌ مُقبلاً). (ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقاً من الفعل، نحو: (طلعت الشمس صافية)، أو اسماً جامداً في معنى الوصف المشتق، نحو: (عدا خليل غزالاً) أي مسرعاً كالغزال. ومعنى كونه فضلة: أنه ليس مسنداً إليه. وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها كقوله تعالى: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين} وقوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}؛ وقول الشاعر: انما الميتُ من يعيشُ كئيباً كاسفاُ بالُهُ، قليلَ الرّجاء وقد تشتبه الحال بالتمييز في نحو: (لله ِ دَرّهُ فارساً أو عالماً أو خطيباً). فهذا ونحوه تمييزٌ لأنه لم يقصد به تمييز الهيئة. وإنما ذكر لبيان جنس المتعجب منه، والهيئة مفهومة ضمناً. ولو قلت: (لله دَرّهُ من فارس). لصحَّ. ولا يصحّ هذا في الحال. فلا يقال: (جاء خالد من راكب) وليس مثل ما تقدم هو التمييز حقيقة. وإنما هو صفته نابت عنه بعد حذفه. والأصل (لله درّهُ رجلاً فارساً). وربما اشتبهت الحال بالنعت. نحو: (مررت برجل راكب). فراكب: نعت. لأنه ذكر لتخصيص الرجل لا لبيان هيئته). واعلم أنّ الحالَ منصوبةٌ دائماً. وقد تُجرُّ لفظاً بالباءِ الزائدة بعد النفيِ، كقول الشاعر: فما رَجَعَتْ بِخائِبةٍ رِكابٌ حَكيمُ بنُ المُسَيَّبِ مُنْتَهاها وفي هذا الباب تسعةُ مَباحثَ: 1- الاسمُ الَّذي تَكون لَهُ الحالُ تجيء الحالُ من الفاعل، نحو: (رجعَ الغائبُ سالماً). ومن نائب الفاعل، نحو: (تُؤكلُ الفاكهةُ ناضجة). ومن الخبرِ، نحو: (هذا الهلالُ طالعاً). ومن المبتدأ (كما هو مذهبُ سيبويه ومن تابعهُ. وهو الحقُّ)، نحو: (أنتَ مجتهداً أخي) ونحو: (الماءُ صرفاً شرابي). ومن المفاعيل كلها على الأصحّ، لا من المفعول به وحدَهُ. فمجيئُها من المفعول به نحو: (لا تأكل الفاكهة فِجّةً) ومن المفعول المطلق نحو: (سرتُ سيري حثيثاً، فتعبتُ التعب شديداً)، ومن المفعول فيه نحو: (سريتُ الليلَ مظلماً. وصُمتُ الشهرَ كاملاً)، ومن المفعول لأجلهِ نحو: (افعلِ الخيرَ محبةَ الخيرِ مجرَّدةً عن الرياء)، ومن المفعولِ معهُ نحو: (سِرْ والجبلَ عن يمينك) ونحو: (لا تَسرِ والليلَ داجياً). ولا فرقَ بينَ أن يكون المفعولُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مجروراً بالحرف، نحو: (انهضْ بالكريمِ عاثراً) ونحو: (لا تَسرِ في الليل مُظلِماً) ونحو: (اسعَ للخير وحدَهُ). وقد تأتي الحالُ من المضاف إليه بشرط أن يكون في المعنى، أو في التقدير، فاعلاً أو مفعولاً، وذلك في صورتين. أ- أن يكونَ المضافُ مَصدراً أو وصفاً مضافين إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو مفعولِهما. فالمصدرُ المضافُ إلى فاعلهِ، نحو: (سَرّني قدومكَ سالماً)، ومنه قولهُ تعالى: {إليه مرجعُكُم جميعاً}، وقولُ الشاعر: تقُولُ ابْنَتي: إنَّ انْطلاقَكَ واحداً، إلى الروْعِ يَوْماً، تاركي لا أَبالِيَا والوصفُ المضافُ إلى فاعله نحو: (أنتَ حسَنُ الفرَسِ مُسرَجاً). والوصفُ المضافُ إلى نائب فاعله نحو: (خالدٌ مغمَض العينِ دامعةً). والمصدرُ المضافُ إلى مفعولهِ، نحو: (يعجبُني تأديبُ الغلام مُذنِباً، وتهذيبُهُ صغيراً). والوصفُ المضافُ إلى مفعولهِ نحو: (أنتَ ورادُ العيشِ صافياً، ومسهَلُ الأمرِ صعباً)، ونحو: (خالدٌ ساري الليلِ مظلماً). وبذلك تكونُ الحالُ قد جاءَت من الفاعل أو نائبه أو من المفعولِ، كما هو شرطها. ب- أن يَصِحَّ إقامةُ المضافِ إليه مقامَ المضاف، بحيثُ لو حذف المضافُ لاستقامَ المعنى. وذلكَ بأن يكونَ المضافُ جُزْءاً من المضاف إليه حقيقةً، كقولهِ تعالى: {أيُحب أحدُكم أن يأكل لحمَ أخيه مَيتاً فكَرِهتُموهُ}، وقوله: {ونَزَعنا ما في صُدورهم من غِلٍّ إخواناً}، ونحو: (أمسكتُ بيدِكَ عاثراً). أو يكونَ كجزءٍ منه، نحو: (تَسرُّني طِباعُ خالدٍ راضياً، وتسوءُني أخلاقُهُ غضبان). ومنه قوله تعالى: {أنِ اتَّبِعْ ملّةَ إبراهيمَ حنيفاً}. (وبذلك تكون الحال أيضا قد جاءت من الفاعل أو المفعول تقديراً، لأنه يصح الاستغناء عن المضاف. فإذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعلية أو انتصب على المفعولية. وإذا علمت ذلك عرفت أنه لا يصحُّ أن يقال: (مررت بغلام سعاد جالسة)، لعدم صحة الاستغناء عن المضاف؛ لأنه ليس جزءاً من المضاف إليه، ولا كالجزء منه. فلو أسقطت الغلام، فقلت: "مررت بهند جالسة" لم يستقم المعنى المقصود، لأن القصد هو المرور بغلامها لا بها). 2- شروطُ الحال يشترطُ في الحال أربعةُ شروطٍ: أ ـ أن تكونَ صفةً مُنتقلةً، لا ثابتةً (وهو الأصلُ فيها)، نحو: (طلعت الشمسُ صافيةً). وقد تكونُ صفةً ثابتةً، نحو: هذا أَبوكَ رحيماً {يومَ أُبعثُ حيّاً}. {خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً}. خَلَقَ اللهُ الزَّرافةَ يَدَيها أطولَ من رِجلَيها. {أَنزلَ إليكم الكتابَ مفصّلاً}". وقال الشاعر: فَجَاءَتْ بهِ سَبْطَ العِظامِ، كأَنما عِمامتُهُ بَيْنَ الرِّجالِ لِواءُ [ سبط العظام: مستوي القِوام. وأصل ذلك في الشعر، يقال: شعر سبط أي ليس بجعد. ومنه يقال: فلان سبط الكف وسبط البنان أي كريم، وفلان جعد الكف أي بخيل. ويصف الشاعر ابنا له حسن القد وطول القامة واعتدالها] ب- أن تكونَ نكرةً، لا معرفةً. وقد تكون معرفةً إذا صحَّ تأويلُها بنكرةٍ، نحو: (آمنتُ بالله وحدهُ). أَي: منفرداً، ونحو: (رجعَ المسافرُ عودَهُ على بَدئهِ"، أي: عائداً في طريقه، والمعنى أنه رجعَ في الحال. ونحو: (أُدخلُوا الأولَ فالأولَ) أي مترَتِّبينَ. ونحو: (جاءُوا الجَمّاءَ الغَفيرَ)، أي جميعاً. ونحو: (افعل هذا جُهدَكَ وطاقتكَ) أي: جاهداً جادًّا. ونحو: (جاءَ القومُ قَضَّهُم، بقَضيضهم)، أي جاءُوا جميعاً أو قاطبةً. ج- أن تكونَ نَفْسَ صاحبِها في المعنى، نحو: (جاءَ سعيدُ راكباً). (فان الراكب هو نفس سعيد. ولا يجوز أن يقال: (جاء سعيد ركوباً). لأن الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه). د- أن تكون مشتقّةً، لا جامدةً. وقد تكون جامدةً مُؤَوَّلةً بوصفٍ مشتقٍّ، وذلك في ثلاث حالات: الأولى: أن تدُلَّ على تشبيهٍ، نحو: (كرَّ عليٌّ أسداً)، أي: شُجاعاً كالأسد، ونحو: (وضَحَ الحقُّ شمساً)، أي: مضيئاً، أو منيراً كالشَّمس. ومنه قولهم: (وقعَ المصطَرعانِ عِدْليْ عَيرٍ). أي مصطَحِبَينِ كاصطحابِ عدليْ حمارٍ حينَ سقوطهما. [عدلي عير: العِدل: كيس من الصوف يتسع الاثنان منه نحو ربع طن، كانت تربط على الجمل أو حمار النقل والبغل القوي، والعير هنا الحمار، وتقال للحمار الأهلي أو الوحشي] |
الثانيةُ: أن تَدُلُّ على مُفاعلةٍ، نحو: (بِعتُكَ الفرَسَ يداً بيدٍ)، أي: متقابضينِ، ونحو: (كلّمتُه فاهُ إلى فيَّ)، أي: مُتشافهينِ.
الثالثةُ: أن تدلَّ على ترتيبٍ، نحو: (دخلَ القومُ رجلاً رجلاً"، أي: مُترَتّبينَ، ونحو: (قرأتُ الكتابَ باباً باباً)، أي: مُرَتّباً. وقد تكونُ جامدةً، غيرَ مُؤوَّلةٍ بوصفٍ مُشتق، وذلك في سبع حالاتٍ: الأولى: أن تكونَ موصوفةً، كقوله تعالى: {إنّا أنزلناه قرآنا عربياً} وقولهِ: {فتَمثَّلَ لها بَشراً سَوياً}. الثانيةُ: أن تدلَّ على تسعيرٍ، نحو: (بعتُ القمحَ مُدًّا بِعشرةِ قُروشٍ. واشتريتُ الثوبَ ذِراعاً بدينارِ). الثالثةُ: أن تدُلَّ على عددٍ، كقوله تعالى: {فَتَمَّ مِيقاتُ رَبكَ أربعينَ ليلةً}. الرابعةُ: أن تَدُلَّ على طَورٍ، أي حالٍ، واقعٍ فيه تفضيلٌ، نحو: (خالدٌ غلاماً أحسنُ منهُ رجلاً) ونحو: (العِنَب زبيباً أطيبُ منه دِبساً). الخامسةُ: أن تكون نوعاً لصاحبها، نحو: (هذا مالُكَ ذهباً). السادسةُ: أن تكونَ فرعاً لصاحبها، نحو: (هذا ذَهبُكَ خاتماً)، ومنه قولهُ تعالى: {وتنحِتونَ الجبالَ بُيوتاً}. السابعةُ: أن تكون أصلاً لصاحبها، نحو: (هذا خاتُمكَ ذَهباً. وهذا ثوبُك كتّاناً)، ومنه قوله تعالى: {أأسجُدُ لِمن خَلقتَ طيناً؟}. |
3- عاملُ الحالِ وصاحبُها تحتاج الحالُ إلى عاملٍ وصاحبٍ. فعاملُها: ما تَقدَّم عليها من فعلٍ، أو شبههِ، أو مَعناهُ. فالفعلُ، نحو: (طلعت الشمسُ صافيةً). والمرادُ بشبهِ الفعلِ: الصفاتُ المشتقةُ من الفعلِ، نحو: (ما مسافرٌ خليلٌ ماشياً). والمراد بمعنى الفعل تسعةُ أشياء: أ- اسمُ الفعلِ، نحو: (صَهْ ساكتاً. ونَزَالِ مُسرعاً). ب- اسمُ الإشارةِ، نحو: (هذا خالدٌ مُقبلاً)، ومنه قولهُ تعالى: {وهذا بَعلي شيخاً}، وقولهُ: {فَتلكَ بُيوتُهُم خاويةً بما ظلموا}، وقولهُ: {إنَّ هذه أُمَّتُكم أُمَّةً واحدةً}. ج- أدواتُ التّشبيهِ، نحو: (كأنَّ خالداً، مقبلاً، أسدٌ)، قال الشاعر: كأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ، رَطْباً ويَابساً لَدَى وَكْرِها، العُنَّابُ والحَشَف البالي د ـ أدوات التمني والترجي، نحو (ليت السرورَ دائماً عندنا) و (لعلك مدعياً على حق) هـ- أدوات الاستفهام، نحو: (ما شأنُكَ واقفاً؟. ما لَكَ مُنطلقاً؟. كيفَ أنتَ قائماً؟. كيفَ بزُهيرٍ رئيساً؟). ومن ذلك قولُه تعالى: {فما لهم عن التّذكرةِ مُعرِضينَ؟}). و- حرفُ التنبيهِ، نحو: (ها هُوَ ذا البدرُ طالعاً). ز- الجارُّ والمجرورُ، نحو: (الفرَسُ لكَ وحدَك). ح- الظرفُ، نحو: (لَدَينا الحقُّ خَفّاقاً لواؤُهُ). ط- حرفُ النداء، كقوله: (يا أيُّها الرَّبعُ مبكيّاً بساحتهِ). وصاحبُ الحالِ: ما كانت الحالُ وصفاً له في المعنى. فإذا قلتَ: (رجعَ الجندُ ظافراً)، فصاحبُ الحال هو (الجُندُ) وعاملُها هو (رجعَ). والأصلُ في صاحبها أن يكون معرفةً، كما رأيتَ. وقد يكونُ نكرةً، بأحدِ أربعةِ شروطٍ: أ- أن يتأخرَ عنها، نحو: (جاءني مُسرعاً مُستنجدٌ فأنجدتهُ)، ومنه قولُ الشاعر: (لِمَيّةً مُوحِشاً طَلَلُ). ب- أن يسبقه نفيٌ أو نهيٌ أو استفهامٌ فالأولُ نحو: (ما في المدرسة من تلميذٍ كسولاً). و(ما جاءني أحدٌ إلاّ راكباً)، ومنه قولهُ تعالى: {وما أهلكنا من قريةٍ إلا لها مُنذِرُونَ}. والثاني نحو: (لا يَبغِ امروءٌ على امرئ مُستسهِلاً بَغيَهُ، ومنه قولُ الشاعر: لاَ يَرْكَنَنْ أَحدٌ إِلى الإِحجامِ يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً لِحمامِ [الإحجام: التأخر، والحِمام: الموت] والثالثُ، نحو: (أَجاءكَ أحدٌ راكباً) ج- أن يتَخصَّصَ بوصفٍ أو إضافةٍ، فالأولُ نحو: (جاءني صديقٌ حميمٌ طالباً مَعونتي)، ومنهُ قوله تعالى: {فيها يُفرَقُ كلُّ أمر حكيمٍ، أمراً من عندِنا}، وقول الشاعر: يا رَبِّ نَجَّيْتَ نُوحاً واستجَبْتَ لَهُ في فُلُكٍ ماخِرٍ في الْيَمِّ مَشْحُونَا والثاني، نحو: (مَرَّت علينا ستةُ أيامٍ شديدةً)، ومنه قولهُ تعالى: {في أربعة أيام سَواءً للسائلين}. د- أن تكون الحالُ بعدَهُ جملةً مقرونةً بالواو، كقوله تعالى: {أو كالذي مَرَّ على قريةٍ، وهيَ خاويةٌ على عُرُوشها}. وقد يكونُ صاحبُ الحالِ نكرةً بلا مُسَوِّغٍ، وهو قليلٌ، كقولهم: (عليه مِئَةٌ بيضاً)، وفي الحديث: (صلَّى رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّم، قاعداً وصلَّى وراءهُ رجالٌ قِياماً). |
4- تَقَدُّمُ الحالِ على صاحِبها وتَأَخُّرُها عنه
الأصلُ في الحالِ أن تتأخرَ عن صاحبها. وقد تتقدَّمُ عليه جوازاً، نحو: (جاء راكباً سعيدٌ)، ومنه قول الشاعر: فَسَقَى دِيارَكِ، غَيْرَ مُفْسِدِها، صَوْبٌ الرَّبيعِ و ديمة تَهْمِي وقد تتقدَّمُ عليه وُجوباً. وقد تَتأخرُ عنهُ وجوباً. فتتقدّمُ عليه وُجوباً في موضعينِ: أ- أن يكونَ صاحبُها نكرةً غير مستوفيةٍ للشُّروطِ، نحو: (لخليلٍ مُهذَّباً غلامٌ)، ومنه قولُ الشاعر: وهَلاَّ أَعَدُّوني لِمثْلي، تَفَاقَدُوا وَفي الأَرْضِ مَبْثُوثاً شُجاعٌ وعَقْرَبُ [أي: هلاّ جعلوني عُدة لرجل مثلي. (تفاقدوا: دعا عليهم بأن يفقدوا بعضهم بعضا. و(الشجّاع) الخبيث من الحيّات. وأراد بالشجاع والعقرب من يشبههما طباعا من الناس] ب- أن يكونَ محصوراً، نحو: (ما جاء ناجحاً إلا خالدٌ وإنما جاء ناجحاً خالدٌ). تقولُ ذلك إذا أردتَ أن تَحصُرَ المجيء بحالة النجاح في خالد. [أي: محصوراً في الحال] وتتأخرُ عنه وجوباً في ثلاثة مواضع: أ- أن تكونَ هي المحصورة، نحو: (ما جاء خالدٌ إلا ناجحاً. وإنما جاء خالدٌ ناجحاً). تقول ذلك إذا أردت أن تحصُرَ مجيء خالدٍ في حالة النجاح. ومنه قولهُ تعالى: {وما نُرسِلُ المُرسلين إلا مبشّرينَ ومنذِرينَ}. [محصوراً في صاحبها] ب- أن يكون صاحبُها مجروراً بالإضافة، نحو: (يُعجبُني وُقوفُ عليٍّ خطيباً. وسرَّني عملُك مخلصاً). أما المجرور بحرف جرٍّ أصلي، فقد منعَ الجمهورُ تقدُّمَ الحال عليه. فلا يقالُ: (مررتُ راكبةً بسعادَ وأخذتُ عاثراً بيدِ خليلٍ). بل يجب تأخيرُ الحال. وأجاز تقدُّمَهُ ابنُ مالك وغيرهُ. وجعلوا منه قوله تعالى: {وما أرسلناكَ إلا كافَّةً للناس}. [ فكافة على قولهم، حال من الناس مقدمة، فهي بمعنى (جميعاً). وقال المانعون: إن كافةً وصف من الكف بمعنى المنع، لحقته التاء التي تلحق الصفات للمبالغة لا للتأنيث، كرجلٍ نابغة وداهية. وجعلوا حالاً من الكاف في أرسلناك. وقولهم هذا أقرب الى الحق. وقد جعل الزمخشري (كافة) صفة لمصدر محذوف أي (أرسلناك إرسالة كافة للناس) ] وجعلَ بعضُهم جوازَ تَقدُّمها عليه مخصوصاً بالشعر، كقول الشاعر: إذا الْمَرءُ أَعيَتْهُ المُرُوءَةُ ناشئاً فَمَطْلَبُها كَهْلاً عَلَيْهِ عَسِيرُ أمّا المجرور بحرفِ جرٍّ زائد، فلا خلافَ في جواز تقدُّمِ الحالِ عليه، لأن حرفَ الجرِّ الزائد كالسّاقطِ فلا يُعتدُّ به، نحو: (ما جاء راكباً من أحدٍ. وكفى صديقاً بِكَ). ج- أن تكون الحالُ جملةً مقترنةً بالواو، نحو: (جاء عليٌّ والشمسُ طالعة). فإن كانت غيرَ مُقترنة بها جاز تأخيرُها وتقديمها، فالأولُ نحو: (جاء خليلٌ يَحمِلُ كتابهُ)، والثاني نحو: (جاء يحملُ كتابَهُ خليلٌ). وأجاز قومٌ تقديمَها وهي مُصَدَّرةٌ بالواو. والأصح ما ذكرناه. |
5- تقَدُّمُ الحالِ على عاملِها وتأَخُّرُها عَنه
الأصلُ في الحال أن تَتأخرَ عن عاملها. وقد تتقدَّم عليه جوازاً، بشرطِ أن يكون فعلاً مُتَصرفاً، نحو: (راكباً جاء علي) أو صفة تُشبهُ الفعلُ المتصرفَ - كاسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والصفة المشبهَةِ - نحو: (مُسرعاً خالدٌ مُنطلقٌ). ومن الفعل المتصرف قوله تعالى: {خُشّعاً أبصارُهم يَخرُجونَ}، وقولهم: (شتّى تؤوبُ الحَلَبةُ)، أي مُتَفرِّقين يرجعون. [شتى: جمع شتيت بمعنى متفرق. وتؤوب: ترجع. والحلبة: جمع حالب] (فان كان العامل في الحال فعلا جامداً، أو صفة تشبهه - وهي اسم التفضيل - أو معنى الفعل دون أحرفه، فلا يجوز تقديم الحال عليه، فالأول نحو: (ما أجملَ البدرَ طالعاً!). والثاني: (عليّ أفصح الناس خطيباً). والثالث نحو: (كأنّ علياً مُقدماً أسدٌ)، فلا يقال: (طالعاً ما أجمل البدر. ولا علي خطيباً أفصحُ الناس. ولا مقدماً كأن علياً أسدٌ) ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو، قولك: (سعيد خطيباً أفصح منه كاتباً. وإبراهيم كاتباً أفصح من خليل شاعراً) ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال، كما ستعلم. واعلم أن اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد، من حيث أنه لا يتصرف بالتثنية والجمع والتأنيث، كما تنصرف الصفات المشتقة، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فهو لا يتصرف تصرّفها إلا في بعض الأحوال، وذلك إن اقترن بأل أو أضيف الى معرفة، فيصرف حينئذ إفرادا وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. كما عرفت في الجزء الأول من هذا الكتاب). متى تتقدم الحال على عاملها وجوباً؟ تتقدمُ الحالُ على عاملها وجوباً في ثلاثِ صُوَرٍ: أ- أن يكون لها صدرُ الكلامِ، نحو: "كيفَ رجعَ سليمٌ؟"، فإن أسماء الاستفهامِ لها صدرُ جملتها. [كيف: اسم استفهام مبني على الفتح، وهو في محل نصب على الحال من سليم، أي: على أية حالٍ جاء؟] ب ـأن يكون العاملُ فيها اسمَ تفضيلٍ، عاملاً في حالين، فُضّلَ صاحبُ إحداهما على صاحبِ الأخرى، نحو: (خالدٌ فقيراً، أكرمُ من خليلٍ غنيّاً)، أو كان صاحبُها واحداً في المعنى، مُفضّلاً على نفسه في حالةٍ دونَ أُخرى، نحو: (سعيدٌ، ساكتاً، خيرٌ منه متكلماً). فيجبُ والحالةُ هذهِ، تقديمُ الحال التي للمُفضّل، بحيثُ يتوسطُ اسمُ التفضيلِ بينهما، كما رأَيتَ. ج- أن يكون العاملُ فيها معنى التّشبيه، دونَ أحرُفهِ، عاملاً في حالينِ يرادُ بهما تشبيهُ صاحبِ الأولى بصاحبِ الأخرى، نحو: (أنا، فقيراً، كخليلٍ غنيّاً، ومنه قولُ الشاعر: تُعَيّرُنا أنَّنا عالةٌ ونحنُ، صَعاليكَ، أَنُتمْ مُلوكا [أي: ( نحن في صعلكتنا مثلكم، في حال ملككم)] أو تشبيهُ صاحبهما الواحد في حالةٍ، بنفسه في حالةٍ أُخرى، نحو: (خالدٌ، سعيداً، مِثلُهُ بائساً). فيجبُ، إذ ذاك، تقديمُ الحالِ التي للمُشبّهِ على الحالِ التي للمُشبّهِ به، كما رأيت. إلا إن كانت أداةٌ التّشبيه (كأنَّ)، فلا يجوزُ تقديمُ الحال عليها مُطلقاً، نحو: (كأنَّ خالداً، مُهرولاً، سعيدٌ بَطيئاً). (فإن كان التشبيه العامل في الحالين، فعلاً أو صفة مشتقة منه، جاز تقديم حال المفضل عليه وتأخيرها عنه، فالأول نحو: (خالد ماشياً يشبه سعيداً راكباً). والثاني نحو: (يشبه خالد ماشياً سعيداً راكباً)). متى تتأخر الحال عن عاملها وجوبا؟ تتأخرُ الحال عن عاملها وجوباً في أحدَ عشرَ موضعاً: 1- أن يكونَ العاملُ فيها فعلاً جامداً، نحو: (نِعْمَ المهذارُ ساكتاً. ما أحسنَ الحكيمَ متكلِّماً. بئس المرءُ منافقاً. أحسِنْ بالرَّجلِ صادقاً). 2- أن يكونَ اسمَ فعلٍ، نحو: (نَزالِ مسرعاً). 3- أن يكونَ مصدراً يَصِحُّ تقديرُهُ بالفعلِ والحرفِ المصدري، نحو: (سرَّني أو يَسرُّني، اغترابُك طالباً للعلم). (إذ يصح أن تقول: (يسرني أن تغترب طالباً للعلم). فإن كان يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري. نحو: (سمعاً كلامَ اللهِ متلوّاً)، جاز تقديمه عليه نحو: (متلوّاً سمعا كلام الله). 4- أن يكون صِلةً لألْ، نحو: (خالدٌ هو العاملُ مجتهداً). 5- أن يكون صِلةً لحرفٍ مصدريٍّ، نحو: "يَسُّرني أن تعملَ مجتهداً. سَرَّني أن عملتُ مُخلِصاً، يَسرُّني ما تجتهدُ دائباً. سرَّني ما سَعَيتَ صابراً). 6- أن يكونَ مقروناً بلامِ الابتداءِ، نحو: (لأَصبِرُ مُعتمِلاً). 7- أن يكونَ مقروناً بلامِ القسم، نحو: ( لأثابرنّ مجتهداً) 8ـ أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون أحرفه، نحو (هذا عليٌّ مقبلاً . ليت سعيداً، غنيّاً، كريمٌ. كأنَّ خالداً، فقيراً، غنيٌّ). 9- أن يكون اسمَ تفضيلٍ، نحو: (عليٌّ أفصحُ القومِ خطيباً)، إلا إذا كان عاملاً في حالين، نحو: (العصفورُ، مغَرداً خيرٌ منه ساكتاً)، فيجبُ تقديمُ حال المفضّل على عامله، كما تقدَّم. 10- أن تكونَ الحالُ مؤكدةً لعاملها، نحو: (ولّى العدوُّ مدبِراً، فتَبسّم الصديقُ ضاحكاً). 11- أن تكون جملةً مقترنة بالواو، على الأصحِّ، نحو: (جئتُ والشمسُ طالعةٌ). (فان كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها، نحو: (يركب فرسه جاء خالد) وأجاز قوم تقديمها على عاملها وهي مصدرة بالواو، فأجازوا أن يقال: (والشمس طالعة جئت) والأصح ما قدّمناه. وقد سبق أنه لا يجوز تقديم الجملة المصدرة بالواو على صاحبها أيضاً؛ وان قوماً أجازوه). |
6- حَذْفُ الحالِ وحَذْفُ صاحِبها
الأصلُ في الحال أنه يجوز ذكرها وحذفُها، لانها فضلةٌ. وإن حذفت فإنما تُحذَفُ لقرينة. وأكثرُ ذلك إذا كانت الحالُ قولاً أغنى عنه ذكرُ القَول، كقولهِ تعالى: {والملائكةُ يَدخلونَ عليهم من كل باب سلامٌ عليكم}، أي: (يدخلون قائلين: سلامٌ عليكم)، وقوله: {وإذْ يَرفعُ إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ وإسماعيلُ ربّنا تَقبّلْ منا}، أي: (يَرفعانِ القواعدَ قائلَينِ: ربّنا تقبّلْ منّا). وقد يُحذَفُ صاحبُها لقرينةٍ، كقولهِ تعالى: {أهذا الذي بَعثَ الله رسولاً}، أَي: (بعثهُ). وقد يَعرِضُ للحال ما يمَنعُ حذفَها، وذلك في أربعِ صورٍ: أ- أن تكونَ جواباً، كقولك: (ماشياً) في جواب من قال (كيف جئتَ؟). ب- أن تكونَ سادًةَ مسَدَّ خبرِ المبتدأ، نحو: (أَفضلُ صدَقةِ الرجلِ مُستتراً). ج- أن تكونَ بَدلاً من التلفُّظِ بفعلها، نحو: (هنيئاً لكَ). د- أن يكونَ الكلامُ مَبنيّاً عليها - بحيثُ يَفسُدُ بحذفها - كقوله تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تقربُوا الصلاةَ، وأنتم سكارى، حتى تَعلموا ما تقولون}، وقولهِ: {ولا تَمشِ في الأرضِ مَرَحاً} ومن هذا أن تكون محصورةً في صاحبها، أَو محصوراً فيها صاحبُها، فالأولُ نحو: (ما جاءَ راكباً إلاّ علي)، والآخرُ نحو: (ما جاءَ عليٌّ إلاَّ راكباً). 7- حذفُ عاملِ الحالِ يحذَفُ العاملُ في الحال. وذلك على قسمين: جائز وواجب. فالجائزُ كقولك لقاصد السفر: (راشداً)، وللقادم من الحجِّ: (مأجوراً)، ولِمن يحدِّثُكَ: (صادقاً)، ونحو: (راكباً) لمن قال لكَ: (كيف جئتَ؟)، وبَلى مسرعاً) في جواب من قال لكَ: (إنَّكَ لم تَنطلق). ومن ذلك قولهُ تعالى: {أيَحسَبُ الإنسانُ أَن لن نجمعَ عِظامَهُ؟ بَلى، قادرينَ على أن نُسوِّي بنَانَهُ}، وقولُهُ: {حافظوا على الصّلواتِ والصلاة الوسطى}، إلى قوله: {فإن خِفتم فَرِجالاً أَو ركباناً}. [للمسافر: الاستعاضة عن تسافر راشداً، وللحاج (رجعت مأجوراً، وللمتحدث: تقول صادقاً، وبلى نجمعها قادرين، وصلوا رجالاً أو ركباناً والرجال هنا جمع راجل أي من يمشي على رجليه، وركبان جمع راكب] والواجبُ في خمس صوَر: أ ـ أن يُبيّن بالحالِ ازديادٌ أَو نقصٌ بتدريجٍ، نحو: (تَصدَّق بدرهمٍ فصاعداً، أَو فأكثرَ)، ونحو: (اشترِ الثّوبَ بدينار فنازلاً، أو فأقلَّ، أَو فسَافِلاً). وشرطُ هذهِ الحالِ أَن تكون مصحوبة بالفاءِ، كما رأيت، أَو بِثمّ. والفاءُ أكثرُ. ب- أن تُذكرَ للتّوبيخِ، نحو: (أقاعداً عن العمل، وقد قام الناسَ؟)، ونحو: (أَمتوَانياً، وقد جَدَّ قُرَناؤكَ؟). ومنه قولهم: (أَتَميميّاً مرةً، وقَيسيّاً أُخرَى؟). ج- أَن تكون مُؤكدةً لمضمونِ الجملةِ، نحو: (أنت أَخي مواسياً). د- أن تسُدّ مسَدّ خبر المبتدأ، نحو: (تأديبي الغلامَ مُسيئاً). هـ- أَن يكون حذفُهُ (أَي حذفُ العامل) سَماعاً، نحو: (هنيئاً لك). |
8- أَقسامُ الحال
تنقسم الحال - باعتبارات مختلفة - الى مؤسسة ومؤكدة؛ والى مقصودة لذاتها وموطئة، والى حقيقية وسببية، والى مفردة وشبه جملة. فالمجموع تسعة أنواع، وسيأتيك بيانها: الحال المؤسسة، والحال المؤكدة الحالُ، إمّا مؤسسةٌ، وإمَّا مؤكدةٌ: فالمؤسسةُ (وتُسمّى المبنيّة أَيضاً، لأنها تُذكرُ للتّبيين والتّوضيح): هي التي لا يُستفادُ معناها بدونها، نحو: (جاءَ خالدٌ راكباً). وأَكثر ما تأتي الحالُ من هذا النوع، ومنه قولهُ تعالى: {وما نُرسِلُ المرسَلين إلا مبَشّرينَ ومُنذِرينَ}. والمؤكدةُ: هيَ التي يُستفادُ معناها بدونها، وإنما يُؤتى بها للتوكيد. وهي ثلاثةُ أَنواع: أ- ما يؤتى بها لتوكيدِ عاملها، وهي التي تُوافقه معنًى فقط، أو معنى ولفظاً. فالأول نحو: (تَبسّم ضاحكاً)، ومنهُ قولهُ تعالى: {ولا تَعثوا في الأرضِ مُفسدِين}، وقولهُ: {ثمَّ توَليتم مدبِرين}، والثاني كقوله تعالى: {وأَرسلناكَ للناس رسولاً}. 2- ما يؤتى بها لتوكيدِ صاحبِها، نحو: (جاءَ التلاميذُ كلُّهم جميعاً). قال تعالى: {ولو شاءَ ربُّكَ لآمنَ مَن في الأرض كلُّهم جَميعاً، أفأنتَ تُكرِهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمِنينَ؟}. 3- ما يؤتى بها لتوكيدِ مضمون جملة معقودة من اسمينِ معرفتينِ جامدينِ، نحو: "هو الحقُّ بيّناً، أو صريحاً"، ونحو: "نحنُ الأخوةُ مُتعاونينَ"، ومنهُ قولُ الشاعر: أَنَا ابنُ دَارَةَ، مَعْروفاً بها نَسَبي. وَهَلْ بِدارَةَ، يا للنَّاسِ مِنْ عارٍ [دارة: اسم أمه] الحال المقصودة لذاتها، والحال الموطئة الحالُ، إمَّا مقصودة لذاتها (وهو الغالبُ) نحو: (سافرتُ منفرداً)، وإمَّا مُوطِّئة، وهيَ الجامدةُ الموصوفةَ، فتُذكرُ تَوطئةً لما بعدها، كقوله تعالى: {فتَمثّلَ لها بَشراً سويّاً}، ونحو: (لَقيتُ خالداً رجلاً مُحسناً). الحال الحقيقية، والحال السببية الحالُ، إمَّا حقيقيةٌ، وهي التي تُبيّنُ هيئَةَ صاحبها (وهو الغالبُ) نحو: (جئتُ فَرِحاً)، وإمَّا سَببيّة، وهي ما تُبيّنُ هيئةَ ما يَحملُ ضميراً يعودُ إلى صاحبها، نحو: (ركِبتُ الفرسَ غائباً صاحبُهُ)، ونحو: (كلّمتُ هنداً حاضراً أبوها). الحال الجملة الحالُ الجملة. هو أَن تقعَ الجملةُ الفعليةُ، أو الجملةُ الاسميّة، مَوقعَ الحال، وحينئذٍ تكونُ مؤَوَّلة بمفرد، نحو: (جاء سعيدٌ يركُضُ) ونحو: (ذهبَ خالِدٌ دَمعُهُ مُتحدَّرٌ). والتأويلُ: (جاء راكضاً. وذهبُ مُتحدِّراً دَمعُهُ). ويُشترطُ في الجملة الحاليّة ثلاثةُ شروطٍ: أ- أن تكون جملةً خبريّةً، لا طلبيةً ولا تَعَجُّبيّة. ب- أن تكون غيرَ مُصدّرةٍ بعلامةِ استقبالٍ. ج- أن تَشتملَ على رابط يربطُها بصاحب الحال. والرابطُ إمّا الضميرُ وحدَهُ، كقوله تعالى: {وجاءُوا أَباهم عِشاءً يبكونَ}. وإمّا الواوُ فقط، كقوله سبحانهُ: {لَئِنْ أكلَهُ الذئبُ ونحنُ عصبةٌ} وإمّا الواو والضميرُ معاً، كقوله تعالى: {خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ}. الحال شبه الجملة الحالُ شِبهُ الجملة: هو أَن يقعَ الظرف أو الجارُّ والمجرورُ في موقعِ الحال. وهما يتعلقانِ بمحذوفٍ وجوباً تقديرُهُ (مستقرًّا) أو (استقرَّ). والمُتعلّقُ المحذوفُ، في الحقيقة هو الحال، نحو: (رأيتُ الهلالَ بينَ السحابِ)، ونحو: (نظرتُ العُصفورَ على الغصنِ). ومنه قوله تعالى: {فخرجَ على قومهِ في زينتهِ}. فائدة جليلة إذا ذكرَ معَ المبتدأ اسمٌ وظرفٌ أَو مجرورٌ بحرف جرّ، وكلاهما صالحان للخبريَّة والحاليّة، فإن تَصدَّرَ الظرفُ أَو المجرورُ، فالمُختارُ نصبُ الاسم على الحاليّة وجعلُ الظرفِ أو المجرور خبراً مقدّماً، نحو (عندك، أَو في الدار، سعيدٌ نائماً)، ونحو: (عندَك، أو في الدار، نائماً سعيدٌ)، لأنه بتقديمه يكون قد تَهيّأ للخبرية، ففي صرفه عنها إجحافٌ. ويجوز العكس. وإن تَصدّرَها الاسمُ، وجب رفعُهُ وجعلُ الظرفِ أو المجرور حالاً، نحو: (نائمٌ عندَكَ، أو في الدار، سعيدٌ)، ونحو: (نائمٌ سعيدٌ عندَكَ، أو في الدار). وإن تَصدَّرَها المبتدأ، فإن تقدَّمَ الظرفُ أو المجرور على الاسم، جاز جعلُ كلٍّ منهما حالاً والآخر خبراً، نحو: "سعيدٌ عندَكَ، أو في داره (نائماً)، أو تقولُ: (نائمٌ). وإن تَقدَّمَ الاسم على الظرف أو المجرور، فالمختارُ رفعُ الاسم، وجعلُ الظرفِ أو المجرور حالاً، نحو: (سعيدٌ نائمٌ عندَك، أو في داره)، ويجوز العكسُ (وهو قليل في كلامهم)، فتقولُ: (سعيدٌ نائماً عندَكَ، أو في داره). ومنعَ الجمهورُ نصبَ الاسم، في هذه الصورة. وأجازَهُ ابن مالك مُستنداً إلى قراءَة الحسن البصريّ. {والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يوم القيامة. والسمواتُ، مَطوياتٍ، بِيَمينهِ} بنصبِ (مطوياتٍ) على الحال، وجعلِ (بيمينهِ) خبراً عن (السّموات)، وإلى قراءة من قرأَ، وقالوا: {ما في بُطُونِ هذه الأنعامِ، خالصةً لذكورنا}، بنصب (خالصةً) على الحال، وجعلِ (لذكورنا) خبراً عن (ما الموصوليّة). والقراءتان شاذّتانِ. لكن فيهما دليلاً على الجواز. لأنه ليس معنى شذوذِ القراءة أنها غيرُ صالحةٍ للاحتجاج بها عَربيّةً. فإن لم يَصلُحِ الظرفُ أو المجرورُ بالحرف للخبريّة (بحيثُ لا يكون مستغنًى عن الاسم، لأنه لا يَحسُنُ السكوتُ عليه) تَعَيّنتْ خبريةُ الاسم وحاليّةُ الظرف أو المجرور، نحو: (فيكَ إبراهيمُ راغبٌ)، ونحو: (إبراهيمُ فيكَ راغبٌ). إذ لا يصحُّ أن تَستغنيَ هنا عن الاسم، فتقولُ: (إبراهيم فيك). الحال المفردة الحالُ المُفرَدةُ: ما ليست جملةً ولا شِبهَها، نحو: (قرأتُ الدرسَ مجتهداً. وكتَباهُ مُجتهدَينِ. وتَعلمناهُ مجتهدِينَ). |
9- واوُ الحالِ وأَحكامُها
واوُ الحالِ: ما يصحُّ وقوعُ (إذ) الظرفيّةِ موقعَها، فإذا قلتَ: (جئتُ والشمسُ تغيبُ)، صحَّ أن تقول: (جئتُ إذِ الشمسُ تغيب). ولا تدخلُ إلاّ على الجملة، كما رأَيتَ، فلا تدخلُ على حال مُفرَدة، ولا على حالٍ شبهِ جملةٍ. وأصلُ الرَّبطِ أن يكونَ بضمير صاحب الحال. وحيثُ لا ضميرَ وجبتِ الواو، لأنّ الجملةَ الحاليّةَ لا تخلو من أحدهما أو منهما معاً. فإن كانت الواو معَ الضمير كان الرَّبطُ أشدَّ وأحكم. وواوُ الحالِ، من حيثُ اقترانُ الجملة الحاليّة بها وعَدمُهُ، على ثلاثة أضرُبٍ: واجبٍ وجائزٍ ومُمتنع. متى تجب واو الحال؟ تجبُ واو الحال في ثلاثِ صُوَرٍ: أ- الأولى أن تكونَ جملةُ الحالِ إسميَّةً مجرَّدةً من ضمير يَربطُها بصاحبها، نحو: (جئت والناس نائمون)، ومنه قوله تعالى: {كما أخرجكَ ربُّك من بيتكَ بالحق، وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهونَ}، وقولهُ: {أَيأكلُهُ الذئبُ، ونحنُ عُصبةٌ}، وتقول: (جئتُ وما الشمسُ طالعةٌ). ب- أن تكون مُصدَّرَةً بضمير صاحبها، نحو: (جاء سعيدٌ وهو راكبٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {لا تَقرَبوا الصلاة وأنتم سُكارى}. ج- أن تكون ماضيَة غيرَ مُشتملةٍ على ضمير صاحبها، مُثبتةً كانت أو مَنفيَّةً. غير أنه تجب (قَدْ) معَ الواوِ في المثبتةِ، نحو: (جئتُ وقد طلعت الشمسُ)، ولا تجوز مع المنفيّةِ، نحو: (جئتُ وما طلعتِ الشمسُ). متى تمنع واو الحال؟ تمتنعُ واوُ الحال من الجملة في سبعِ مسَائلَ: أ- أن تقعَ بعد عاطفٍ، كقوله تعالى: {وكم من قريةٍ أهلكناها، فجاءَها بأسُنا بَياتاً، أو هم قائلونَ}. [قوله تعالى: {أهلكناها} أي أهلكنا أهلها. وقوله {فجاءها} أي: فجاء أهلها. فالكلام على حذف مضاف. والبأس: العذاب. وبياتاً: مصدر وضع موضع الحال، وهو مصدر بات يبات بياتاً، و {قائلون} : أي نائمون وقت الظهيرة، من القيلولة. والمعنى: جاء أهلها عذابنا بائتين أو قائلين] ب- أن تكونَ مُؤكدةً لمضمون الحملةِ قبلَها، كقولهِ سبحانهُ: {ذلكَ الكتابُ، لا ريبَ فيه}. ج- أن تكونَ ماضِيَّةً بعد (إلاَّ)، فتمتنعُ حينئذٍ من (الواو) و (قدْ) مجتمعينِ، ومُنفردتينِ، وتُربطُ بالضميرِ وحدَهُ، كقوله تعالى: {ما يأتيهم من رسول إلاَّ كانوا بهِ يستهزئونَ}. د- أن تكون ماضيّةً قبلَ (أو)، كقول الشاعر: كُنْ لِلخَليلِ نَصيراً، جارَ أوْ عَدَلاَ وَلاَ تَشُحَّ علَيْهِ. جادَ أَوْ بَخِلاَ هـ- أن تكونَ مُضارعيّةً مُثبَتةً غيرَ مُقترنةٍ بِقدْ وحينئذٍ تُربطُ بالضميرِ وحدَهُ، كقولهِ تعالى: {ولا تَمنُنْ تَستكثرُ}، ونحو: (جاء خالدٌ يحملُ كتابهُ). فإن اقترنت بِقدْ، وجبتِ الواوُ معَها، كقولهِ تعالى: {لِمَ تُؤذونني؟ وقد تَعلمونَ أني رسولُ اللهِ إليكم}. ولا يجوزُ الواوُ وحدَها ولا قَد وحدَها. بل يجبُ تجريدُها منهما معاً، أو اقترانُها بهما معاً، كما رأيت. و- أن تكونَ مُضارِعيّةً منفيّةً بِ (ما)، فتمنعُ حينئذٍ من الواو وقد، مُجتمعتينِ ومُنفردتينِ، وتُربَطُ بالضميرِ وحدَهُ كقول الشاعر: عَهْدْتُكَ ما تَصْبُو، وفيكَ شَبيبةٌ فَما لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًّا مُتَيَّما؟ وقول الآخر: كأنَّها - يومَ صَدَّتْ ما تُكَلِّمُنا – ظَبْيٌ بِعُسْفانَ ساجِي الْظَّرْفِ مَطْرُوفُ (وأجاز بعض العلماء اقترانها بالواو، نحو: (حضر خليل وما يركب). وليس ذلك بالمختار عند الجمهور. والذوق اللغوي لا يأباه. قال السيوطي في (همع الهوامع): والمنفيّ بما فيه الوجهان أيضاً، نحو: "جاءَ زيد وما يضحك؛ أو ما يضحك)). ز- أن تكونَ مُضارعيّةً مَنفيّةً بِـ (لا)، فتمنع أيضاً من(الواو) و (قَدْ) مُجتمعتينِ ومُنفردتينِ، كقوله تعالى: {وما لَنا لا نُؤمِنُ باللهِ}، وقولهِ: {ما لي لا أرَى الهُدهُدَ} (وأجاز قوم اقترانها بالواو، لكنه بعيد من الذوق اللغوي، قال ابن الناظم: (وقد يجيء (أي المضارع المنفي بلا) بالضمير والواو)). فإن كانت مَنفيّةً بِلَمْ، جاز أن تُربَطَ بالواوِ والضميرِ معاً، كقولهِ تعالى: {أو قالَ: أُوحِيَّ، إِليَّ ولم يُوحَ إليهِ شيءٌ}. متى تجوز واو الحال وتركها يجوزُ أن تقترنَ الجملةُ بواو الحالِ، وأن لا تقترنَ بها، في غير ما تقدَّمَ من صُوَر وُجوبها وامتناعها. غيرَ أن الأكثرَ في الجملةِ الاسميّة - مُثبتةً أو منفيةً - أن تقترنَ بالواو والضمير معاً. فالمُثبتةُ كقولهِ تعالى: {خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ}، وقولهِ: {فلا تجعلوا للهِ أنداداً وأنتم تعلمونَ}. والمنفيّةُ نحو: (رجعتُ وما في يدي شيءٌ). وقد تُربَطُ - مُثبَتةً أو منفيّةٌ - بالضمير وحدَهُ. فالمُثبتَةُ كقوله تعالى: {قُلنا: اهبِطوا بعضُكم لبعضٍ عدُوٌّ}. والمنفيّة كقوله تعالى: {واللهُ يَحكُمُ لا مُعَقْبَ لِحُكمه}. (ولا يشترط لاقتران الجملة الاسمية بالواو، عدم اقترانها بالا (كما توهم بعض أصحاب الحواشي سامحهم الله، فان ذلك ثابت في أفصح الكلام، قال تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم}. وهذا الشرط إنما هو للجملة الماضيَّة فقط، كما علمت، وأما الجملة الاسمية فقد تقترن بهما معاً كما رأيت، وقد تقترن بالا وحدها، كقوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون}). أمّا الجملةُ الماضيّة الحاليَّة، فإن كانت مثُبتَةً، فأكثرُ ما تُربَطُ بالضمير والواو وقَدْ معاً، كقوله تعالى: {أفتَطْمَعونَ أن يُؤمنوا لكم، وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلامَ اللهِ ثمّ يُحرفونهُ من بعدظش ما عقَلوهُ}. وأقلَ من هذا أن تُربَطَ بالضمير وحدَهُ، دون الواو وقَدْ، كقوله تعالى: {هذِهِ بِضاعتُنا رُدَّتْ إلينا}، وقولهِ: {أو جاءُوكم حَصِرَتْ صُدورُهم} وأقلّ من الجميعِ أن تُربَطَ بالضمير والواو فقط، دونَ قد، كقوله تعالى: {قالوا، وأقبلوا عليه: ماذا تفقِدون}، وقوله: {أنؤمِنُ لكَ واتّبعكَ الأرذلونَ}. إن كانت منفيّةً امتنعتْ معها (قد)، فهي تُربَط غالباً بالضمير والواو معاً، نحو: (رجعَ خالِدٌ وما صنعَ شيئاً). وقد تُربَطُ بالضمير وحدَهُ، نحو: (رجعَ ما صنعَ شيئاً). فإن لم تشتمل الجملةُ الماضيّة، مُثبتةً كانت أو منفيّة، على ضميرٍ يعودُ إلى صاحب الحال، رُبِطت المُثبتةُ بالواوِ وقد، والمنفيّةُ بالواو وحدها، وجوباً، كما سبقَ. |
10- تَعَدُّدُ الحالِ يجوزُ أن تَتعدّدَ الحالُ، وصاحبُها واحدٌ أو مُتَعدّدٌ. فمثالُ تعدُّدها، وصاحبُها واحدٌ، قولهُ تعالى: {فرجَعَ موسى إلى قومهِ غضبانَ أسِفاً}. وإن تَعدّدَت وتعدّدَ صاحبها، فإن كانت من لفظٍ واحدٍ، ومعنًى واحدٍ ثَنّيتها أو جمعتها، نحو: (جاءَ سعيدٌ وخالدٌ راكبينِ. وسافر خليلٌ وأخواه ماشِيينَ)، ومنه قوله تعالى: {وسَخَّرَ لكمُ الشمسَ والقمرَ دائِبَيْنِ} (والأصلُ دائبةً ودائباً) وقولهُ: {وسخَّرَ الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ والنجومَ مُسخّراتٍ بأمرهِ}. وإن اختلفَ لفظُهما فُرِّقَ بينهما بغير عطفٍ، نحو: (لَقيتُ خالداً مُصعِداً مُنحدراً. ولقيتُ دَعداً راكبةً ماشياً. ونظرتُ خليلاً وسعيداً واقفيْنِ قاعداً). وإنْ لم يُؤمنِ اللّبسُ أعطيتَ الحال الأولى للثاني والأخرَى للأولِ. فإن أردتَ العكس وجبَ أن تقول: (لقيتُ خالداً مُنحدِراً مُصعِداً، فيكونُ هوَ المنحدِر وأنت المُصعِد. وإن أُمِنَ من اللّبسُ، لظهور المعنى، كما في المثالينِ الباقيينِ، جاز التقديمُ والتأخير، لأنهُ يمكنُكَ أن تَرُدّ كلّ حال إلى صاحبها. فإن قلت: (لقيتُ دعداً ماشياً راكبةً. ونظرت خليلاً وسعيداً قاعداً راكبينِ)، جاز لِوضوح المعنى المراد. ومنه قول الشاعر: خَرَجْتُ بها أَمشِي تَجُرُّ وَراءَنا عَلى أَثَرَيْنا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ [المرط: كل ثوب غير مخيط. وكساء يؤتزر به، وربما تشده المرأة على رأسها وتتلفع به. والمرحل من الثياب ما أشبهت نقوشه رحال الإبل. وجملة أمشي: حال من تاء المتكلم. وجملة تجر: حال من ضمير الغائبة في (بها).] 11- تَتمَّةٌ وردت عن العَربِ ألفاظٌ، مركّبةٌ تركيبَ خمسةَ عشَر، واقعةً موقع الحالِ. وهي مبنيّة على فتح جُزءَيها، إلاّ ما كان جُزؤهُ الأولُ ياءً فبناؤهُ على السكون. وهذهِ الألفاظُ على ضربينِ: أ- ما رُكِّبَ، وأصلُهُ العطفَ، نحو: (تَفَرّقُوا شَذَرَ مَذَرَ، أو شَغَرَ بَغَرَ)، أي: "مُتفرّقِين، أو مُنتشرين، أو متَشتّتينَ)، ونحو: (هو جاري بيتَ بَيتَ)، أي: (مُلاصِقاً)، ونحو: (لَقيتُهُ كَفّةَ كَفّةَ)، أي: (مُواجِهاً). ب- ما رُكِّبَ، وأصلهُ الإضافةُ، نحو: (فَعلتُهُ بادِئَ بَدْءَ، وبادِيْ بَدْأَةَ، وبادِئَ بِداءَ، وباديْ بَداءَ، وبَدْأَةَ بَدْأَةَ)، أي: (فعلتُهُ مَبدوءاً بهِ" ونحو: (تفَرَّقوا، أو ذَهَبُوا أَيدي سَبَا وأَيادِي سَبا)، أي: (مُتَشتِتين). |
التمييز
التَّمييزُ: اسمٌ نكرةٌ يذكرُ تفسيراً للمُبهَم من ذاتٍ أو نِسبةٍ. فالأوّلُ نحو: (اشتريتُ عشرينَ كتاباً)، والثاني نحو: (طابَ المجتهدُ نفساً). والمُفسّرُ للمُبهَمِ يُسمّى: تمييزاً ومُميّزاً، وتفسيراً ومُفسّراً، وتبييناً ومُبيّناً، والمُفَسّرُ يُسمّى: مُميّزاً ومُفسّراً ومُبيّناً. والتّمييزُ يكونُ على معنى (مِنْ)، كما أنَّ الحال تكون على معنى (في). فإذا قلتَ: (اشتريتُ عشرين كتاباً)، فالمعنى أنكَ اشتريتَ عشرين من الكتُب، وإذا قلتَ: (طابَ المجتهدُ نفساً)، فالمعنى أنهُ طابَ من جِهة نفسهِ. والتَّمييزُ قسمانِ: تمييزُ ذاتٍ (ويسمّى: تمييزَ مُفرَدٍ أيضاً)، وتمييزُ نِسبةٍ (ويُسَمّى أيضاً: تمييزَ جملةٍ). وفي هذا المَبحث ثمانيةُ مَباحثَ: 1- تَمْيِيزُ الذَّاتِ وحُكْمُهُ تمييزُ الذاتِ: ما كان مُفسّراً لاسمٍ مُبهمٍ ملفوظٍ، نحو: (عندي رِطلٌ زَيتاً). والاسمُ المُبهَمُ على خمسة أنواع: أ- العَدَدُ، نحو: (اشتريتُ أحدَ عشرَ كتاباً). ولا فرقَ بينَ أن يكونَ العدَدُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مُبهَماً، نحو: (كم كتاباً عندكَ؟). والعددُ قسمانِ: صريحٌ ومُبهمٌ. فالعدَدُ الصريحُ ما كان معروفَ الكميّةِ: كالواحد والعشرةِ والأحدَ عشرَ والعشرينَ ونحوِها. والعدَدُ المُبهَمُ: ما كانَ كنايةً عن عَدَدٍ مجهولٍ الكميّةِ وألفاظهُ: (كَمْ وكأيِّنْ وكذا)، وسيأتي الكلام عليه. ب- ما دلَّ على مِقدارٍ (أي شيءٍ يُقدَّرُ بآلة). وهو إمّا مِساحةٌ نحو: (عندي قَصبَةٌ أرضاً)، أو وزنٌ، نحو: (لك قِنطارٌ عَسَلاً، أو كيلٌ، نحو: (أعطِ الفقيرَ صاعاً قمحاً)، أو مِقياسٌ نحو: (عندي ذراعٌ جوخاً). ج- ما دلَّ على ما يُشبهُ المقدارَ - مما يَدُلُّ على غيرِ مُعيّنٍ - لأنهُ غيرُ مُقدَّر بالآلة الخاصّة. وهو إمّا إن يُشبهَ المِساحةَ، نحو: (عندي مَدُّ البصرِ أرضاً. وما في السماء قَدْرُ راحةٍ سَحاباً)، أو الوزن كقوله تعالى: {فمن يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ، ومَنْ يعملْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ}، أو الكيلُ - كالأوعيةِ - نحو: (عندي جَرَّةٌ ماءً، وكيسٌ قمحاً، وراقودٌ خَلاًّ، ونِحْيٌ سَمناً، وحُبٌّ عسلاً"، وما أشبه ذلك، أو المِقياسَ، نحو: (عندي مَدُّ يَدِكَ حبلاً). [الراقود: خابية فخارية عظيمة مطلية من الداخل؛ والنِحي: الزق (من جلد السخلة؛ والحُب: إناء فخاري عظيم لحفظ الماء وتبريده بالرشح] د- ما أُجرِيَ مُجرَى المقادير - من كل اسمٍ مُبهَمٍ مُفتقرٍ إلى التّمييز والتّفسير، نحو: (لنا مِثلُ ما لَكم خيلاً. وعندنا غيرُ ذلك غَنَماً)، ومنه قولهُ تعالى: {ولو جئْنا بِمثلهِ مَدَداً}. هـ- ما كان فرعاً للتّمييز، نحو: (عندي خاتمٌ فِضّةً، وساعةٌ ذهباً، وثوبٌ صوفاً، ومِعطفٌ جوخاً). وحكمُ تمييز الذاتِ أنه يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جرُّه بمن، نحو: (عندي رِطلٌ من زيتٍ، ومِلْءُ الصّندوقِ من كتب)، وبالإضافة، نحو: (لنا قَصَبةُ أرضٍ، وقِنطارُ عَسَلٍ)، إلا إذا اقتضت إضافتُهُ إضافتْين - بأن كانَ المُمَيّزُ مضافاً - فتمتنعُ الإضافةُ، ويتَعيَّنُ نصبُهُ أو جَرُّهُ بِمِن، نحو: (ما في السّماءِ قدَرُ راحةٍ سَحاباً، أو من سَحابٍ). ويُستثنى منه تمييزُ العدَدِ، فإن له أحكاماً ستُذكر. 2- تَمْيِيزُ النِّسْبَةِ وحُكمُهُ تمييزُ النّسبةِ: ما كان مُفسّراً لجملةٍ مُبهَمةِ النسبةِ، نحو: (حَسُنَ علي خُلُقاً. ومَلأ الله قَلبَكَ سُروراً). فإنَّ نسبةَ الحُسنِ إلى عليٍّ مُبهَمةٌ تحتملُ أشياءَ كثيرة، فأزلتَ إبهامَها بقولك (خلُقاً). وكذا نسبةُ مَلْءِ اللهِ القلبَ قد زال إبهامُها بقولك: (سروراً). ومن تمييزِ النسبةِ الاسمُ الواقعُ بعدَ ما يُفيدُ التَّعجُّبَ، نحو: (ما أشجعَهُ رجلاً. أكرمْ بهِ تلميذاً. يا لهُ رجلاً. للهِ درُّهُ بَطلاً. وَيحَهُ رجلاً. حَسبُكَ بخالدٍ شُجاعاً. كفى بالشَّيبِ واعظاً. عَظُمَ عليٌّ مَقاماً، وارتفعَ رتبةً). وهو على قسمين: مُحَوَّلٍ وغير مُحوَّل. فالمحوَّلُ: ما كانَ أصلُهُ فاعلاً؛ كقوله تعالى: {واشتعلَ الرأسُ شيباً}[فالأصل: اشتعل شيب الرأس]، ونحو: (ما أحسنَ خالداً أدباً!)، أو مفعولاً، كقوله سبحانهُ: {وفجَّرنا الأرضَ عُيوناً}، ونحو: (زَرَعتُ الحديقةَ شجراً)، أو مُبتدأ، كقوله عزَّ وجلَّ: (أنا أكثرُ منكَ مالاً وأعزُّ نفراً)، ونحو: (خليلٌ أوفرُ علماً وأكبرُ عقلاً). وحُكمهُ أنهُ منصوبٌ دائماً. ولا يجوزُ جرُّهُ بِمن أو بالإضافة، كما رأيتَ. وغيرُ المحول: ما كان غير محوّل عن شيء، نحو: (أكرمْ بسليم رجلاً. سَمَوتَ أديباً. عظُمت شجاعاً، لله دَرُّهُ فارساً, ملأتُ خزائني كُتُباً. ما أكرَمكَ رجلاً). وحُكمُهُ أنهُ يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جَرهُ بِمن، نحو: (لله دَرُّهُ من فارس. أكرِمْ به من رجل. سَمَوتَ من أديب). واعلم أنَّ ما بعدَ اسم التفضيل ينصَبُ وجوباً على التَّمييزِ، إن لم يكن من جنس ما قبلَهُ، نحو: (أنتَ أعلى منزلاً). فإن كان من جنس ما قبلهُ وجبَ جَرُّهُ بإضافتهِ، إلى (أفعل)، نحو: (أنتَ أفضلُ رجلٍ). إلاّ إذا كانَ (أفعَلُ) مضافاً لغير التَّمييز، فيجبُ نصبُ التمييز حينئذٍ، لتعذُّرِ الإضافة مَرتينِ، نحو: (أنتَ أفضلُ الناسِ رجلاً). |
3- حُكمُ تَمْيِيزِ العَدَدِ الصَّريح
تمييزُ العددِ الصَّريحِ مجموعٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، منَ الثلاثةِ إلى العشرة، نحو: (جاءَ ثلاثةُ رجالٍ، وعشرُ نِسوةٍ)، ما لم يكن التمييزُ لفظَ مِئَةٍ، فيكون مفرداً غالباً، نحو: (ثلاث مِئَةٍ). وقد يُجمعُ نحو: (ثلاثِ مئينَ، أو مِئاتٍ). أما الألفُ فمجموع البتةَ، نحو: (ثلاثة آلافٍ). واعلم أنَّ مُميَّزَ الثلاثةِ إلى العشرة، إنما يُجرُّ بالإضافة إن كان جمعاً كعشرةِ رجالٍ. فإن كان اسمَ جمعٍ أو اسمَ جنس، جُرَّ بمن. فالأولُ: كثلاثةٍ من القوم، وأَربعةٍ من الإبل، والثاني: كستَّةٍ من الطَّيرِ، وسَبعٍ من النَّخلِ. قال تعالى: {فَخُذْ أَربعةً من الطَّير}. وقد يُجرُّ بالإضافة كقوله تعالى: {وكان في المدينةِ تسعةُ رَهْطٍ}. وفي الحديثِ (ليس فيما دونَ خَمسٍ ذَوْدٍ صَدَقةٌ)، [الرهط: عدد من الرجال بين الثلاثة والعشرة] [الذود: عدد من الإبل ما بين الثلاث الى عشر. واللفظة مؤنثة، ولذلك كان العدد معها مذكراً. والصدقة الزكاة] وقال الشاعر: ثَلاثَةُ أَنفُسٍ، وثَلاَثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جارَ الزَّمانُ على عِيالي وأما معَ أحدَ عشرَ إلى تسعةٍ وتسعينَ، فالتمييزُ مفردٌ منصوبٌ، نحو: (جاء أحدَ عشرَ تلميذاً، وتسعٌ وتسعونَ تلميذةً). وأما قوله تعالى: {وقَطَّعناهمُ اثنتيْ عشَرةَ أسباطاً}، فأسباطاً: ليس تمييزاً لاثنتيْ عَشرةَ، بل بدلٌ منه والتمييزُ مُقدَّر، أي: قطعناهم اثنتي عشرةَ فِرقةً، لأنَّ التمييزَ هنا لا يكونُ إلا مفرداً. ولو جازَ أن يكون مجموعاً - كما هو مذهبُ بعض العلماءِ - لَمَا جازَ هنا جعلُ (أَسباطاً تمييزاً، لأن الأسباطَ جمعُ سِبطٍ، وهو مُذكَّر، فكان ينبغي أن يُقالَ: وقطَّعناهم اثنتيْ عشرَ أسباطاً، لأنَّ الاثنين تُوافِقُ المعدودَ، والعشرةَ، وهي مركبةٌ، كذلك، كما مرَّ بك في بحث المركبات. وأما معَ المئَةِ والألفِ ومُثنَّاهما وجمعِهما، فهو مفردٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، نحو: (جاءَ مِئَةُ رجلٍ؛ ومِئَتا امرأَةٍ، ومِئاتُ غُلامٍ، والفُ رجلٍ، وأَلفا امرأَةٍ، وثلاثةُ آلافِ غلامٍ). وقد شذَّ تمييزُ المِئَة منصوباً في قوله: إذا عاشَ الْفَتى مِئَتَيْنِ عاماً فَقَدْ ذّهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالفَتاءُ 4- (كم) الاستِفْهامِيَّة وتَمْيِيزُها كم على قسمينِ: استفهاميّة وخَبَريّة. فكَمِ الاستفهاميةُ: ما يُستفهَمُ بها عن عددٍ مُبهَمٍ يُراد تَعيينُهُ، نحو: (كم رجلاً سافرَ؟). ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، كجميع أَدواتِ الاستفهام. ومُميّزُها مفردٌ منصوبٌ، كما رأَيتَ. وإن سبقها حرفُ جرّ جاز جره - على ضَعفٍ - بِمنْ مُقدَّرةً، نحو: (بكمْ درهمٍ اشتريتَ هذا الكتابَ؟) أَي: بكم من درهم اشتريته؟ ونصبُهُ أَولى على كلِّ حالٍ. وجرُّهُ ضعيفٌ. وأَضعفُ منه إظهارُ (مِنْ). ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميِّزها. ويكثرُ وقوعُ الفصل بالظّرف والجارِّ والمجرور، ونحو: (كم عندَك كتاباً؟. كم في الدار رجلاً؟). ويَقِلُّ الفصلُ بينهما بخبرها، نحو: (كم جاءَني رجلاً؟)، أو بالعامل فيها نحو: (كمن اشتريتَ كتاباً؟). ويجوزُ حذفُ تمييزِها، مثل: (كم مالُكَ؟) أي: كم درهماً، أو ديناراً، هُو؟. وحُكمُها، في الإعرابِ، أَن تكونَ في محلِّ جرٍّ، إن سبقَها حرفُ جرٍّ، أو مضافٌ، نحو: (في كم ساعة بلغتَ دمَشقَ؟)، ونحو: (رأيَ كم رجلاً أّخذتَ؟)، وأن تكونَ في محل نصب إن كانت استفهاماً عن المصدر، لأنها تكونُ مفعولاً مطلقاً، نحو: (كم إحساناً أحسنت؟)، أو عن الظّرفِ، لأنها تكونُ مفعولاً فيه، نحو: كم يوماً غِبْتَ؟ وكم ميلاً سِرتَ؟)، أَو عن المفعول به، نحو: (كم جائزةً نِلْتَ؟) أَو عن خبر الفعلِ الناقصِ، نحو: (كم إخوتُكَ؟). فإن لم تكن استفهاماً عن واحدٍ مما ذُكرَ، كانت في محل رفعٍ على أنها مبتدأ أو خبرٌ. فالأولُ نحو: (كم كتاباً عندَكَ؟)، والثاني نحو: (كم كتُبكَ؟). ولك في هذا أيضاً أن تجعل (كم) مبتدأ وما بعدَها خبراً. والأول أولى. |
5- (كم) الخَبَرِيَّة وتَمْيِيزُها كم الخبريّةُ: هي التي تكون بمعنى (كثيرٍ) وتكونُ إخباراً عن عدَد كثير مُبهَمِ الكميّةِ، نحو: (كم عالمٍ رأيتُ!)، أي: رأيتُ كثيراً من العلماء ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، ويجوز حذفُ مُميّزها، إن دلَّ عليه دليلٌ، نحو: (كم عَصَيتَ أمري!)، أي: (كم مَرَّةٍ عصيتَهُ!). وحكمُ مُميّزها أن يكونَ مفرداً، نكرةً، مجروراً بالإضافةِ إليها أو بِمن، نحو: (كم علمٍ قرأتُ!) ونحو: (كم من كريم أكرمتُ!). ويجوزُ أن يكون مجموعاً، نحو: (كم عُلومٍ أعرِفُ!). وإفرادُهُ أَولى. ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميّزها. فإن فُصِلَ بينهما وجبَ نصبُهُ على التَّمييز، لامتناعِ الإضافةِ معَ الفصلِ، نحو: (كم عندكَ درهماً!)، ونحو: (كم لك يا فتى فضلاً!) أو جرُّه بِمنْ ظاهرةً، نحو: (كم عندكَ من درهم!). ونحو: (كم لك يا فتى من فضل!). إلاّ إذا كان الفاصل فعلاً مُتعدّياً متسلّطاً على (كم)، فيجبُ جرُّهُ بمن، نحو: (كم قَرأتُ من كتابٍ)، كيلا يلتبسَ بالمفعول به فيما لو قلت: (كم قَرأتُ كتاباً). (وذلك لأن الجملة الأولى تدل على كثرة الكتب التي قرأتها، والجملة الأخرى تدلّ على كثرة المرّات التي قرأت فيها كتاباً. فكم في الصورة الأولى في موضع نصب على أنها مفعول به مقدم لقرأت، وفي الصورة الأخرى في موضع نصب على أنها مفعول مطلق له. لأنها كناية عن المصدر، والتقدير: كم قراءة قرأت كتاباً فيكون تمييزها محذوفاً). ويجوز في نحوِ: (كم نالني منك معروفٌ!)، أن تَرفعَهُ على أنه فاعل (نالَ)، فيكون تمييزُ (كم) مقدَّراً، أي (كم مرَّةٍ!). ويجوز أن تنصبَهُ على التمييز، فيكون فاعلُ (نال) ضميراً مستتراً يعود إلى (كم). وحكمُ (كم) الخبريّةِ، في الإعراب، كحُكم (كم) الاستفهامية تماماً، والأمثلةُ لا تخفى. واعلم أنَّ (كم) الاستفهاميةَ و (كم) الخبريَّةَ، لا يَتقدَّمُ عليهما شيءٌ من متعلَّقاتِ جُملَتيهما، إلا حرفُ الجرّ والمضاف، فهما يَعملانِ فيهما الجرَّ. فالأولى نحو: (بكم درهماً اشتريتَ هذا الكتاب؟) ونحو: (ديوانَ كم شاعراً قرأتَ؟)، والثانيةُ نحو: (إلى كم بلدٍ سافرتُ!) ونحو: (خطبةَ كم خَطيبٍ سَمِعتُ فَوَعيتُ!) وتشترِكُ (كم) الاستفهاميةُ و (كم) الخبريّة في خمسةِ أمور: كونُهما كنايتَينِ عن عددٍ مُبهَمٍ مجهولِ الجنس والمِقدارِ، وكونُهما مُبنيَّتينِ، وكون البناءِ على السكونِ، ولُزومُ التصديرِ، والاحتياجُ إلى التَّمييز. ويفترقانِ في خمسة أُمور أيضاً: 1- أنَّ مُميزيهما مختلفانِ إعراباً. وقد تقدَّم شرحُ ذلك. 2- أنَّ الخبريّة تختصُّ بالماضي، كَرُبَّ، فلا يجوزُ أن تقول: (كم كتُبٍ سأشتري!)، كما لا تقولُ: (رُبَّ دارٍ سأبني). ويجوز أن تقول: (كم كتاباً ستشتري؟). 3- أن المتكلَم بالخبرية لا يستدعي جواباً، لأنه مخبِرٌ، وليس بُمستفهِم. 4- أنَّ التصديقَ أو التكذيب يتوجَّهُ على الخبرية، ولا يتوجّه على الاستفهاميّة، لأنَّ الكلامَ الخبريّ يحتملُ الصدقَ والكذبَ. ولا يحتملُهما الاستفهاميُّ، لأنه إنشائي. 5- أنَّ المُبدَل من الخبريةِ لا يقترِنُ بهمزة الاستفهاميّة، تقولُ: (كم رجلٍ في الدار! عَشَرةٌ، بل عشرونَ). وتقولُ: (كم كتابٍ اشتريتَ! عَشَرةً، بل عشرينَ)، أما المُبدَلُ من الاستفهاميةِ فيقترن بها، نحو: (كم كتُبُكَ؟ أعشرَةٌ أم عشرون؟) ونحو: (كم كتاباً اشتريتَ؟ أَعشرةً، أَم عشرين؟). 6- (كأَيِّنْ) وتَمْيِيزُها كأيّنْ: (وتُكتَبُ: كأيٍّ أيضاً) مثل: (كم) الخبريّة معنًى. فهي تُوافقُها في الإبهام، والافتقارِ إلى التمييز، والبناءِ على السكون، وإفادةِ التّكثير، ولُزومِ أن تكونَ في صدر الكلام، والاختصاصِ بالماضي. وحكمُ مُميزها أن يكون مفرداً مجروراً بِمِنْ، كقوله تعالى: {وكأيّنْ من نَبيّ قاتلَ معَهُ رِبَيُّونَ كثير} [الرِبيون: الألوف من الناس أو الجماعات. وفُسِرَت أيضاً هنا بالعلماء الأتقياء والعابدين والواحد (رِبِّي) نسبة الى الرِبة، وهي الجماعة] وقولهِ: {وكأيّنْ من دابّة لا تَحمِلُ رزقَها، اللهُ يَرزقُها وإياكم} [كأين: اسم كناية، في محل رفع مبتدأ. وجملة (لا تحمل رزقها): صفة الدابة وجملة (الله يرزقها وإياكم)، من المبتدأ والخبر: في محل رفع خبر (كأين)] وقولِ الشاعر: وَكائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ، لكَ مُعجبٍ زِيادَتُهُ، أَو نَقْصُهُ، في التَّكَلُّمِ! وقد يُنصبُ على قِلَّة، كقولِ الآخر: وَكائِنْ لَنا فَضْلاً عَلَيْكُمْ ومِنَّةً قَديماً! ولا تَدْرُونَ ما مَنُّ مُنْعِمِ؟ وقول غيره: أُطْرُدِ الْيأْسَ بالرَّجا، فَكَأيِّنْ آلِماً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرٍ! وحكمها في الإعراب، كحكم أُختها (كم) الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يُخبَر عنها إلا بجملةٍ أو شبهها (أي الظَّرفِ والجارّ والمجرور)، كما رأيتَ ولا يُخبَرُ عنها بمفردٍ، فلا يقالُ: (كأينْ من رجلٍ جاهلٌ طريق الخير!)، بخلاف (كم). 7- (كَذا) وتَمْيِيزُها تكونُ (كذا) كنايةً عن العددِ المبهَمِ، قليلاً كان أو كثيراً، نحو: (جاءني كذا وكذا رجلاً)، وعن الجملةِ، نحو: قلتُ: (كذا وكذا حديثاً) والغالب أن تكونَ مُكرَّرةً بالعطفِ، كما رأيت. وقد تُستعمَلُ مُفردَةً أو مكرَّرةً بلا عَطف. وحكمُ مُميّزها أنه مفردٌ منصوبٌ دائماً، كما رأيت. ولا يجوزُ جرهُ. قال الشاعر: عِدِ النَّفْس نُعْمى، بَعدَ بُؤْساكَ، ذاكراً كَذا وكَذا لُطْفاً بهِ نُسِيَ الجَهْدُ وحُكمُها في الإعراب أنها مبنيّةٌ على السكون. وهي تقع فاعلاً، نحو: (سافر كذا وكذا رجلاً)، ونائب فاعل، نحو: (أُكرِمَ كذا وكذا مجتهداً)، ومفعولاً به نحو: (أكرمتُ كذا وكذَا عالماً)، ومفعولاً فيه، نحو: (سافرتُ كذا وكذا يوماً. وسرت كذا وكذا ميلاً)، ومفعولاً مطلقاً، نحو: (ضربتُ اللصَّ كذا وكذا ضَربةً)، ومبتدأ، نحو: (عندي كذا وكذا كتاباً)، وخبراً، نحو: (المسافرونَ كذا وكذا رجلاً). |
8- بعضُ أَحكامٍ للتَّمْيِيز
أ- عاملُ النّصبِ في تمييزِ الذاتِ هو الاسمُ المُبهَمُ المميَّزُ، وفي تمييزِ الجملةِ هو ما فيها من فعل أو شِبههِ. ب- لا يَتَقدَّمُ التمييزُ على عامله إن كان ذاتاً: (كرطل زيتاً)، أو فعلاً جامداً، نحو: (ما أحسنَهُ رجلاً. نِعمَ زيدٌ رجلاً. بِئس عَمرٌو امرأً). ونَدَر تَقدُّمُهُ على عاملهِ المتصرّفِ، كقولهِ: أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيْلِ المُنى؟ وداعِي المْمَنُونِ يُنادي جِهارا! أمّا تَوسُّطُهُ بينَ العاملِ ومرفوعهِ فجائزٌ، نحو: (طابَ نفساً علي). ج- لا يكونُ التمييزُ إلاّ اسماً صريحاً، فلا يكونُ جملةً ولا شِبهَها. د- لا يجوز تعدُّدُهُ. هـ- الأصلُ فيه أن يكونَ اسماً جامداً. وقد يكونُ مشتقاً، إن كان وصفاً نابَ عن موصوفهِ، نحو: (للهِ دَرُّهُ فارساً!. ما أحسنَهُ عالماً!. مررت بعشرينَ راكباً). (لأن الأصل: "لله درّهُ رجلاً فارساً، وما أحسنه رجلاً عالماً، ومررت بعشرين رجلاً راكباً). فالتمييز، في الحقيقة، إنما هو الموصوف المحذوف). و- الأصلُ فيه أن يكونَ نكرةً. وقد يأتي معرفةً لفظاً، وهو في المعنى نكرةٌ، كقول الشاعر: رَأَيتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجوهَنا صَدَدْتَ، وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو وقول الآخر: (عَلاَمَ مُلِئْتَ الرُّعبَ؟ وَالحَرْبُ لم تَقِدْ). فإن (أل) زائدةٌ، والأصل: (طِبتَ نفساً، ومُلِئتَ رعباً)، كما قال تعالى: {لَوَلْيتَ منهم فراراً،، ولُمُلئتَ منهم رُعباً}. وكذا قولهم: (ألِمَ فلانٌ رأسَهُ) أي: (ألِمَ رأساً). قال تعالى: {إلاّ مَنْ سَفِه نَفسَه}، وقال: {وكم أهلكنا من قرية بَطِرَتْ مَعيشَتها}، أي: (سَفِهَ نفساً، وبَطِرَت مَعيشةً). فالمعرفةُ هنا، كما ترى، في معنى النكرة. (وكثير من النحاة ينصبون الاسم في نحو: (ألم رأيه، وسفه نفسه، وبطرت معيشتها) على التشبيه بالمفعول به. ومنهم من لم يشترط تنكير التمييز، بل يجيز تعريفه مستشهداً بما مرّ من الأمثلة. والحق أن المعرفة لا تكون تمييزاً إلا اذا كانت في معنى التنكير، كما قدمنا). ز- قد يأتي التمييزُ مؤكّداً، خلافاً لكثير من العُلماءِ، كقوله تعالى: {إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عندَ اللهِ اثنا عشرَ شهراً} ونحو: (اشتريتُ من الكتبِ عشرينَ كتاباً)، فشهراً وكتاباً لم يذكرا للبيانِ، لأنَّ الذات معروفة، وإنما ذُكرا للتأكيد. ومن ذلك قول الشاعر: وَ التَّغْلِبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُم فَحْلاً، وأُمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ [الزلاَّء: الرسحاء، الخفيفة الوركين. والمنطيق: المرأة تضم الى عجيزتها حشيّةً تكبرها بها] ح- لا يجوزُ الفصلُ بينَ التمييزِ والعدَدِ إلاّ ضرورة في الشعر كقوله (في خَمْسَ عَشْرَةَ من جُمادَى لَيْلَةً) يريدُ: في خَمسَ عَشرَةَ ليلةً من جُمادى. ط- إذا جئتَ بعد تمييز العَددِ - كأحدَ عشرَ وأخواتها، وعشرين وأخواتها - بِنعتٍ، صَحّ أن تُفردهُ منصوباً باعتبارِ لفظِ التمييز، نحو: (عندي ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون، رجلاً كريماً)، وصَحَّ أن تجمعهُ جمعَ تكسيرٍ منصوباً، باعتبار معنى التمييز، نحو: (عندي ثلاثة عَشر، أو ثلاثون رجلاً كِراماً، لأن رجلاً هُنا في معنى الرجال، ألا ترى أنَّ المعنى: ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون من الرجال). ولكَ في هذا الجمعِ المنعوتِ به أن تحمِلَهُ، في الإعراب، على العَدَد نفسه، فتَجعلهُ نعتاً لهُ، نحو: (عندي ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون رجلاً كِراماً). ولكَ أن تقولَ: (عندي أَربعونَ درهماً عربياً أَو عربيّةً)، فالتذكير باعتبار لفظٍ الدرهم، والتأنيث باعتبار معناهُ، لأنه في معنى الجمع، كما تقدمَ. فإن جمعتَ نعتَ هذا التمييز جمعَ تصحيحٍ، وجبَ حملُهُ على نفسه، وجعلُهُ نعتاً لهُ لا للتمييز، نحو: (عندي أَربعةَ عشرَ، أو أَربعونَ، رجلاً صالحونَ). ي- قد يضافُ العددُ فيستغنى عن التّمييز، نحو: (هذه عَشَرَتُكَ، وعِشرُو أبيك، وأحدَ عشرَ أَخيكَ)، لأنك لم تُضِف إِلاَّ والمُميّزُ معلومُ الجنس عند السامع. ويستثنى من ذلك (اثنا عشرَ واثنتا عَشْرةَ)، فلم يُجيزُوا إضافتها، فلا يقال: (خُذِ اثنيْ عشرَكَ)، لأنَّ عَشْرَ هنا بمنزلةِ نون الاثنين، ونونُ الاثنينِ لا تجتمعُ هي والإضافة، لأنها في حكم التنوينِ، فكذلك ما كان في حكمها. واعلم أنَّ العددَ المركبَ، إذا اضيفَ، لا تُخِلُّ إِضافته ببنائه، فيبقى مبنيّ الجزءَين على الفتحِ، كما كان قبلَ إضافتهِ، نحو: (جاءَ ثلاثةَ عشرَكَ). ويرى الكوفيّون أنَّ العددَ المركّب إذا اضيفَ أعرب صدرُهُ بما تقتضيهِ العواملُ، وجرَّ عَجزُهُ بالإضافةِ نحو: "هذه خمسةُ عشَركِ. خُذْ خمسةَ عشرِكَ. أعطِ من خمسةِ عشرِكَ) والمختارُ عند النُّحاة أنَّ هذا العددَ يلزم بناءَ الجزءين، كما قدَّمنا. |
( الاستثناء )
الاستثناءُ: هو إخراجُ ما بعدَ (إلاّ) أو إحدَى أخواتها من أدوات الاستثناءِ، من حكم ما قبلَهُ، نحو: (جاءَ التلاميذُ إلاّ عليّاً).. والمُخرَجُ يُسمّى (مستثنى)، والمُخرَجُ منه (مُستثنى منه). وللاستثناءِ ثماني أَدواتٍ، وهي: (إلاّ وغيرٌ وسِوًى (بكسر السين. ويقال فيها أيضاً سُوًى - بضم السين - وسَواءٌ - بفتحها) وخَلا وعَدا وحاشا وليسَ ولا يكونُ). وفي هذا المبحث ثمانية مباحث: 1- مَباحِثُ عامَّةٌ أ- المُستثنى قسمانِ: مُتَّصلٌ ومنقطعٌ. فالمُتّصلُ: ما كان من جنس المُستثنى منه، نحو: (جاءَ المسافرون إلا سعيداً). والمُنقطعُ: ما ليسَ من جنس ما استثنيَ منه، نحو: (احترقت الدارُ إلاّ الكتُبَ). ب- الاستثناء: استفعالٌ من (ثنَاهُ عن الأمر يثنيهِ): إذا صَرَفهُ عنه ولواه. فالاستثناءُ: صرفُ لفظِ المُستثنى منه عن عمومه، بإخراج المستثنى من أن يتناولهُ ما حُكِمَ به على المستثنى منه. فإذا قلتَ: (جاءَ القومُ، ظُنَّ أنَّ خالداً داخلٌ معهم في حكم المجيءِ أيضاً، فإذا استثنيتَهُ منهم، فقد صرفتَ لفظَ (القوم) عن عُمومه باستثناءِ أحدِ أفرادهِ - وهو خالدٌ - من حكم المجيءِ المحكومِ به على القوم. لذلك كان الاستثناءُ تخصيصَ صفةٍ عامّةٍ بذكر ما يَدُلُّ على تخصيص عمومها وشُمولها بواسطة أداةِ من أدوات الاستثناء. فإذا علمتَ هذا، علمتَ أَن الاستثناء من الجنس، هو الاستثناءُ الحقيقيُّ، لأنه يُفيدُ التخصيص بَعدَ التّعميم، ويُزيلُ ما يُظَنُّ من عُموم الحكم. وأَما الاستثناءُ من غير الجنس فهو استثناءٌ لا معنى له إلاّ الاستدراكُ، فهو لا يُفيدُ تخصيصاً، لأن الشيءَ إنما يُخصّصُ جنسَهُ. فإذا قلتَ: (جاءَ المسافرون إلا أَمتعتَهُم)، فلفظ (المسافرين) لا يتناول الأمتعةَ، ولا يدلُّ عليها. وما لا يَتناولهُ اللفظُ فلا يحتاجُ إلى ما يخرجُهُ منهُ. لكنْ إنما استثنيتَ هُنا استدراكاً كيلا يُتَوهم أن أَمتعتَهُم جاءَت مَعهم أَيضاً، عادةَ المسافرين. فالاستثناءُ المتَّصلُ يُفيدُ التَّخصيصَ بعدَ التعميم، لأنهُ استثناءٌ من الجنس. والاستثناءُ المُنقطعُ يُفيدُ الاستدراكَ لا التّخصيصَ، لأنه استثناءٌ من غير الجنس. ج- لا يستثنى إلاّ من معرفةٍ أو نكرةٍ مُفيدةٍ، فلا يقالُ (جاءَ قومٌ إلا رجلاً منهم)، ولا (جاءَ رجالٌ إلا خالداً). فإن أفادت النكرةُ جاز الاستثناء منها، نحو: (جاءَني رجالٌ كانوا عندكَ إلاّ رجلاً منهم) ونحو: (ما جاءَ أحدٌ إلا سعيداً)، قال تعالى: {فَلَبِثَ في قومهِ أَلفَ سنةٍ إلا خمسينَ عاماً}. وتكونُ النكرةُ مفيدة إذا أُضيفتْ، أو وصِفت، أو وقعت في سياقِ النفي أو النَّهي أو الاستفهام. وكذا لا يُستثنى من المعرفة نكرةٌ لم تخصَّص، فلا يقالُ: (جاء القومُ إلاّ رجلاً). فإن تُخصّصَت جاز، نحو: (جاء القومُ إلاّ رجلاً منهم، أو إلاَّ رجلاً مريضاً، أو إلاّ رجلَ سُوءٍ). د- يصح استثناءُ قليلٍ من كثير. وكثيرٍ من أكثرَ منه. وقد يُستثنى من الشيء نصفُهُ، تقول: (لهُ عليَّ عشرةٌ إلا خمسةً)، قال تعالى: {يا أَيُّها المُزَّمِّلُ، قُمِ الليلَ إلاّ قليلاً، نِصفَه، أَو انقُصْ منهُ قليلاً، أو زِدْ عليه}. فقد سمّى النصفَ قليلاً واستثناهُ من الأصل. وقال قومٌ: لا يستثنى من الشيءِ إلا ما كان دونَ نصفهِ. وهو مردودٌ بهذه الآية. [الراجح من أقوال المفسرين أن (قليلاً) مستثنى من الليل، و(نصفه): بدلاً من قليلاً، وقِلته بالنسبة الى الكل] هـ- استثناءُ الشيء من غيرِ جنسهِ لا معنى له. وما ورد من ذلك فليست فيه (إلاّ) للاستثناء على سبيل الأصل. وإنما هي بمعنى (لكنْ)، وهو ما يُسمونهُ: (الاستثناء المُنقَطِع). ومعّ ذلك فلا بدّ من الارتباط بين المستثنى منه والمستثنى، كما ستعلم ذلك ... ومن ذلك قوله تعالى: {ما أنزَلنا عليك القرآنَ لِتشقى، إلا تَذكرَةً لِمن يخشى}، أي: لكن أنزلناهُ تذكرةً، وقولُهُ: {فذَكّر، إنما أنتَ مُذكّرٌ، لستَ عليهم بِمُسَيطرٍ، إلاّ مَنْ تَوَلى وكفرَ فَيُعذبُهُ اللهُ العذابَ الأكبرَ}، أي: لكنْ مَنْ تَوّلى وكفرَ. [تذكرة: مُستثنى من المصدر المؤول من (تشقى) بأن المُقدرة، والتقدير ما أنزلنا عليك القرآن لشقائك] [من تولى وكفر: من مستثنى من الضمير في عليهم] |
2- حُكْمُ المُسْتَثْنَى بِإلاَّ المُتَّصِلِ
إن كان المستثنى بإلاّ مُتَّصلاً، فلهُ ثلاثُ أحوال: وجوبَ النصبِ بإلاّ وجوازُ النّصبِ والبدليّةِ، ووجوبُ أن يكونَ على حسبِ العواملِ قبلَه. متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ يجبُ نصبُ المستثنى بإلاّ في حالتين: أ- أن يقعَ في كلامٍ تام موجَب، سواءٌ أتأخرَ عن المستثنى منهُ أم تقدَّمَ عليه. فالأولُ نحو: (ينجحُ التلاميذُ إلا الكسولَ)، والثاني نحو: (ينجحُ إلاّ الكسولَ التلاميذُ). والمُرادُ بالكلامِ التام أن يكونَ المُستثنى منه مذكوراً في الكلام، وبالمُوجَب أن يكونَ الكلامُ مُثَبتاً، غيرَ منفي. وفي حكم النَّفي النَّهيُ والاستفهامُ الإنكاري. ولا فرقَ بينَ أن يكون النفيُ معنًى أو بالأداةِ، كما ستعلم. ب- أن يقعَ في كلامٍ تام منفي، أو شِبهِ منفي، ويتقدَّمَ على المستثنى منه، نحو: (ما جاء إلا سليماً أحدٌ) ومنه قولُ الشاعر: ومَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحمدَ شِيعَةٌ وما لِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ فإن تقدَّمَ المستثنى على صفة المُستثنى منه، جاز نصبُ المستثنى بإلا، وجاز جعلهُ بدلاً من المستثنى منه، نحو: (ما في المدرسة أحد إلا أخاك، أو إلاّ أخوكَ، كَسولٌ). متى يجوز في المستثنى بالاّ الوجهان يجوز في المستثنى بإلاّ الوجهان - جَعلُهُ بَدَلاً من المستثنى منه. ونصبُهُ بالاّ - إن وقعَ بعدَ المستثنى منه في كلامٍ تام منفيٍّ أو شِبهِ منفيّ، نحو: (ما جاءَ القومُ إلاّ علي، وإلا علياً). وتقولُ في شِبه النفي: (لا يَقمْ أحدٌ إلاّ سعيدٌ، وإلا سعيداً. وهل فعلَ هذا أحدٌ إلا أنت، وإلا إياك!) والإتباع على البدليّة أولى. والنصبُ عربي جَيِّدٌ. ومنه قوله تعالى: {ولا يَلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتَكَ}. (وقُرئَ إلا امرأتُكَ)، بالرفع على البدلية. ومن أمثلة البدليّةِ، والكلامُ منفيٌّ، قولُهُ تعالى: {ما فعلوهُ إلاَّ قليلٌ منهم}، وقرئَ (إلاّ قليلاً) بالنصب بالاّ، وقولُهُ: {لا إله إلاّ اللهُ}، وقوله: {ما من إله إلاّ إلهٌ واحدٌ} [من: حرف جر زائد. وإله: مجرور لفظاً بمن الزائدة، مرفوع محلاً لأنه مبتدأ. وخبره محذوف تقديره: موجود إله. إما بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وإما بدل من محل إله الأول، لأن محله الرفع على الابتداء، كما ذكرنا] وقوله: {ما من إلهٍ إلاّ اللهُ}. ومن أمثلتها، والكلامُ شِبهُ منفي، لأنهُ استفهامٌ إنكاري، قولهُ تعالى: {ومَن يغفرُ الذُّنوبَ إِلاّ اللهُ!}، وقولهُ: {ومَن يقنَطُ من رحمةِ ربهِ إلاّ الضّالون؟!}. وقد يكونُ النفيُ معنوياً، لا بالأداةِ، فيجوزُ فيما بعدَ (إلاّ) الوجهان أيضاً - البدليّةُ والنصبُ بإلاّ، والبدليّة أولى - نحو: (تَبدَّلت أخلاقُ القوم إلاّ خالدٌ، وإلاّ خالداً)، لأن المعنى: لم تَبقَ أخلاقُهم على ما كانت عليه، ومنه قول الشاعر: وبَالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عافٍ، تَغَيَّرَ، إلاَّ النُّؤْيُ وَالْوَتِدُ [ الصريمة: موضع، وأصلها: قطعة من الرمل ضخمة تنصرم ـ أي تنقطع ـ عن سائر الرمال. والخلق: البالي. والنؤي: حفير حول الخيمة يمنع السيل] فمعنى تغيّرَ: لم يبقَ على حاله. (وإنما جاز الوجهان في مثل ما تقدم، لأنك إن راعيت جانب اللفظ نصبت ما بعد (إلا)، لأن الجملة قد استوفت جزءيها - المسند والمسند إليه - فيكون ما بعد (إلا) فضلة، والفضلة منصوبة, وان راعيت جانب المعنى رفعت ما بعدها، لأن المسند إليه في الحقيقة هو ما بعد (إلا). لذلك يصح تفريغ العامل الذي قبلها له وتسليطه عليه. فان قلت: (ما جاء القوم إلا خالد. أو خالداً)، صحّ أن تقول: (ما جاء إلا خالد)، فنصبه باعتبار أنه عمدة في المعنى، فهو بدل مما قبله، والمبدل منه في حكم المطروح. ألا ترى أنك إن قلت: (أكرمت خالداً أباك)، صحّ أن تقول: (أَكرمت أَباك)). متى يجب أن يكون المستثنى بالا على حسب العوامل. يجبُ أن يكون المستثنى بإلا على حسب ما يطلبُهُ العاملُ قبلَهُ، متى حُذِفَ المستثنى منه من الكلام، فيتفرَّعُ ما قبلَ (إلا) للعملِ فيما بعدَها، كما لو كانت (إلا) غيرَ موجودةٍ. ويجبُ حينئذٍ أن يكون الكلامُ منفيّاً أو شِبهَ منفيٍّ، نحو: (ما جاءَ إلا عليٌّ، ما رأيتُ إلا عليّاً، ما مررتُ إلا بعليّ) ومنه في النهي قوله تعالى: {ولا تَقولوا على الله إلا الحقّ}، وقولهُ: {ولا تُجادلوا أهلَ الكتابِ إلا بالتي هيَ أحسن}. ومنه في الاستفهامِ قولُه سبحانهُ: {فَهَلْ يَهلِكُ إلا القومُ الفاسقون}. وقد يكونُ النفيُ معنويّاً، كقولهِ تعالى: {ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نورَهُ}، لأنَّ معنى يأبى: لا يريدُ. |
3- حُكُم المُستثْنى بِإِلاَّ المُنْقَطِعِ
إن كان المُستثنى بإلا منقطعاً، فليس فيه إلا النصبُ بالا، سواءٌ أتقدَّمَ على المستثنى منه أم تأخر عنه، وسواءٌ أكان الكلام مُوجَباً أم منفياً، نحو ) جاءَ المسافرونَ إلا أمتعتَهم. جاءَ إلا أمتعتَهمُ المسافرون. ما جاءَ المسافرون إلا أمتعتَهم(. ومن الاستثناء المُنقطع قولهُ تعالى: {ما لهم به من علمٍ، إلا إتباعَ الظنّ}، وقوله: {وما لأحدٍ عندَهُ من نِعمةٍ تُجزى، إلا ابتغاءَ وجهِ ربهِ الأعلى}. ولا تجوز البدليّةُ في الكلام المنفيّ، هنا، إن صحَّ تَفرُّغ العاملِ قبلَه له وتَسلُّطهُ عليه. فيجيزون أن يقالَ: (ما جاءَ المسافرونَ إلا أمتعتُهم)، لأنك لو قلتَ: (ما جاءَ إلا أمتعةُ المسافرين)، لَصَحَّ. وعليه قولُ الشاعر: وبَلْدةٍ لَيْسَ بِها أَنيسُ إِلاَّ الْيَعافِيرُ، وإِلاَّ العِيسُ [اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية (المها). والعيس: الإبل البيض المخلوط بياضها شقرة أو سواد خفي، والذكر أعيس والأنثى عيساء] وقول الآخر: عَشِيَّةَ لا تُغْنِي الرِّياحُ مَكانَها ولا النَّبْلُ، إِلاَّ المَشْرِفيُّ المُصَمِّمُ [المشرفي: السيف، والمصمم القاطع الماضي في الصميم، وهو العَظم الذي به قوام العضو] وقول غيره: وَبِنتَ كِرامٍ قد نَكحْنا، ولم يَكُنْ لَنا خاطِبٌ إلا السِّنانُ وعامِلُهُ [عامل الرمح: صدره] 4- (إلاَّ) بِمَعْنى (غَيْر) الأصلُ في (إلاّ) أن تكونَ للاستثناء، وفي (غير) أن تكون وصفاً. ثمَّ قد تُحمَلُ إحداهما على الأخرى، فَيوصَفُ بإلاّ، ويُستثنى بغير. فان كانت (إلا) بمعنى (غير)، وقعت هي وما بعدَها صفةً لما قبلها، (وذلك حيثُ لا يُرادُ بها الاستثناءُ، وإنما يُرادُ بها وصفُ ما قبلَها بما يُغاير ما بعدَها)، ومن ذلك حديثُ: (الناسُ هلَكَى إلا العالِمونَ، والعالِمونَ هَلكَى إلا العامِلونَ، والعاملونَ هلكى إلاّ المخلصون)، أي: (الناسُ غيرُ العالمينَ هَلكى، والعالمونَ غيرُ العاملين هلكى، والعاملونَ غيرُ المخلصينَ هَلكى) ولو أراد الاستثناءَ لنصبَ ما بعدَ (إلا) لأنهُ في كلام تامٍّ مُوجَبٍ. وقد يصحُّ الاستثناءُ كهذا الحديث، وقد لا يصحُّ، فيتعيّن أن تكونَ (إلا) بمعنى (غير)، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا}. فالا وما بعدَها صفةٌ لآلهَة، لأنَّ المُرادَ من الآية نفي آلهةٌ المتعدِّدةِ وإثبات الآلهِ الواحد الفرد. ولا يصحُّ الاستثناءُ بالنصب، لأنَّ المعنى حينئذٍ يكون: (لو كان فيهما آلهةٌ، ليس فيهمُ اللهُ لفسدتا). وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهةٌ، فيهمُ الله، لم تَفسْدا، وهذا ظاهرُ الفسادِ. وهذا كما تقولُ: (لو جاءَ القوم إلا خالداً لأخفقوا) أي: لو جاءُوا مستثنًى منهم خالدٌ - بمعنى أنه ليس بينهم - لأخفقوا. فهم لم يُخفقوا لأنَّ بينهم خالداً. ونظيرُ الآية - في عدم جواز الاستثناءِ - أن تقول: (لو كان معي دراهمُ، إلا هذا الدرهمُ). فان قلتَ: (إلا هذا الدرهمَ)، بالنصب كان المعنى: لو كان معي دراهمُ ليس فيها هذا الدرهمُ لبذلتُها، فيُنتجُ أنكَ لم تبذُلها لوجودِ هذا الدرهمِ بينّها. وهذا غير المراد. ولا يَصِحُّ أيضاً أن يُعرَب لفظ الجلالةِ بدلاً من آلهة، ولا (هذا الدرهم)، بدلاً من دراهمَ، لأنهُ حيثُ لا يَصِحُّ الاستثناءُ لا تصحُّ البدليّةُ. ثم إنَّ الكلامَ مُثبتٌ، فلا تجوزُ البدليّةُ ولو صحَّ الاستثناءُ، لما علمتَ من أنَّ النصبَ واجبٌ في الكلام التامّ المُوجَبِ. وأيضاً: لو جعلتَهُ بدلاً لكان التقديرُ: (لو كان فيهما إلا اللهُ لفسدتا)، لأنَّ البدلَ على نِيَّةِ طرحِ المُبدَل منه، كما هو معلومٌ. ولعدَم صحَّةِ الاستثناءِ هنا وَعدَمِ جَواز البدليّة تَعيَّنَ أن تكونَ (إلا) بمعنى (غير). وممّا جاءَت فيه (إلا) بمعنى (غير)، معَ عدم تَعذُّرِ الاستثناءِ معنًى، قول الشاعر: وكلُّ أخٍ مُفارقُهُ أخوهُ لَعَمْرُ أَبيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ أي: كلُّ أخٍ، غيرُ الفرقدينِ، مفارقُهُ أخوه. ولو قال: (كل أخٍ مُفارقُهُ أخوهُ إلا الفَرقدينِ) لَصَحَّ. [الفرقدان: هما كوكبان معروفان بتقاربهما ومجاورتهما الأزلية، من مجموعة بنات نعش [[صبح الأعشى: القلقشندي]] ] واعلم أنَّ الوصفَ هو (إلا) وما بعدَها معاً، لا (إلا) وحدَها، ولا ما بعدَها وحدَه، معَ بقائها على حرفيّتها، كما يُوصف بالجارّ والمجرورِ معَ بقاءِ حرف الجرِّ على حرفيته. والإعرابُ يكون لِما بعدَها. ومن العلماءِ من يجعلُها اسماً مبنياً بمعنى (غير) ويَجعلُ إعرابها المحلّي ظاهراً فيما بعدَها. والجمهور على الأول وهوَ الأولى. |
5- حُكُم المُستَثْنى بِغَيْرٍ وسِوًى
غيرٌ: نكرة مُتوغلةٌ في الإبهام والتَّنكير، فلا تُفيدُها إضافتُها إلى المعرفة تعريفاً، ولهذا تُوصَفُ بها النكرةُ مع إضافتِها إلى معرفةٍ، نحو: (جاءَني رجلٌ غيرُكَ، أو غيرُ خالدٍ). فلذا لا يُوصَفُ بها إلا نكرةٌ، كما رأيتَ، أو شبهُ النكرةِ مِمّا لا يفيدُ تعريفاً في المعنى، كالمُعرَّفِ بألِ الجنسيةٍ، فإنَّ المعرَّفَ بها، وإن كان معرفة لفظاً، فهو في حكم النكرةِ معنًى، لأنه لا يدُلُّ على مُعيَّنٍ. فان قلتَ: (الرجالُ غيرُك كثيرٌ)، فليس المرادُ رجالاً مُعيَّنينَ. ومثلُها في تنكيرها، وتَوَغُّلها في الإبهام، ووصفِ النكرةِ أو شبهها بها، وعدمِ تعرُّفها بالإضافةِ (مِثلٌ وسِوًى وشِبْهٌ ونظيرٌ). تقول: (جاءَني رجلٌ مِثلُك، أو سِواكَ، أو شِبهُكَ، أو نظيرُكَ). وقد تُحمَلُ (غير) على (إلا) فيُستثنى بها، كما يستثنى بإلا، كما حُملتْ (إلا) على (غير) فَوُصِفَ بها. والمستثنى بها مجرورٌ أبداً بالإضافة إليها، نحو: (جاءَ القومُ غيرَ عليّ). وقد تُحمَلُ (سِوى) على (إلا)، كما حُمِلت (غيرٌ)، لأنها بمعناها، فتقول: (جاءَ القومُ غيرَ خالدٍ)، بالنصب، لأنَّ الكلام تامٌّ مُوجَبٌ. وتقول: (ما جاءَ غيرَ خالدٍ أحدٌ)، النصب أيضاً، وإن كان الكلامُ منفيّاً، لأنها تقدَّمت على المستثنى منه. وتقول: (ما احترقتِ الدارُ غيرَ الكتبِ)، بالنصب، وإن كان الكلام منفيّاً، ولم يَتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه، لأنها وقعت في استثناء مُنقطع. وتقول: (ما جاءَ القومُ غيرُ خالدٍ، أو غيرَ خالد)، بالرفع على أنها بدلٌ من القوم، وبالنصب على الاستثناء، لأنَّ الكلام تَامٌّ منفي. قال تعالى: {لا يَستوي القاعدون من المؤمنينَ، غيرُ أولي الضَرر، والمُجاهدون في سبيل اللهِ بأموالهم وأنفُسهم}. قُرئَ (غير) بالرفع، صفةً ل(القاعدون)، وبالجر، صفةً للمؤمنين، وبالنصب على الاستثناءِ. وتقول: (ما جاءَ غيرُ خالدٍ) بالرفع، لأنها فاعل، و (ما رأيتُ غيرَ خالد) بالنصب، لأنها مفعولٌ به، و (مررتُ بغير خالدٍ)، بجرها بحرف الجر. وإنما لم تُنصَب (غير) هنا على الاستثناء لأن المستثنى منه غيرُ مذكورٍ في الكلام، فتفرَّغَ ما كان يعملُ فيه للعمل فيها. واعلم أنه يجوز في (سوى) ثلاثُ لغاتٍ: (سِوى) بكسر السين، و (سُوى) بضمها، و (سَواء) بفتحها معَ المدّ. 6- حُكُم المُستثْنى بِخَلا وعَدَا وحاشا خلا وعدا وحاشا: أفعال ماضيةٌ، ضُمّنت معنى (إلا) الاستثنائية، فاستثنيَ بها، كما يُستثنى بإلاّ. وحكمُ المستثنى بها جوازُ نصبِه وجرّهِ. فالنصبُ على أنها أفعالٌ ماضية، وما بعدَها مفعولٌ به. والجرُّ على أنها أحرفُ جرٍّ شبيهةٌ بالزائدِ، نحو: (جاءَ القومُ خَلا عليّاً، أو عليٍّ). والنصبُ بخلا وعَدا كثيرٌ، والجرُّ بهما قليلٌ. والجرُّ بحاشا كثيرٌ، والنصبُ بها قليلٌ. وإذا جررتَ بهن كان الاسمُ بعدَهنَّ مجروراً لفظاً، منصوباً محلاً على الاستثناءِ. فإن جُعلت أفعالاً كان فاعلها ضميراً مستتراً يعودُ على المُستثنى منه.والتُزِمَ إفرادهُ وتذكيرهُ، لوقوعِ هذهِ الأفعالِ موقعَ الحرف، لأنها قد تضمّنت معنى (إلا)، فأشبهتها في الجمودِ وعَدَمِ التَّصرُّفِ والاستثناءِ بها. والجملةُ إما حالٌ من المستثنى منه، وإما استئنافية. ومن العلماءِ من جعلها أفعالاً لا فاعلَ لها ولا مفعولَ، لأنها محمولةٌ على معنى (إلا)، فهي واقعةٌ موقعَ الحرفِ. والحرفُ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. فما بعدَها منصوبٌ على الاستثناء، حملاً لهذه الأفعال على (إلا). وهو قولٌ في نهاية الحِذقِ والتَّدقيق. (قال العلامة الاشموني في شرح الالفية: (ذهب الفراءُ الى أن (حاشا) فعل، لكن لا فاعل له. والنصب بعده إنما هو بالحمل على (إلا). ولم ينقل عنه ذلك في (خلا وعدا). على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك). قال الصبان في حاشيته عليه: (قوله لا فاعل له، أي ولا مفعول، كما قاله بعضهم. وقوله بالحمل على (إلا) أي. فيكون منصوباً على الاستثناء ومقتضى حمله على (إلا) أنه العامل للنصب فيما بعده) والحق الذي ترتاح إليه النفس أن تُجعل هذه الأدوات: (خلا وعدا حاشا) - في حالة نصبها ما بعدها - إما أفعالاً لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها واقعة موقع الحرف، وإما أحرفاً للاستثناء منقولة عن الفعلية الى الحرفية، لتضمنها معنى حرف الاستثناء كما جعلوها - وهي جارَّةٌ أحرفَ جر، وأصلها الافعال). وإذا اقترنت بخلا وعدا (ما) المصدريةُ، نحو: (جاءَ القوم ما خلا خالداً) وجبَ نصبُ ما بعدَهما، ويجوزُ جره، لأنهما حينئذٍ فعلانِ. و (ما) المصدريّة لا تَسبقُ الحروفَ. والمصدر المؤوَّل منصوبٌ على الحال بعد تقديره باسم الفاعل، والتقديرُ: جاءَ القومُ خالينَ من خالدٍ. (هكذا قال النحاة، وأنت ترى ما فيه من التكلف والبعد بالكلام عن أسلوب الاستثناء. والذي تطمئن إليه النفس أن (ما) هذه ليست مصدرية. وإنما هي زائدة لتوكيد الاستثناء، بدليل أن وجودها وعدمه، في إفادة المعنى، سواء على أن من العلماء من أجاز أن تكون زائدة، كما في شرح الشيخ خالد الأزهري لتوضيح ابن هشام). أما حاشا فلا تَسبقُها (ما) إلا نادراً. وهي تُستعملُ للاستثناءِ فيما ينزَّه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه، تقول: (أهملَ التلاميذُ حاشا سليمٍ)، ولا تقولُ: (صلَّى القومُ حاشا خالدٍ) لأنه لا يتنزَّه عن مشاركة القوم في الصَّلاة. وأما سليم - في المثال الأول، فقد يتنزَّه عن مشاركة غيرهِ في الإهمال. وقد تكون للتَّنزيه دون الاستثناء، فيُجرُّ ما بعدها إما باللام، نحو: (حاشَ للهِ)، وإما بالإضافة إليها، نحو: (حاشَ اللهِ). ويجوز حذفُ ألفها، كما رأيتُ، ويجوز إثباتها، نحو: (حاشا لله) و (حاشا اللهِ). ومتى استُعملت للتّنزيهِ المجرَّدِ كانت اسماً مُرادِفاً للتنزيهِ، منصوباً على المفعوليّة المُطلَقةِ انتصابَ المصدرِ الواقع بدلاً من التلفُّظ بفعلهِ. وهي، إن لم تُضَف ولم تُنوَّن كانت مبنيّةً، لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى. وإن أُضيفت أو نُوّنت كانت مُعرَبةً، لِبُعدِها بالإضافة والتنوينِ من شَبِهٍ الحرف، لأنَّ الحروفَ لا تُضافُ ولا تنوَّنُ، نحو: (حاشَ اللهِ، وحاشا للهِ). وقد تكونُ فعلاً متعدِّياً مُتصرفاً، مثل: (حاشيتهُ أُحاشيهِ)، بمعنى: استثنيتُه أستثنيهِ. فإن سبقتها (ما) كانت حينئذٍ نافيةً. وفي الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: (أُسامة أحبُّ الناسِ إليَّ)، وقال راويهِ: (ما حاشى فاطمةَ ولا غيرَها). وتأتي فعلاً مضارعاً، تقول: (خالدٌ أفضلُ أقرانهِ، ولا أُحاشي أحداً)، أي: لا استثني، ومنه قول الشاعر: ولا أرَى فاعلاً في النَّاس يُشْبِهُهُ وَلا أُحاشِي منَ الأَقوامِ مِنْ أحدِ وإن قلت: (حاشاك أن تكذب. وحاشى زهيراً أن يُهملَ)، فحاشى: فعلٌ ماضٍ بمعنى: (جانبَ) وتقولُ أيضاً: (حاشى لك أن تُهملَ)، فتكون اللام حرفَ جرّ زائداً في المفعول به للتقوية. وإن قلتَ: (أُحاشيك أن تقول غير الحقِّ)، فالمعنى أُنزِّهُك. |
7- حُكْمُ المُستثْنى بِلَيْسَ ولا يَكُون ليس ولا يكونُ: من الأفعال الناقصةِ الرَّافعة للاسم الناصبةِ للخبر. وقد يكونان بمعنى (إلا) الاستثنائية؛ فَيستثنى بهما، كما يُستثنى بها. والمستثنى بعدَهما واجبُ النصبِ، لأنه خبرٌ لهما، نحو: (جاءَ القومُ ليس خالداً، أو لا يكون خالداً). والمعنى: جاءُوا إلا خالداً. واسمُهما ضميرٌ مستتر يعود على المستثنى منه. والخلاف في مرجع الضمير فيهما كالخلاف في مرجعه في (خلا وعدا وحاشا) فراجِعهُ. (هكذا قال النحاة. أما ما تطمئن إليه النفس فان يجعلا فعلين لا مرفوع لهما ولا منصوب، لتضمنهما معنى (إلا) أو يجعلا حرفين للاستثناء، نقلاً لهما عن الفعلية إلى الحرفية، لتضمنهما معنى (إلا) كما جعل الكوفيون (ليس) حرف عطف إذا وقعت موقع (لا) النافية العاطفة، نحو: خذ (الكتابَ ليس القلمَ)، وكما قال الشاعر: (والأشرم المطلوبُ ليس الطالبُ). برفع (الطالب) عطفاً بليس على (المطلوب) أي: (الأشرمُ الطالب لا المطلوب). 8- شِبْهُ الاستِثناء شبهُ الاستثناء يكون بكلمتين: (لا سِيَّما) و (بيدَ): فلا سِيّما: كلمةٌ مُركَّبةٌ من (سِيّ) بمعنى مثلٍ، ومُثناها سِيّانِ، ومن (لا) النافيةِ للجنس، وتُستعمل لترجيح ما بعدَها على ما قبلها. فإذا قلتَ: (اجتهدَ التلاميذُ، ولا سِيّما خالدٍ)، فقد رَجَّحْتَ اجتهادَ خالدٍ على غيرهِ من التلاميذ. وتشديد يائها وسَبقُها بالواوِ و (لا)، كلُّ ذلك واجب. وقد تُخففُ ياؤها. وقد تُحذَف الواو قبلها نادراً. وقد تُحذفُ (ما) بعدَها قليلاً. أما حذفُ (لا) فلم يَرد في كلام من يُحتج بكلامهِ. والمُستثنى بها، إن كان نكرةً جازَ جَرُّهُ ورَفعُه ونَصبُهُ. تقول: (كلُّ مجتهدٍ يُحَبُّ، ولا سيّما تِلميذٍ مثلِكَ) أو (ولا سيّما تلميذٌ مِثلَك)، أو (ولا سِيّما تلميذاً مثلَك). وجرُّهُ أَولى وأكثرُ وأشهرُ. (فالجر بالإضافة إلى (سيّ) وما: زائدة. والرفع على أنه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. وتكون (ما): اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى (سي). وجملة المبتدأ والخبر: صلة الموصول. ويكون تقدير الكلام: (يُحَبُّ كل مجتهد لا مثل محبة الذي هو تلميذٌ مثلك، لأنك مُفصَّلٌ على كل تلميذ) والنصب على التمييز لسي، وما: زائدة). وإن كان المُستثنى بها معرفةً جازَ جَرُّه، وهو الأولى، وجاز رفعهُ، نحو: (نجحَ التلاميذُ ولا سِيّما خليلٍ) أو (ولا سِيّما خليلٌ). ولا يجوزُ نصبُهُ، لأن شرطَ التّمييز أن يكونَ نكرةً. وحكمُ (سِيّ) أنها، أن أُضيفت (كما في صورَتي جرَّ الاسم ورفعه بعدَها) فيه مُعرَبةٌ منصوبةٌ بلا النافية للجنس، كما يعرَبُ اسم (لا) في نحو: (لا رجلَ سوءٍ في الدار). وإن لم تُضَف فهي مبنيّةٌ على الفتح كما يُبنى اسم (لا) في نحو: (لا رجلَ في الدار). وقد تستعمل (لا سِيّما) بمعنى (خُصوصاً)، فيُؤتى بعدَها بحالٍ مُفردَةٍ، أو بحالٍ جُملةٍ، أو بالجملة الشرطية واقعةً موقعَ الحال. فالأول نحو: (أُحِبُّ المطالعةَ، ولا سِيّما منفرداً). والثاني نحو: (أُحبُّها، ولا سِيّما وأنا منفردٌ). والثالثُ نحو: (أُحبُّها، ولا سِيّما إن كنتُ منفرداً). وقد يَليها الظَّرفُ، نحو: (أُحبُّ الجلوسَ بين الغِياضِ، ولا سِيّما عند الماءِ الجاري)، ونحو: (يَطيبُ ليَ الاشتغالُ بالعلم، ولا سِيّما ليلاً)، أو (ولا سِيّما إذا أَوَى الناسُ إلى مضاجعهم). [الغياض: جمع غيضة وهو مكان يجتمع فيه الماء فتنبت الأشجار [لسان العرب]] أمّا (بَيدَ فهو اسمٌ ملازمٌ للنّصب على الاستثناءِ). ولا يكون إلا في استثناءٍ منقطع. وهو يَلزَمُ الإضافةَ إلى المصدر المؤوَّلِ بأنَّ التي تنصبُ الاسمَ وترفُ الخبرَ، نحو: (إنهُ لكثيرُ المال، بيدَ أنه بخيل). ومنه حديثُ: (أنا أفصَحُ من نطقَ بالضادِ، بَيدَ أني من قُرَيشٍ، واستُرضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بَكرٍ). |
( المنادى )
المنادَى: اسمٌ وقعَ بعدَ حرفٍ من أَحرف النداءِ، نحو: (يا عبدَ الله). وفي هذا البحث أربعةَ عشرَ مبحثاً: 1- أَحرُفُ النِّداءِ أحرفُ النداءَ سبعة، وهيَ: (أَ، أَيْ، يا، آ، أَيا، هَيا، وَا). فـ (أَيْ و أَ): للمنادَى القريب. و (أيا وهَيا وآ): للمنادى البعيد. و (يا): لكلّ مُنادًى، قريباً كان، أو بعيداً، أو مُتوسطاً. و (وا): للنُّدبة، وهي التي يُنادَى بها المندوبُ المُتفجَّعُ عليه، نحو: (وا كبدِي!. وا حَسرتي!). وتَتعيَّنُ (يا) في نداءِ اسمِ اللهِ تعالى، فلا يُنادَى بغيرها، وفي الاستغاثة، فلا يُستغاثُ بغيرِها. وتتعيَّنُ هيَ و (وَا) في النُّدبة، فلا يُندَُ بغيرهما، إلا أنَّ (وا" - في النُّدبة - أكثرُ استعمالاً منها، لأنَّ (يا) تُستعمل للنُّدبة إذا أُمِنَ الالتباسُ بالنداءِ الحقيقيِّ، كقوله: حُمِّلْتَ أَمراً عَظيماً، فاصطَبَرْتَ لَهُ وقُمْتَ فيهِ بِأَمْرِ اللهِ يا عُمَرَا! [البيت لجرير يندب عمر بن عبد العزيز، رضوان الله عليه. والمراد بالأمر الذي حمله هو الخلافة.] 2- أَقسامُ المُنادى وأَحكامُهُ المنادَى خمسةُ أقسامٍ: المفردُ المعرفةُ، والنكرةُ المقصودة، والنكرةُ غيرُ المقصودة، والمضافُ، والشبيهُ بالمضافِ. (والمراد بالمفرد والمضاف والشبيه به: ما أريد به في باب (لا) النافية للجنس، فراجعه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والمراد بالنكرة المقصودة: كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقُصد تعيينه، وبذلك يصير معرفة. لدلالته حينئذ على مُعّين. راجع مبحث المعرفة والنكرة في الجزء الأول من هذا الكتاب). وحكمُ المنادَى أنهُ منصوبٌ، إمّا لفظاً، وإمّا مَحَلاً. وعاملُ النَّصب فيه، إمّا فعلٌ محذوفٌ وجوباً، تقديرُهُ: (أَدعو)، نابَ حرفُ النداءِ منَابَهُ، وإمّا حرفُ النداءِ نفسُهُ لتَضمنهِ معنى (أَدعو)، وعلى الأول فهو مفعولٌ به للفعل المحذوف، وعلى الثاني فهو منصوب بـ (يا) نفسِها. فيُنصَبُ لفظاً (بمعنى أنهُ يكونُ مُعرَباً منصوباً كما تُنصب الأسماءُ المُعربَةُ) إذا كان نكرةً غيرَ مقصودةٍ، أو مُضافاً، أو شبيهاً به، فالأول نحو: (يا غافلاً تنبّهْ)، والثاني نحو: (يا عبدَ اللهِ)، والثالثُ نحو: (يا حسناً خُلُقُهُ). ويُنصبُ محلاً (بمعنى أنهُ يكونُ مبنياً في محلِّ نصب) إذا كان مفرداً معرفةً أو نكرةً مقصودةً، فالأولُ نحو: (يا زُهيرُ)، والثاني نحو: (يا رجلُ). وبناؤه على ما يُرفَعُ بهِ من ضمَّةٍ أو ألفٍ أو واوٍ، نحو: (يا علي. يا موسى. يا رجلُ. يا فَتى. يا رجلانِ. يا مجتهدونَ. [ موسى: منادى مفرد مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر؛ فتى: منادى نكرة مقصودة بالنداء، مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر؛ رجلان: منادى نكرة مقصودة، مبني على الألف لأنه مثنى؛ مجتهدون: منادى نكرة مقصودة، مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم] بعض أحكام للمنادى المبني المستحق البناء أ- إذا كان المنادَى، المُستحقُّ للبناء، مبنيّاً قبلَ النداءِ، فإنهُ يبقى على حركة بنائهِ. ويقالُ فيه: إنهُ مبنيٌّ على ضمَّةٍ مُقدَّرةٍ، منعَ من ظهورها حركةُ البناءِ الأصليَّةُ، نحو: (يا سيبويهِ. يا حَذامِ. يا خَباث. يا هذا. يا هؤلاء). ويظهر أثرُ ضمِّ البناءِ المقدَّر في تابعه، نحو: (يا سيبويهِ الفاضلُ. يا حذامِ الفاضلةُ. يا هذا المجتهِدُ. يا هؤلاءِ المجتهدون). [سيبويه وحذام: كلاهما منادى مفرد معرفة، مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة البناء الأصلية. وحذام من أعلام الإناث؛ خباث: منادى نكرة مقصودة، إعرابها كإعراب حذام وهي من كلمات الشتم للإناث] ب- إذا كان المنادَى مفرداً علماً موصوفاً بابنٍ، ولا فاصلَ بينهما، والابنُ مضافٌ إلى علَمٍ، جاز في المُنادى وجهانِ: ضمُّهُ للبناءِ ونصبُهُ، نحو: (يا خليلُ بنَ أحمدَ. ويا خليلَ بنَ أحمدَ). والفتحُ أولى. أمّا ضمُّهُ فعلى القاعدةِ، لأنه مفردٌ معرفةٌ. وأما نصبُهُ فعلى اعتبارِ كلمة (ابن) زائدةً، فيكونَ (خليل) مضافاً و (أحمد) مضافاً إليه. وابنُ الشخص يُضافُ إليه، لمكان المناسبة بينهما. والوصف بابنةٍ كالوصفِ بابنٍ، نحو: (يا هندَ ابنةَ خالدٍ. ويا هندُ ابنةَ خالد). أمّا الوصفُ بالبنت فلا يُغيّر بناءَ المفرد العَلَم، فلا يجوزُ معَها إلا البناءُ على الضمِّ، نحو: (يا هندُ بنتَ خالدٍ). ويتَعيَّنُ ضَمُّ المنادى في نحو: (يا رجلُ ابنَ خالدٍ. ويا خالد ابنَ أَخينا) لانتفاءِ عَلَميَّةِ المنادَى، في الأول، وعَلَميَّةِ المضافِ إلى ابنِ في الثاني، لأنك، إن حذفتَ ابناً، فقلتَ: (يا رجلَ خالدٍ، ويا خالدَ أخينا)، لم يبق للإضافة معنًى. وكذا يَتعيّنُ ضمُّهُ في نحو: (يا عليٌّ الفاضلُ ابنَ سعيد)، لوجود الفَصل، لأنه لا يجوزُ الفصلُ بينَ المضافِ والمضاف إليه. ج-إذا كُرِّرَ المنادى مضافاً، فلك نصب الاسمينِ معاً، نحو: (يا سعدَ سعدَ الأوس)، ولكَ بناءُ الأول على الضم، نحو: (يا سعدُ سعدَ الأوس). أما الثاني فهو منصوب أبداً. (أما نصب الأول، فعلى أنه مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني زائد للتوكيد، لا أثر له في حفض ما بعده. أو على أنه مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف اليه الثاني. وأما بناؤه (أي بناء الأول) على الضم، فعلى اعتباره مفرداً غير مضاف. وأما نصب الثاني، فلأنه على الوجه الأول توكيد لما قبله، وعلى الوجه الثاني بدلٌ من محل أو عطف بيان). د- المنادَى المُستحقُّ البناءِ على الضمّ، إذا اضطُرَّ الشاعر إلى تنوينه جازَ تنوينُهُ مضموناً أو منصوباً. ويكونُ في الحالة الأولى مَبنيّاً، وفي الثانيةِ مُعرباً منصوباً كالعلم المضاف، فمن الأول قول الشاعر: سَلامُ الله يا مَطَرٌ عَلَيْها وَلَيْس عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلامُ [ مطر الثانية: اسم رجل] وقولُ الآخر يخاطب جَمَله: حَيَّيْتكَ عَزَّةُ بَعْدَ الهَجْرِ وَانصَرَفَتْ فَحَيّ، وَيْحَكَ، مَنْ حَيَّاكَ، يا جَمَلُ لَيْتَ التَّحِيَّةَ كانَتْ لِي، فَأَشْكرَها، مَكانَ يا جَمَلٌ: حُيِّيتَ يا رَجُلُ ومن الثاني قول الشاعر: ضَرَبَتْ صَدْرَها إليَّ وقالتْ: يا عَيدِيّاً، لَقَدْ وَقَتْكَ الأَواقي [الأواقي: جمع واقية] ومن العلماءِ من اختارَ البناءَ، ومنهم من اختارَ النصبَ، ومنهم من اختارَ البناءَ مع العَلَمِ، والنصبَ مع اسم الجنس. فائدة إذا وقعَ (ابنٌ) أو (ابنةٌ) بينَ علَمينِ - في غير النداء - وأُريدَ بهما وصفُ العَلَم، فسبيلُ ذلكَ أن لا يُنوَّنَ العلَمُ قبلهما في رفع ولا نصبٍ ولا جرّ، تخفيفاً، وتُحذَفُ همزةُ (ابن) تقولُ: (قالُ عليٌّ بنُ أبي طالب. أُحب عليَّ بنَ أبي طالب. رَضي اللهُ عن عليٍّ بن أبي طالب). |
3ـ نِداءُ الضَّمير
نداءُ الضمير شاذ نادرُ الوقوع في كلامهم. وقصَرَهُ ابنُ عُصفور على الشعر. واختار أبو حيّانَ أنهُ لا ينادَى البَتَّةَ. والخلاف إنما هو في نداءِ ضمير الخطاب. أمّا نداءُ ضميريِ التكلم والغَيبة، فاتفقوا على أنهُ لا يجوز نداؤهما بَتَّةً، فلا يُقال: (يا أنا. يا إيّايَ. يا هُوَ. يا إيّاهُ). وإذا ناديتَ الضمير، فأنتَ بالخيار: إن شئتَ أتيتَ به ضميرَ رفعٍ أو ضمير نصبٍ، فتقولُ: (يا أنت. يا إياك). وفي كِلتا الحالتينِ، فالضميرُ مبني على ضم مُقدَّر، وهو في محل نصب، مِثلَه في(يا هذا، ويا هذهِ، ويا سِيبَويهِ)، لأنه مُفَردٌ معرفة. 4- نِداءُ ما فيهِ "أَلْ" إذا أريْدَ نداءُ ما فيه (أَلْ)، يُؤتى قبلَهُ بكلمةِ (أيُّها) للمذكر، و (أَيّتُها) للمؤنث. وتَبقيانِ معَ التثنيةِ والجمع بلفظ واحدٍ، مراعىً فيهما التذكيرُ والتأنيث، أو يؤتى باسم الإشارة. فالأول كقوله تعالى: {يا أيُّها الإنسانُ ما غَرَّكَ بربّكَ الكريم؟} وقوله: {يا أيتُها النفسُ المُطمَئِنّةُ، ارجعي إلى ربكِ راضيةً مرضِيّةً} وقوله: {يا أيُّها الناسُ اتَّقوا ربَّكم}. والثاني نحو: (يا هذا الرجل. يا هذهِ المرأةُ) إلا إذا كان المنادى لفظَ الجلالة. لكن تبقى (ألْ) وتُقطَعُ همزتُها وُجوباً، نحو: (يا ألله). والأكثر معَهُ حذفُ حرفِ النداءِ والتعويضُ منه بميمٍ مُشدَّدةٍ مفتوحةٍ، للدلالةِ على التعظيم نحو: (اللهمَّ ارحمنا). ولا يجوز أن تُوصَفَ (اللهمَّ)، على اللفظ ولا على المحلِّ، على الصحيح، لأنهُ لم يُسمَع. وأما قولهُ تعالى: {قُلِ: اللهمَّ، فاطرَ السمواتِ والأرض }، فهو على أنه نداءٌ آخرُ، قُل: اللهمَّ، يا فاطرَ السمواتِ. وإذا ناديتَ علماً مُقترِناً بألْ وَضعاً حذفتَها وُجوباً فتقولُ في نداء العبّاسِ والفضلِ والسّموأَلِ: (يا عبّاسُ. يا فضلُ. يا سَمَوأَلُ). فائدة تستعمل (اللهمَّ) على ثلاثة أنحاء: (الأول): أن تكون للنداء المحض، نحو: (اللهمَّ اغفر لي). (الثاني): أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع، كأن يقال لك: (أخالد فعل هذا؟)، فتقول: (اللهم نعم). (الثالث): أن تستعمل للدلالة على الندرة وقلة وقوع المذكور معها، كقولك للبخيل: (إن الأمة تعظمك، اللهم إن بذلت شطراً من مالك في سبيلها). 5- أَحكامُ تَوابعِ المُنادَى إن كن المنادى مبنياً فتابعُهُ على أربعة أضرُبٍ: أ- ما يجبُ رفعُهُ معرَباً تَبَعاً لِلَفظِ المنادى. وهو تابعُ (أيّ وأيَة واسمِ الإشارة)، نحو: (يا أيها الرَّجلُ. يا أيتها المرأةُ. يا هذا الرجلُ. يا هذهِ المرأةُ). ولا يُتبَعُ اسمُ الإشارةِ أبداً إلا بما فيهِ (ألْ). ولا تُتبَعُ (أيُّ وأيّةٌ) في باب النداءِ، إلا بما فيه (أَلْ) - كما مُثِّلَ - أو باسم الإشارة، نحو: (يا أيُّهذا الرجلُ). ب- ما يجبُ ضَمهُ للبناءِ، وهوَ البدَلُ، والمعطوفُ المجرَّدُ من (أَلْ) اللَّذانِ لم يضافا، نحو: (يا سعيدُ خليلُ. يا سعيدُ وخليلُ). ج- ما يجبُ نصبُهُ تبعاً لمحلِّ المنادَى، وهو كلُّ تابعٍ اضيف مُجرَّداً من (أَل)، نحو: (يا علي أبا الحسن. يا علي وأبا سعيد. يا خليلُ صاحبَ خالدٍ. يا تلاميذُ كلَّهُمْ، أو كلَّكُم. يا رجلُ أبا خليلٍ). د- ما يجوز فيه الوجهان: الرفعُ مُعرَباً للفظِ المنادَى، والنصبُ تبعاً لمحلِه وهو نوعان: الأول: النعتُ المضافُ المقترنُ بألْ، وذلك يكون في الصفاتِ المُشتقَّةِ المضافة الى معمولها، نحو: (يا خالدُ الحسنُ الخلُقِ، أو الحسنَ الخلق. يا خليلُ الخادمُ الأمةِ، أَو الخادمَ الأمة). الثاني: ما كان مُفرَداً من نعتٍ، أو توكيدٍ، أو عطفِ بيانٍ، أو معطوفٍ مُقترنٍ بألْ، نحو: (يا عليّ الكريمُ، أو الكريمَ. يا خالدٌ خالدٌ، أو خالداً. يا رجلُ خليلٌ، أو خليلاً. يا عليّ والضيفُ، أو والضيفَ)، ومن العطفِ بالنصبِ تبعاً لمحلِّ المنادى قوله تعالى: {يا جبالُ أَوّبي معهُ والطّيرَ}، وقُرئ في غيرِ السبعةِ: (والطيرُ)، بالرفع عطفاً على اللفظ. [في يا خالدٌ خالدٌ: الثانية تأكيد لخالد المنادى، فإن رفعته فهو توكيد للفظه، وإن نصبته كان عطف بيان على محله من الإعراب] وان كان المنادَى مُعرَباً منصوباً فتابعُهُ أبداً منصوبٌ مُعرباً، نحو: (يا أَبا الحسنِ صاحبَنا. يا ذا الفضل وذا العلم. يا أبا خالدٍ والضيفَ)، إلا إذا كان بدَلاً، أو معطوفاً مجرداً من (ألْ) غيرَ مضافين، فهما مَبنيّان، نحو: (يا أبا الحسن عليٌّ. يا عبدَ الله وخالدُ). 6- حَذْفُ حَرْفِ النِّداءِ يجوزُ حذفُ حرفِ النداءِ بكثرةٍ، إذا كان (يا) دونَ غيرِها، كقولهِ تعالى: {يوسفُ، أَعرِضْ عن هذا}، وقولهِ: {رَبِّ أَرِني أَنظُرْ إليكَ} ونحو: (مَنْ لا يزالُ مُحسناً أحسنْ إليَّ، واعظَ القومِ عِظهُمْ. أَيُّها التلاميذُ اجتهدوا. أَيتُها التلميذاتُ اجتهِدْنَ). ولا يجوزُ حذفُهُ من المنادى المندوبِ والمنادَى المُستغاث والمنادى المتعجَّبِ منه والمنادى البعيد، لأنَّ القصدَ إطالةُ الصوتِ، والحذفُ يُنافيهِ. وقلَّ حذفُهُ من اسم الإشارة، كقول الشاعر: إذا هَمَلَتْ عَيْني لَها قالَ صاحبي: بِمثْلِكَ، هذا، لَوْعَةٌ وغَرامُ؟! ومن النكرة المقصودة بالنداءِ كقولهم: (إفتَد مخنوقُ. أصبح ليلُ) [هو مثلٌ يُضرب لكل مشفَقٍ عليه مضطر وقع في شدة وهو يبخل على نفسه أن يفتديها بماله. أي: يا مخنوق افتد نفسك... أصبح ليل: مثل يضرب لليلة شديدة، ولأمر مكروه طال أمده] ومنه قول الشاعر: جَارِيَ، لا تَسْتَنْكري عَذِيري: سَيْرِي وإِشْفاقِي على بَعيري [ يقول لجاريته لا تعيبي علي سيري رحمة ببعيري] وقولُ الآخر: أَطرِقْ كرا، أَطرِقْ كرا إنَّ النَّعَامَ في الْقُرَى [هو مثل يُضرب لمن يُتكلم أمامه بكلام فيظن أنه المراد بالكلام، أي: اسكت يا حقير فإني أريد بالكلام من هو أنبل منك. مقارنة بين الكرا وهو طائر لا يساوي شأناً أمام النعام] وأقل من ذلك حذفُهُ من النكرة غير المقصودة ومن المشبّه بالمضاف. |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.