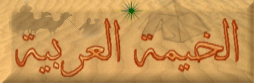
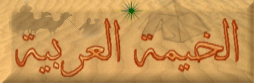 |
صورة الآخر .. العربي ناظرا ومنظورا إليه
صورة الآخر .. العربي ناظرا ومنظورا إليه
في كثير من الأحيان، يتطير البعض عندما يتم ذكر (الآخر) كمؤثر على سلوك المتكلم أو المحلل، فردا أو جماعة أو مذهبا، فيتصدى البعض لمسألة استخدام الآخر في الحديث أو الكتابة، باعتبار أن هذا المصطلح مستورد من الأجنبي، ويحشر في ثقافتنا حشرا غير مبررا .. وقد لاحظت ذلك في كثير من مداخلات البعض، عندما يرد مصطلح الآخر في مقالة أو تحليل لمسألة ما .. في الفترة بين 29و 31/3/1993 عقدت الجمعية العربية لعلم الاجتماع ندوة حول (صورة الآخر) في مدينة الحمامات في تونس، كانت من دون شك أول لقاء علمي متخصص في البلدان العربية يتناول هذا الموضوع ويتداول اشتقاق (الآخرية) عوضا عن (الغيرية) .. وقد اشترك بهذه الندوة علماء عرب وأجانب، تناول الجميع فيها مجالات شتى .. وبعد أكثر من ثلاث سنوات وبالتحديد بين 15 و 17/11/1996 تم عقد ندوة للمختصين العرب (فقط) للإجابة عن تساؤل كيف يرى العرب الآخرين؟ وقد قام الدكتور لبيب طاهر (رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع) بتجميع بحوث ومساهمات العلماء العرب والأجانب في الندوتين وحررها في كتاب يقع في 956 صفحة من القطع المتوسط وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم الاجتماع وقد بوبه في ستة أقسام : القسم الأول: في مسألة الآخرية الفصل الأول: الآخر بما هو اختراع تاريخي .. قدمه : جان فارو ـ باحث فرنسي الفصل الثاني: مفهوم ومواريث (العدو) في ضوء عملية التوحيد والسياسات الأوروبية .. قدمه: فيلهو هارلي من دائرة العلوم السياسية ـ جامعة جيفسكيلا ـ فنلندا . الفصل الثالث: الاستشراق والاستغراب : اختراع الآخر في الخطاب الأنثروبولوجي .. قدمه: منذر الكيلاني : أستاذ في جامعة لوزان ـ سويسرا الفصل الرابع: العنصرية: منطق الإقصاء العام .. قدمه: جاك ماهو : باحث بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRC باريس . الفصل الخامس: الآخر أو الجانب الملعون قدمته: أسماء العريف بياتريكس : باحثة تونسية ـ باريس الفصل السادس: الآخر : المفارقة الضرورية .. قدمته : دلال البزري .. أستاذة في الجامعة اللبنانية ـ صيدا الفصل السابع: صورة الآخر المختلف فكريا: سوسيولوجيا الاختلاف والتعصب .. قدمه : حيدر ابراهيم علي : مدير مركز الدراسات السودانية في القاهرة وأمين عام الجمعية العربية لعلم الاجتماع .. الفصل الثامن: صورة الآخر في العلاقة: مواطن/أجنبي .. ملاحظات أولية .. قدمه: بيار باولو دوناتي : أستاذ في جامعة بولونيا ـ إيطاليا الفصل التاسع: ما بعد الأحكام المسبقة .. قدمه: روبارتو سيبرياني و ماريا مانسي .. أستاذان في جامعة روما .. الفصل العاشر: صورة الآخرين كخلفية لتصور الذات في المجتمع الروسي .. قدمته: آنا أندرينكوفا : أستاذة في معهد البحوث المقارنة ـ موسكو الفصل الحادي عشر: الإنسان والزمن ـ الآخر .. الزمن بين أسياده وعبيده .. قدمه: جيندريخ فيليباك .. أستاذ في جامعة براغ ـ تشيكيا الفصل الثاني عشر: أصل الشغف بالآخر لدى حركات الأنتلجنسيا الطلائعية في أوروبا.. قدمه: جوزي أنطونيو غونزاليس آلكنتود.. مدير مركز البحوث الإثنولوجية في جامعة غرناطة ـ إسبانيا .. القسم الثاني: ما وراء الحدود: نظرة العرب الى الآخر .. الفصل الثالث عشر: الآخر في الثقافة العربية .. قدمه الطاهر لبيب (المحرر للكتاب) الفصل الرابع عشر: صورة الإفريقي لدى المثقف العربي: محاولة تخطيطية لدراسة (ثنائية قبول/استبعاد) .. قدمه: حلمي شعراوي .. مركز البحوث العربية ـ القاهرة . الفصل الخامس عشر: جدل الأنا والآخر: دراسة في تخليص الإبريز للطهطاوي .. قدمه: حسن حنفي : أستاذ ورئيس قسم الفلسفة ـ جامعة القاهرة. الفصل السادس عشر: صورة الآخر من خلال تقارير الرحلات السفارية المغربية الى أوروبا.. قدمه: عبد السلام حيمر ..أستاذ في جامعة مكناس/ المغرب الفصل السابع عشر: أثر الصورة الذاتية في الموقف العربي من دولة إسرائيل .. قدمه: مهنا يوسف حداد..أستاذ في جامعة اليرموك/الأردن الفصل الثامن عشر: صورة الإسرائيلي لدى المصري بين ثقافة العامة والدراما التلفزيونية.. قدمه: عبد الباسط عبد المعطي.. رئيس قسم علم الاجتماع بكلية البنات /جامعة عين شمس ـ القاهرة الفصل التاسع عشر: الذات العربية المتضخمة: إدراك الذات المركز والآخر الجواني .. قدمه: سالم ساري أستاذ في جامعة فيلادلفيا/ الأردن الفصل العشرون: تونس والعالم: موقف الشباب التونسي من البلدان الأخرى.. قدمه: ميخائيل سليمان .. أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كنساس الفصل الحادي والعشرون: البعد الجغرافي وصورة الآخر: مقاربة أمبيرقية .. قدمه: مصطفى عمر التير .. أستاذ في جامعة الفاتح ـ طرابلس ـ ليبيا القسم الثالث: ما وراء الحدود: نظرة الآخر الى العرب.. الفصل الثاني والعشرون: العلوم الاجتماعية والاستشراق : صورة المجتمع العربي الإسلامي.. قدمه: محمد نجيب بوطالب أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس الفصل الثالث والعشرون: الفلاحون المغاربة في الإثنولوجيا الكولونيالية: بين الجمود وقابلية التحسن .. قدمه عبد الجليل حليم.. أستاذ بجامعة مكناس/المغرب الفصل الرابع عشر: صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية.. قدمته: مارلين نصر.. باحثة من لبنان الفصل الخامس والعشرون: اليهود والعرب: صورة الآخر وآثار المرآة .. تقديم: ريجين عزرية : باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRC باريس . الفصل السادس والعشرون: الكنيسة الكاثوليكية والإسلام .. تقديم: آنزو باتشي .. أستاذ في جامعة بادوفا ـ إيطاليا الفصل السابع والعشرون: المغرب العربي في رؤية بلدان الشمال.. تقديم: تيومو ميلازيو .. باحث في معهد العلوم حول السلم ـ فنلندا الفصل الثامن والعشرون: في معضلة الباحث ووضع البحث في العلوم الاجتماعية حول العالم العربي في الجامعة الفرنسية.. تقديم: اليزابيث لونغنس .. باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRC باريس . الفصل التاسع والعشرون: صورة الآخرين: المخاوف الحقيقية والكاذبة في العلاقات العربية ـ الأوروبية .. تقديم: سيغوردن سكيرباك .. أستاذ في جامعة أوسلو النرويج الفصل الثلاثون: ماضي الأقليات العربية والمسلمة في بولونيا: المرآة والوعي الذاتي .. تقديم: توماس مارسينياك .. أستاذ في أكاديمية العلوم ـ بولندا الفصل الحادي والثلاثون: صورة الآخر: حالة المجر .. تقديم: ميكلوس هاداس .. أستاذ في جامعة بودابست للعلوم الاقتصادية ـ المجر الفصل الثاني والثلاثون: صور الإسلام في اليابان: الماضي والحاضر.. تقديم: أيري طامورا .. أستاذ بالجامعة الدولية ـ طوكيو يتبع |
القسم الرابع: ما بين الحدود: المهاجر العربي الفصل الثالث والثلاثون: الآخر في فرنسا المعاصرة: العربي كبش الفداء .. تقديم: روبار شارفان .. أستاذ في جامعة نيس ـ فرنسا الفصل الرابع والثلاثون: صورة الآخر في النزاع العرقي.. تقديم: فيكتوريو كوتاستا ..أستاذ في جامعة سالارنو ـ إيطاليا الفصل الخامس والثلاثون: معاينة أزمة معلنة: صورة الذات وصورة الآخر أثناء حرب الخليج .. تقديم: آني بينفينيست .. أستاذة في جامعة باريس .. الفصل السادس والثلاثون: وجهات نظر المغاربة والأفارقة في فرنسا، بالفرنسيين .. تقديم: ماري ـ جوزيف باريزاي .. باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRC باريس . الفصل السابع والثلاثون: التفاعلات الاجتماعية بين الإيطاليين والمغاربة في ميلانو .. تقديم: وكلوديو بوسي .. أستاذة في جامعة ميلانو ـ إيطاليا القسم الخامس: داخل الحدود: الاختلاف والتراتب الفصل الثامن والثلاثون: الآخرية والتراتب .. تقديم: علي الكنز .. أستاذ في جامعة نانت ـ فرنسا الفصل التاسع والثلاثون: الذات الممزقة بين الأنا والآخر .. تقديم: عروس الزبير .. أستاذ في جامعة الجزائر الفصل الأربعون: صور الآخرين في لحظات الحرب اللبنانية: معاينات مونوغرافية .. تقديم: أحمد بعلبكي .. أستاذ في الجامعة اللبنانية ـ بيروت الفصل الحادي والأربعون: الرفض المتبادل بين الطوائف اللبنانية: صورة الأنا والآخر في الحرب الأهلية (1975ـ 1990) .. تقديم: مسعود ضاهر .. أستاذ في الجامعة اللبنانية ـ بيروت الفصل الثاني والأربعون: الآخر العربي والآخر الفلسطيني في نظر الفلسطينيين في إسرائيل .. تقديم: عزيز حيدر .. أستاذ بجامعة بير زيت ـ فلسطين الفصل الثالث والأربعون: الفلسطيني والعربي والإسرائيلي في نظر الطلبة الجامعيين في فلسطين .. تقديم: محمود ميعاري .. أستاذ بجامعة بير زيت ـ فلسطين الفصل الرابع والأربعون: "العوام" و"الأفندي" في مصر: دراسة في آليات الشك المتبادل.. تقديم: علي فهمي.. باحث مصري الفصل الخامس والأربعون: المرأة ك "آخر" : دراسة في هيمنة التنميط الجنساني على مكانة المرأة في المجتمع الأردني .. تقديم: حلمي خضر ساري .. أستاذ في قسم الاجتماع ـ الجامعة الأردنية الفصل السادس والأربعون: الرجل ـ المرأة: انعكاس أم انكسار؟ صورة الرجل من خلال أقوال المرأة وفانتزماتها .. تقديم: ماري ـ تيراز خيري بدوي .. أستاذة في جامعة القديس يوسف ـ بيروت القسم السادس : عبر الحدود : آخر الأدب والفن الفصل السابع والأربعون: صورة (الأخرى) في الرواية العربية: من نقد الآخر الى نقد الذات .. في أصوات سليمان فياض.. تقديم: جورج طرابيشي .. كاتب ومفكر عربي .. الفصل الثامن والأربعون: صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي: تحليل سوسيولوجي لرواية (محاولة للخروج) .. تقديم: فتحي أبو العينين ..أستاذ في جامعة عين شمس ـ القاهرة الفصل التاسع والأربعون: الطريق الى الآخر يمر بالذات: نموذج من أعمال يوسف إدريس.. تقديم: محمد حافظ دياب .. أستاذ بجامعة بنها ـ مصر الفصل الخمسون: رؤية مصرية لصورة اليهودي في أدب إحسان عبد القدوس .. تقديم: رشاد عبد الله الشامي ..أستاذ في جامعة عين شمس ـ القاهرة الفصل الحادي والخمسون: صورة الآخر في رواية المهدي لكونيل .. تقديم: أبو بكر أحمد باقادر .. أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة الفصل الثاني والخمسين: الأصوات الغربية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: حالة الأدب الشعبي .. تقديم: توان فان تيفلين .. أستاذة بجامعة أمستردام الفصل الثالث والخمسون (الأخير): التعامل مع الماضي وخلق الحضور: صور فلسطين البريدية .. تقديم: أنليس موريس .. أستاذة بجامعة أمستردام ـ هولندا و استيفن فاشلين (مؤرخ ومصور هولندي) .. ملاحظة: نعلم أن هذا الكتاب الذي استغرق جمعه وتحريره بشكله المطروح في الأسواق أكثر من سبع سنين، أنه من الصعوبة بمكان تطويعه ليصبح بمتناول المثقفين الذين لا يتعاملون مع كتب بهذا الحجم .. ونعلم أن كل فصل منه يصلح أن يكون موضوعا ذو حلقات .. ونعلم أن اختصار الكتاب بمواده الدسمة والكثيرة المتنوعة سيفقده كثيرا من دقة معلوماته .. ولكن المساهمة في تقديمه أو تقديم بعض مواده بالطريقة التي يمكن احتمالها في الشبكة العنكبوتية لن يخلو من فائدة .. سائلا الله أن يبقي الرغبة في إنجاز هذا العمل موجودة .. وحبذا لو ساعدني من يملك نسخة من هذا الكتاب في تحقيق تقديمه بالصورة التي توسع من دائرة المطلعين عليه .. |
القسم الأول: في مسألة الآخرية
الفصل الأول: الآخر بما هو اختراع تاريخي .. قدمه : جان فارو ـ باحث فرنسي يبدأ الكاتب مشاركته بتساؤل شرطي عن الآخر، فيشترط حتى يكون هناك آخر وجوب أن يكون (أنا) .. فهي أي (الأنا) هي من ترسم حدود الآخر وتضع مواصفات شكله .. ويتوقع الكاتب في بداية مشاركته أن الإحساس بوجود الآخر بدأ عند الشعوب الأوروبية أو (الهندية الآرية) قبل الميلاد بألف سنة، لكنه لا يتشبث بهذا التوقع الى نهاية المشاركة (وبالمناسبة فإن توقعه صائب حيث أن شعوب بلاد العراق ووادي النيل قد عرفت تلك المسألة قبل الأوروبيين والهندود بحوالي ألفي عام) ليعود ويجعل نشأة هذا الإحساس متزامنة في كل من شعوب جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط مع الإغريق .. وهي نقطة يتمحور عليها التفكير الغربي باعتبار أن الحضارة الأوروبية لها دور مركزي قيادي على صعيد العالم ولم يكن لأي حضارة فضل عليها! لقد ميز الكاتب بين الآخر ل (الأنا) والآخر ل (النحن)، فالآخر للأنا قد يكون أخا أو جارا أو صديقا في عينة من الوقت لكن الآخر ل (النحن) هو من يكون لقبيلته أو شعبه جد وإله مختلف عن جد وإله قبيلة أو شعب (النحن) .. ولقد ضرب عينة من الأمثلة الطريفة التي تدعم وجهة نظره، رابطا إياها بمسألة الوعي .. فقال إن كل منا قد رأى في حياته شجرة، ولكن لو كان الحديث عن شجرة مخصصة فإن السامع سيرسم صورة تلك الشجرة (موضوع الحديث) حسب وعيه للشجرة التي رآها أو انتقى صورة معينة لشجرة رآها .. وهنا توكيد على أن الوعي هو إعادة إنتاج صورة معينة، في حالة الحديث عن الواقع أو الماضي .. يعارض الكاتب الفكرة القائلة بأن الوعي ضروري للتعلم، فيقول أن الوعي بكثير من الحالات يكون كابحا للتعلم .. وهي مسألة يريد أن يفصح عنها الكاتب بأن الصور المعاد إنتاجها عند من يقوم بالوعي تعتمد على (أرشيف) قديم، قد يكون مضللا لمن يحاول التعلم. والنقطة تلك من الأهمية بمكان وقد يكون الكاتب محقا، فالتصور الذي يحمله الأوروبيون عن العرب، تم تغذية ملفاته وفق تطور تاريخي حكمته أسباب ووقائع قد لا ترتبط بالحاضر، أو أنها ترتبط ولكن بصورة مشوهة .. وهذا لا يتوقف على الأوروبيين وحدهم، بل يشملنا نحن ويشمل شعوب الأرض كلها. نحن لا نعرف أجدادنا على وجه الدقة، ولكننا نرسم صورهم البعيدة التي قد تصل آلاف السنين بأشكال نبتكرها في آلية الرسم لتلك الصور .. كذلك لا نعرف سكان الغرب أو سكان العالم فردا فردا، ولكننا نرسم صورتهم وفق آليات لها علاقة بما نحمل من موروث ثقافي يناقشهم كآخرين لنا .. يضع الكاتب مثالا طريفا، عندما يفترض نقاطا بيضاء على لوحة سوداء، لا صلة بينها، نقطة تمثل الأكل والشرب ونقطة تمثل العلاقات العاطفية ونقطة تمثل الحروب والأحداث الحادة ونقطة تمثل المهارات الخ .. فتبدو اللوحة لا معنى لها سواء كانت اللوحة لماضي شعبنا أو حاضر شعوب أخرى نعتبرها (آخر جماعي) لنا .. في حين لو كانت تلك النقاط تمثل إحداثيات (رياضية أو هندسية) فيستطيع عالم الرياضيات أن يضع قوانين لعلاقاتها مع بعض .. يستخلص الكاتب نتيجة أن الوعي بالآخر يتأثر ببعدين (زماني ومكاني) .. وحتى يكون للوعي شروطه اللازمة لفهم ما يدور، وجب الانصياع لقوة جازمة تفرض قانونها وسلطانها على محددات الآخر ل (النحن)، وإلا فإن التضاد والصراع سيطال نشاطات الجماعات لتقوم بتصفية بعضها البعض كما حدث في الصراعات القبلية في إفريقيا (رواندا والكونغو وكينيا وتشاد) أو ما يحصل في أفغانستان أو صراعات عرقية (كما يحصل في مكونات يوغسلافيا السابقة) أو طائفية (كما يحدث في كثير من دول العالم) أو (يُحضر له). ويقترح أن تلك القوة الأنسب هي (الديمقراطية) .. |
شكرا أخي ابن حوران علي الموضوع .
دمت كريما سخيا معطاءا. تحياتي وتقديري والمودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
قرأت وتمتعت واستفدت من هذا العلم تحاياي
|
الأخوان الفاضلان ..
أشكر تفضلكما بالمرور وامتداح الموضوع احترامي و تقديري |
الفصل الثاني: مفهوم ومواريث (العدو) في ضوء عملية التوحيد والسياسات الأوروبية ..
قدمه: فيلهو هارلي من دائرة العلوم السياسية ـ جامعة جيفسكيلا ـ فنلندا . يبدأ الكاتب مشاركته التي خصصها للحالة الأوروبية بشكل خاص، بترجيح الجانب الاقتصادي حيث يقول: ( إن مبدأ التكامل يتحدى العناصر الأساسية للمنطق الواقعي القائل بالحفاظ على نظام الدول ذات السيادة ...) ثم يضع عدة محاور لمشاركته، سنتجاوز بقدر الإمكان ما يتشابه فيها مع من سبقه أولا: مفهوم العدو يذكر الكاتب نماذج فيما قيل بالآخر الذي يتطور الى (عدو) في آخر المطاف، فيذكر ما قاله أرسطو عن الآخر عندما قال : (الآخر المستبعد هو الغريب، الذي لم يتمكن من استخدام وفهم اللغة المشتركة (اليونانية)، ونتيجة لذلك أصبح (البربري) هدفا للمطاردة، أي أصبح عبدا أو يجب استعباده .. ويذكر (في العصر الحديث) ما قاله (ميشال فوكو) إلى إدراك "الآخر" باعتبار أنه شخص غير طبيعي، ومجنون ومعوق .. بينما يذكر ما ذهب إليه (جيمس آهو) بأن ما يميز الأنا عن الآخر هو أن أفراد الأنا ينادون بعضهم بأسمائهم الأولى دون ألقاب أو دون ذكر اسم العائلة .. وهي حميمية غير موجودة في سلوك الآخر .. إن العدو هو صورة للآخر متطورة في خشونتها وأذاها في حين أن الآخر هو في حالة استبعاد عن النحن أو الأنا .. ويميز الكاتب بين صنفين من العدو .. العدو الجدير والعدو الشرير.. فالعدو الجدير هو شريك (آخر) يلتزم بطقوس كما يلتزم فريقان من كرة القدم .. في حين العدو الشرير ليس عنده أي شيء مشترك معنا .. وهنا أطلق (ريغان) اسم إمبراطورية الشر على الاتحاد السوفييتي (سابقا) .. كما أطلق (بوش) محور الشر على دول قد لا يجمعها جامع إلا صفتها الشريرة (في نظر بوش!) . ثانيا: دور "العدو" في الميراث الثقافي الأوروبي ترتبط العبرية والإسلام والبروتستانتية الى الساحة الثقافية للعالم (الأوروبي) وأحيانا يطلق على الفرقاء في هذا التصنيف اسم (العدو المحبوب).. لكن هناك عدو ديني شرير تركز عليه الثقافة الغربية ..[ كلام الكاتب] .. 1ـ الجذور الدينية ل (العدو) نشأت الفكرة الدينية عن "العدو" أي الكفاح الثنائي بين الخير والشر، في إيران القديمة، حيث خلع Zarathustra على مازدا Ahur Mazda (إله النور والإله الحكيم) صفة الإله الواحد الحق، ومع ذلك هنالك مناوأة الروح الشريرة (انغرا ماينيو Angra Mainyu) .. والواقع أن الصراع بين الخير والشر انتقل من مستواه الإلهي الى مستوى الناس .. ليصبح الصراع تاريخيا بين قوى الخير وقوى الشر .. لم يكن هناك تأثير بين (الزرادشتية الإيرانية) واليهودية، إلا بعد السبي لليهود ونقلهم الى العراق، حيث اختلط الفكر الزرادشتي بالفكر اليهودي .. في حين اعتنقت الإمبراطورية الرومانية المسيحية (الممثلة للخير) وتساهلت مع من اعتنقها حتى لو لم يكونوا من الرومان، فقبلت بالبرابرة المعتنقين للمسيحية واصطفوا معها في صراع ضد الشر المتمثل بالفكر اليهودي .. وهنا تطور مفهوم الآخر و العدو .. لم يكتف الرومان بمحاربة أعداء المسيحية الخارجيين بل عمموا عدائهم ليطال الأعداء الداخليين .. وهذا ظهر في القرنين السادس عشر والسابع عشر .. 2ـ الجذور السياسية ل (العدو) في صراعات الأثينيون القدماء على السلطة بين المدن، كان الزعم يدور أن (أيديولوجية) الصراع كانت بين الأثينيون الديمقراطيون المدافعون عن حقوق الفقراء والضعفاء ضد الديكتاتوريين والأغنياء الأقوياء (تبرير إمبريالي لا يزال قائما حتى اليوم) .. ظهرت تلك المزاعم مجددا في العصر الحديث بعد ظهور الاتحاد السوفييتي، واعتماد مقولات العالم الحر وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب .. 3ـ عدو أوروبا تعززت الأنماط الدينية والسياسية كمنهج للتفكير في العدو الذي حاربت أوروبا نشاطه، وقد تمثل في عدة أشكال وسأركز على شكل واحد وهو المشرق (الكاتب) .. لقد ذكر (شيراز دوسا Shiraz Dossa) أن الخط الفاصل بين اليونانيين المتمدنين والشرق (البربري) قد تشكل على يد (هيرودوتس ) مؤرخ الكفاح البطولي ضد الإمبراطورية الفارسية .. وقد كرس المؤرخون والفلاسفة تلك الفواصل فيما بعد .. حيث كانت عبقرية الغرب تواجه شرور العبيد الشرقيين. ونواجه مرة أخرى العدو نفسه على صورة تهديد إسلامي بطابع ديني وعسكري للمسيحية الغربية في حوالي القرن الحادي عشر لتتوسع الحروب بين الطرفين وتعبأ كل أوروبا ضد الشرق المسلم (الحروب الصليبية) .. ثالثا: "العدو" منذ الحرب العالمية الثانية إن مؤيدي فكرة ترجيح التكامل على ما سواه، يفترضون انقطاعا بين الماضي والحاضر والبدائي والحديث، ويعبرون عن اعتقادهم بأفكار سرعان ما تلوذ بالهزيمة أمام استعادة الأساطير واللغة البدائية لسيطرتها على عقلية القائمين في مختلف البلدان، فتذوب (فزلكة العلمانية) التي حاولت وضع نظريات تتحكم في العلاقات الدولية بنزاهة، أمام نهوض التقاليد البدائية.. 1ـ الحرب الباردة لقد كانت فلسفة الحرب الباردة ( ظاهريا) هي وجوب نصرة المسيحية على الشيوعية الملحدة، وطبعا ظهرت الولايات المتحدة كنصير لأوروبا ضد الشيوعية كما كانت نصيرة لها ضد النازية .. وبالمقابل فإن الروس (المكون الأكبر للاتحاد السوفييتي) والذين كانوا سدا منيعا أمام هجمات الآسيويين ضد المسيحية الأرثوذكسية سابقا، هم حماة البشرية من الشرور الإمبريالية في الحرب الباردة. 2ـ القومية العربية والإسلام لقد حطمت الحرب العالمية الأولى اعتقاد الحضارة الأوروبية في تقدمها دون حدود، واستمرت موجات التحطيم بشكل ثورة درامية في استقلال الدولة تلو الدولة عن الغرب المستعمر..ومع ذلك برز في الستينات من القرن الماضي شر جديد هو القومية العربية وأحلامها في توحيد شعوب منطقة واسعة تتوسط العالم وتؤثر في التحركات بين أوصاله، فكان لا بد من تشويهها ومهاجمتها وحشد الخصوم ضدها من خارجها وداخلها، وكان تسلسل الأعداء يبدأ بجمال عبد الناصر ومنظمة أوبك وصدام حسين ثم بروز إيران وربطت كل المعتقدات الدينية والقومية بالنفط، فكان العداء لكل الأطراف مجتمعة وردات الفعل من مختلف الأطراف الغربية متناغم .. (الموقف من سلمان رشدي وكتابه آيات شيطانية) ( الموقف من انضمام تركيا للجسم الغربي) .. وتتوالى الأحداث المشابهة .. رابعا: الاختلافات الدينية والقومية داخل أوروبا المعاصرة عندما يتم ذكر أوروبا، فيعني ذلك بلغة السياسيين الغربيين (أوروبا الغربية) وعندما يتم ذكر المسيحية فإن ذلك يعني ديانة أوروبا الغربية (الكاثوليك والبروتستانت) .. وبعبارة أخرى ستسقط روسيا وصربيا وبلدان أخرى من هذين التصنيفين .. وهذا يجعل العرق (السلافي)( أي سكان أوروبا الشرقية) وكأنهم ليسوا بأوروبيين .. إن انتهاء الحرب الباردة لم يجعل أوروبا خالية من الأعداء، بل بالعكس كثر الأعداء داخل أوروبا، ورأينا الحروب في منطقة البلقان، وتفكك دول مثل يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، وما وراء ذلك من انبعاث لعداوات كانت سابتة .. باختصار هناك ثلاث أعداء للأوروبيين : أعداء من خارج أوروبا (المسلمون) وأعداء أوروبيين (باختلافات عرقية وطائفية) .. وأعداء تغلغلوا في أوروبا .. وهم المهاجرون (ومعظمهم مسلمون) .. خامسا: الطبيعية السياسية للاندماج الأوروبي بعكس الذين يراهنون على سلاسة نشوء اتحاد أوروبي، وبالذات من ينظرون إليه من الخارج، باعتبار أن التطور فيه آخذ الى تحول أوروبا الى دولة (كتلة) قوية تنافس أمريكا واليابان ودول العالم الثالث .. يصنف الكاتب نفسه على أنه من المتشائمين، فالإجراءات التي تمت حتى الآن لم تكن أكثر من إجراءات اقتصادية أملتها قوانين السوق، لكن التحول السياسي والإرادة السياسية لن تمر بتلك السلاسة .. فهو يميز بين التعاون الأطلسي المدعوم من النرويج وإنكلترا وبين الاندماج القاري المدعوم من ألمانيا وفرنسا .. حيث يرى أنه في الحالة الأولى أن من يحدد العدو والصديق هو الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الحالة الثانية تتراجع دول كثيرة من أوروبا عن المضي قدما (الاستفتاءات على الاندماج ونتائجها العكسية) .. ويشترط الكاتب أنه حتى يكون هناك أوروبا قوية لا بد من اندماج روسيا معها وهو يستبعد حدوث ذلك .. |
الفصل الثالث: الاستشراق والاستغراب : اختراع الآخر في الخطاب الأنثروبولوجي .. قدمه: منذر الكيلاني : أستاذ في جامعة لوزان ـ سويسرا
أولا: بلاغة الخطاب الأنثروبولوجي: الكونية والمقارنة والتراتب من المحقق أن "اكتشاف" أمريكا افتتح عهد الحداثة في الغرب، وأنه وفر أيضا شروط انبثاق الخطاب حول الآخر، الآخر الذي دائما ما يكون الفكر الأوروبي محتاجا إليه. لكن ما الذي حدث؟ كانت الأشياء التي شاهدها المكتشفون لأمريكا ينظرون لها بأدوات قديمة وقياسا لأشياء "معلومة" فاستنفرت الأدوات المعلومة والمتحصلة من تراكم معرفة العالم القديم، منذ عهد التوراة والإغريق والرومان ومصر القديمة وبلاد ما بين النهرين والحضارة الإسلامية لتساعد في وصف وفهم ما شاهده المكتشفون في البلاد المكتشفة حديثا. فقورنت الصروح المهيبة التي شيدها (الأنكا) و (المايا) من حيث العظمة والمهارة بأهرام مصر أو بالهندسة الرومانية، وقورنت معابد (الأزتيك) بالمساجد، وقورنت اللاما بالجمل والخروف، فصارت (اللاما) جمل وحمار وخروف أمريكا! يتوجب إذن على البصر، كي يتخطى حدوده ويحصِل المعنى، أن يتحمل جزءا من ذاته كان قد ابتناه مسبقا ليصاحبه في رحلته. لقد كان لكولومبس ولمعاصريه فكرة مكونة سلفا عما سيشاهدون. لقد كان تحت تأثير الهدف الذي ترمي إليه سفرته [ لقد سمي الشعب بالهنود الحمر، كون الرحلة بالأصل كانت تبحث عن طريق آخر للهند المعروفة قبل الرحلة] لا مناص للأنثروبولوجي الحديث من أن يؤدي دور (الصانع) الذي يرى بأم عينيه أمورا لم يرها شخص قط حتى ذلك الحين. إن المونوغرافيا الميدانية لها قدرة حقيقية على تغيير وجه الآخر، وعلى اختراع هيئة له تكون إما "نبيلة" أو "شرسة"، إما "مسالمة" أو معادية" إما "ودية" أو"منفرة". إن الأنثروبولوجيا تصنع وتبث صورا عن الثقافات والشعوب، فتصير مع الزمن جزءا من مكونات ثقافة الشخص العادي في الغرب وموضوعا مكررا ومشتركا عند الحديث عن أي آخر. هكذا تكون الطيبة عند الأقزام، كما صورها المستكشفون، وتكون اللون الأزرق عند الطوارق، أو الفلاحين الماكرين في الحيازات (النورماندية) .. البلاغة في الآخرية، وهي اختزالية على الغالب، وتتضمن دائما تهديدا لمن تجعله موضوعا لخطابها، والبلاغة هنا، فن مبني في العمق على عدم التناظر. ليس هناك تناظر بين وضع تكون فيه ناظرا أو "رائيًا" وبين أن تكون منظورا إليه "مرئيا"، هكذا صور الغرب المستكشف لأمريكا الشعب هناك، وقاموا بتسويغ قتله وإبادته، وهكذا فعلوا في الحديث عن المسلمين، قبل الحملات الصليبية. في الأعمال الأنثروبولوجية الحديثة، تكون الأدوات غربية بحتة، فالآخر في كل الحالات هو من لا ينتمي للحضارة الغربية .. ( كتاب رحلة الى الشرق وهو اختراع يقوم فيه المؤلف برحلة دائرية تعود فيه باستمرار الى الغرب بعد أن يمر على كل ما هو مغاير ومخالف ومتخلف عن الغربي) .. لكن لماذا نفترض وجود تعادل للأصوات والثقافات، بعيدا عن موازين القوى التي تربط الثقافات على ضوء القوة الراهنة (في وقتها) .. من الجائز مثلا لمهاجر مغربي في فرنسا أن يتذكر عبثا الحظوة التي كانت لثقافته في الماضي أو التي يمكن أن تكون لها في بعض المناسبات الحاضرة، لكن ذلك لن يغير شيئا في آلام الواقع اليوم، أي في التراتب الاجتماعي الذي يرفع الثقافة الفرنسية والأوروبية الى أعلى السلم ويضع الثقافات المغربية والعربية والإسلامية والعالمثالثية في أسفل السلم، أو حتى خارجه نهائيا.. ثانيا: الاستشراق والاستغراب .. أو أوهام التمامية القائمة على الهوية. كان خصوم الاستشراق ـ ولا زالوا ـ يركزون على واقعهم الأنثروبولوجي الذاتي دون الالتفات للآخر، لتعديل موقعهم التراتبي، بحيث يصبحون هم من ينظر للآخر نظرة فوقية! وفصلهم الذاتي عن الموضوعي* أوقعهم بحالة غبية وأوجد عندهم ما يعرف بجمود الهوية .. لنأخذ حالة نقد الاستشراق عند (إدوارد سعيد) الذي يحمل في نهاية المطاف الغرب للقولبة التي وجد بها الشرق، وهو هنا يفصل بين الذاتي والموضوعي، ويزيل العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع التي تسري داخل كل بناء اجتماعي وداخل كل مشروع فكري. ليس هناك دواعي للتدليل على أهمية العلاقة بين الذات والموضوعي وإعادة مثال السيد بالخادم، التي توجب وجود السيد حتى يكون للخادم هوية .. بمعنى آخر، ليس الأوروبي بالمسئول وحده عن قولبة الشرقي في قالب "آخرية" لا معنى لها إلا في حدود ذاتها، بل كان للشرقي المتواطئ مع الأوروبي حتى يجعل نفسه في هذا الموضع "الآخري" حرصت بعض النزعات السوسيولوجية العربية المعاصرة على تنظيم البناء بحسب مقتضيات الهوية، أي أنها تربط الاستشراق بتفهم نظرة الآخر، بعدما كانت تتفرغ لتهاجم الاستشراق وتشنع به. في حين لا زال هناك من يساهم في (تكليس) الهوية وتجميدها وتصنيع مسلمات جديدة لتحديد الهوية كالطائفية أو العرقية، وهذه المساهمات تعمل ما تعمله المرآة في تسليط أضواء الآخرين على تلك الهويات المحلية العربية كآخر (دوني) .. أن نرفض أن الآخر حاضر في ذاتنا، وأن الهوية تنبني على التفاعل بين الاثنين يؤول بنا الى تعتيم البعد الأبيستيمولوجي الذي تقوم عليه مقاربة العلوم الاجتماعية: وتتمثل هذه المقاربة في الأخذ بالمرجعية الكونية .. ويختتم الكاتب دعوته بالحث على الكيفية التي نحقق فيه ذاتنا ومعرفة موقعنا بين مفصليات العلاقات التراتبية العالمية من خلال استنفار الجهود في وضع تلك المسألة بين المسائل المهمة التي على الجميع الانتباه لها .. |
الفصل الرابع: العنصرية: منطق الإقصاء العام ..
قدمه: جاك ماهو : باحث بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRC باريس . (1) كيف نسمي الناس؟ إن المرء الذي ما يزال يعير انتباها ولو قليلا لأسلوب تحرير الأحداث المتفرقة في الصحف، سيجد أنه من المفيد أن يقرأ الأسلوب الذي به يُنعت أولئك الناس الذين يحف بهم أمرٌ ما: (رجل شمال إفريقي يطعن واحدا من أهل ديانته)؛ (امرأة في العقد الخامس من عمرها تنتحر في الميترو) ؛ (عصابة من الشبان قامت بسرقة سيارات) .. الخ . إن الألفاظ المستعملة ليست بريئة. فنحن لم نعرف عن المرأة سوى عمرها، ولم نعرف عن الشمال إفريقي كم عمره، وهكذا فإن الخبر يدخل طي النسيان ولن يبقى منه سوى المحور الذي أراده المورد للخبر.. فإن أراد المخبر أن يركز على العرق فيذكر (جريمة شنعاء) ويلصقها بالعرق أو المذهب، وأن هناك علاقة بين الألفاظ المستعملة وبين الفعل المنطوق به، فلكل فعل محدد يتم اختيار ألفاظ محددة. فالقول بأن عصابة من الشبان تسرق الدراجات النارية يعني القول بأن الشباب (متضمن) داخل السرقة، أو أن السرقة تعلل بوجود الشباب في أقصى الحالات. ولن تجد يوما (عصابة من الكهول تسرق بنكا) . هذا يسمى المنطق المضمر في التسمية. (2) يوجد لدى علماء النفس وعلماء الاجتماع تمرين على القراءة يسمى بتحليل المضمون. وشغلهم في هذا المضمار هو الاستعاضة من الكلام العادي الذي يعبر الناس بواسطته بخطاب متفقه (من الفقه) في العلم، مفاده التوجه بنبرة جادة الى جمهور من المختارين بتفسير ما يريد الغير قوله؛ إنه تفسير ينعت خطاب عامة الناس بالخطاب المبهم وينعت خطاب شارح الطلاسم بالخطاب الواضح. لقد تجلت هذه الخاصية التأويلية في نشاط من يريدون تأويل ما يقال ويكتب الى ما لا نهاية من التأويلات، وحاولوا وضع نظريات تفسر ما يكمن وراء نسق تلك التأويلات . ولنقل بأنه لا يوجد تحليل للمضمون يكون ساذجا وبريئا، بقدر ما لا يوجد أيضا منهج لكل المجالات يمنحنا مفتاحا سحريا لتفكيك رموز كل نص. إن ما يُطلب منا هو أن نمنح ثقتنا عندما يُعرض علينا تأويل من التأويلات. وربما تكون غالبية تلك التأويلات مقنعة شريطة أن نسلم بسيكولوجيا الأعماق أين نجد أن المسكوت عنه يفيد ب (ما كان يراد قوله) في حين يكون (ما قيل) واضحا بذاته بالطبع. مختصر القول في هذا الشأن، أن تسليمنا بما يقوم بتأويله من يعرضون الشأن علينا، يشترط التصديق بقدرتهم على رؤية ما لم نستطع رؤيته نحن. (3) في الحقيقة ولكن من منظور منطقي فقط، عندما يظهر في قضية ما موضوع نقرر أنه محل المعالجة ويكون مقترنا بفعل فاعل تنبسط أمامنا ثلاث إمكانات: أ/أ : أي المقابلة بين حدين متماثلين بصدد عبارات منطوقة. ومثال ذلك : يهود فرنسا (لهم هذه الخاصية المعينة)/ يهود روسيا (ليس لهم هذه الخاصية). أ/ب : حدان ليس بينهما علاقات: اليهود وأطباء الأسنان. أ/ج أو أ/أ : ثمة اليهود الذين يتصفون بمميزات ما، وثمة الآخرون الذين لا يكتسبون هذه المميزات ولكنهم يكتسبون مميزات أخرى تجيز احتمالا تمييزهم بسمات أخرى. من هنا يتأتى النفي البسيط الذي بمقتضاه نثبت أن الآخرين هم فقط الذين تنعدم فيهم طبائع اليهود، من دون أن يكون في مقدورنا أن نقول شيئا في خصوصيتهم كمجموعة. يقول الكاتب: إن هذا المشكل لعلى قدر من الأهمية .. فبيان كيف يعمل الفكر العنصري يعني أيضا كيف يعمل الفكر غير العنصري، إن الفكر غير العنصري لا يتضح في التحليل الأخير إلا بتبيان ما يلي : 1ـ أنه توجد وجودا شائعا تقابلات من نوع أ/ج أو أ/أ يكون فيها المسمى هو الأغلبية . (ليلاحظ القارئ الكريم أن تلك التقابلات تسود في الوقت الحاضر خطاب من يهيئون للفتن في منطقتنا (شيعة/سنة/ كرد الخ) محاولين تعميم صفة ينتقونها ليقدموا الآخر بها لتأجيج الفتنة). 2ـ أنه توجد تقابلات من نوع أ/ب 3ـ إن نظام التسمية هذا يعمل إن قليلا أو كثيرا بالطريقة نفسها التي يعمل بها النظام العنصري. أن يتحكم المرء في الحجة يعني أنه يقدم حجة على انعدام أية حجة مضادة. (4) تبدو العنصرية في آخر الأمر بما هي نمط من أنماط التصنيف الشعبي ذات قرابة متينة بعلم التصنيف الذي للعلماء، وهو الشهير لدى علماء الاجتماع والمنعوت بالتيمولوجيا (علم الأصناف البشرية). وأعني بالعنصري كل فكر يستخدم، بدلا من المنطق التوسعي، منطق المعاني الشاملة الذي يعمل بحسب تضمين المعاني. فمن بين الصفات الكثيرة التي يمكن أن تُلحق بالفرد، ومن بين طبائعه المتنوعة تنوعا لا متناهيا، ينتقي العنصري البعض منها ليلصقها بمن يريد أن يتحدث عنه. وبالمقابل فإن لهذه المشاركة بالنمط فضل ترسيخ السمات في الفرد وفضل تثبيت وجودها فيه وجودا مطلقا لا يقبل غيره من السمات. إنها تجعل من الإنسان المتكاثر والمتنوع يهوديا أو عاملا أو امرأة. إن الفكرة (الأصلية) (الصورة بالمعنى الفلسفي) هي التي تنتقي هذه السمات وهي بدورها تعتمد على وجود السمات. خلاصة القول: أنه عندما ننتقي فئة أو فردا ونريد أن نعالجه بالدرس أو الوصف، فإننا سنكون أسرى لصورة مسبقة كوناها عن هذه الفئة أو الفرد. |
الفصل الخامس: الآخر أو الجانب الملعون
قدمته: أسماء العريف بياتريكس : باحثة تونسية ـ باريس بعض الصور النمطية الأصلية: معلوم أن الصور والرموز سابقة عند الكائن البشري على كل تشريط تاريخي، وعلى كل ملكة عاقلة، ولكن هل نحتاج الى أعلام التحليل النفسي والأنثروبولوجيا*1 لنكتسب هذه المعرفة؟ ما انفكت الفرضية التي صاغها (يونغ) حول وجود ( لا وعي) جمعي تلقى مزيد التقصي والتوكيد لدى علماء النفس الذين يعالجون الأعماق البشرية ولدى مؤرخي الأديان. وهذه الفرضية لها الفضل في تبيان خلود (الأصول القديمة) التي لا تعني شيئا آخر سوى الجوهر المقوم للإنسانية الأم، رغم تنوع المسارات التاريخية والتناقضات الأيديولوجية المؤثرة في منابع الثقافة. الكوسموغونيا*2 الدينية وصورة الآخر صحيح أن صورة الآخر تُشَيَد دائما على ميدان التاريخ، ولكنها تشيد انطلاقا من أنماط أصلية عابرة للتاريخ هي التي تؤسس مخيالنا الإنساني. ينزع الإنسان حيثما وُجِد الى إدراك العالم وتصوره انطلاقا من خطي بداية، الأول يعني بتصوره عن بدء خلق البشرية (الكوسموس) والتوق الى التقرب من الله والصعود الى السماء والابتعاد عن الظلام والسديم. والثاني، الشعور بالتعالي والإحساس بتفوق نوعه أو قبيلته أو عرقه. وإن كل المجتمعات تنتهي طوعا أو كرها الى قبول الغزاة الأجانب أو الى استيعابهم داخلها. وسيرى المجتمع المغلوب تفسيرا يرجع فيه انقطاعه المأساوي في صلب النظام الاجتماعي، وسقوطه في الظلام من جديد، وأن هذا الغازي الدخيل قد بعثته السماء رسولا ليعيد المجتمع المغلوب الى رشده. إن الإنسانية لم تعش فقط تجربة الخوف من الكوارث الكونية أو نبذ البربري المعكر للنظام، وإنما عاشت أيضا الحلم باستعادة الفردوس المفقود. وهذه الثنائية تحددها النمطية التي يتصور بها الشعب الشكل الأولي للخلق (الكوسموغونية)، فهي عند الهنود تختلف عند أصحاب الديانات السماوية. الكوسموغونية السياسية وإدراك الآخر لقد طغت التطورات الصناعية والرأسمالية على مشاعر الناس، فتحول الآخر الديني الى آخر سياسي، وكان الانزياح من المجال الديني الى المجال السياسي مصحوبا بترسيخ بعض الصور ودحر صور أخرى. وأن انتقاء صور دون أخرى يبدو أحيانا أنه اعتباطي، لكن التوفيق بين الحالتين المقبولة والمنبوذة هو الكفيل بتأمين توازن النفس البشرية. فعندما نجبر أنفسنا على قبول صورة كنا قد كرهناها عند الآخر فإننا نقرر التنازل عن جزء من ذاتنا. وفي هذا المجال تشير مقدمة البحث (أسماء العريف) الى رؤية (جيلبار دوران) أنه بإمكاننا أن نتبين عبر مجموعة الصور المتجاورة التي تنظم مخيالنا نظامين اثنين من الصور: نظام نهاري يجمع كل الصور الرامزة الى القوة والسلطان مثل الصولجان والسيف ويطمح للتفوق والانتصار على الموت والتمرد على القدر. ونظام ليلي يشمل الصور المعبرة عن الألفة الحميمة، بين أحضان الأم واستعادة الأنوثة لاعتبارها. يلاحظ القارئ، أن النظام الليلي الذي اقترحه (جيلبار دوران) يريد أن يبين فيه أن الليل الذي هو عكس النهار، والظلام والذي هو عكس النور بالقدر الذي تكون فيه الصورة مكروهة، بالقدر الذي ممكن أن نستخلص منه الجزء الحميمي الذي لا غنى لنا عنه. وهي نفس الصورة التي تريد الكاتبة أن توصلنا بها لنظرتنا الى الآخر أو نظرته لنا، أنه لا يكون لكلينا مناصا من اعتبار جزء من الصورة مقبول بل وضروري. الآخر في المخيال تنتقل الكاتبة الى نقطة في غاية الأهمية، وقد تناولت فيها نظرة (تياري هانتش) في كتابه (الشرق الخيالي)، الذي يقول فيه أن الانشطار (شرق/غرب) هو من صنع الغرب أنفسهم في القرن الخامس عشر، حيث بدأ الغرب يحس بقوته، في حين أن بداخله أثر (روحي) كبير من الشرق الذي قدم له (ديانته المسيحية) وقدم له فلسفته ومعارفه القديمة بثوب شرقي شارح لها. فقد استكثر الغرب على الشرق تلك الخدمة فأراد أن ينسفها، ويخلعها عن الشرق، فقام بإسقاط وضعه الجديد (القوي السياسي) على الماضي فحاول في شرحه تقليل أهمية الشرق وهمجيته. في حين لم يكن الشرق (الإسلامي) قد تعامل مع الغرب قبل القرن الخامس عشر إلا في شكل متوازن، يقرأ له (علومه القديمة) ويقدم له وجهة نظره حسب فهمه الإسلامي دون إبداء روح التعالي بل بحكم ووجوب التلاقح الفكري ، وتضرب الكاتبة مثال (عمر الخيام الشاعر والصوفي والفيلسوف والرياضي). وعندما أراد الشرق أن ينهض في القرن التاسع عشر، لم يستنكف عن الاهتمام بالغرب (محمد عبده، محمد إقبال). وبعد أن تكلست نظرة الغرب في عليائه وكبرياءه تجاه الشرق، برزت ضرورة استنهاض قوة مضادة له من بين مغالين من الشرق، ليقابلوا تلك النظرة النابذة للآخر الشرقي، فكان التسابق لاستنبات مفكرين ومنظمات متطرفة بين الفريقين الشرق والغرب. نحو تواصل علماني وديني بين الأنماط الأصلية رغم النزعة المغالية في التشبث بالهوية الذاتية، فإنه يوجد تواصل إنساني في كل المستويات، دينية أو سياسية علمانية أو رافضة للعلمانية. دعنا ننظر الى ما كتبه (مرسيا إلياد) : (إن حضور الصور والرموز هو الذي يحفظ بقاء الثقافات ((المنفتحة)) : ففي كل ثقافة سواء كانت ثقافة أسترالية أو أثينية، تكشف أوضاع الإنسان عن حدودها القصوى ... تمثل الصور انفتاحات على عالم عابر للتاريخ ... وبفضلها يمكن للتواصل بين المؤرخين أن يتحقق) وهذا مثال آخر على ما كتبه (لويس ماسينيون) : (( تكفي إيماءة سريعة الى الحلاج، جاءت في حواشي رباعيات الخيام تمدها يد ملتبسة، وتكفي حكمة عربية بسيطة على لسانه تراءت عِبر فارسية العطار (الغابرة ذكراها)، ليرتد صوبي معنى الخطيئة، ثم الرغبة تنهشني ... إني أحيي من بعيد وعيناي صاغرتان هذا الوجه السامي [وجه الحلاج] المحتجب دوما عني حتى في عرائه في محنة صلبه وقد اجتثت هامته من الأرض ورفعت وأغرقت في الدماء برمتها تمزقها جراح الموت التي غرستها فيها أظفار الغيرة من حب يفوق كل وصف ممكن). من هذا النص يظهر تكريس الصور الدينية بغض النظر ـ لأي دين تعود ـ فصورة صلب المسيح وناقة صالح ومحنة أي عابد تتجول في كل الثقافات برمزيتها وتتناقل قدسيتها أقلام متدينة وعلمانية. وكلها تدعو للخروج من الإقليمية الضيقة (حسب اقتراح جاك بارك في كتابه الشرق الثاني) . هوامش *1ـ ، الأنثروبولوجيا بشطريها، "Anthropos " "Logos"؛ تعني علم الإنسان؛ أي العلم الذي يدرس الإنسان في أبعاده المختلفة، البيوفيزيائية والاجتماعية والثقافية، فهي علم شامل يجمع بين ميادين ومجالات متباينة ومختلفة بعضها عن بعض، اختلاف علم التشريح عن تاريخ تطوّر الجنس البشري والجماعات العرقية، وعن دراسة النظم الاجتماعية من سياسيّة واقتصادية وقرابية ودينية وقانونية، وما إليها .. وكذلك عن الإبداع الإنساني في مجالات الثقافة المتنّوعة التي تشمل: التراث الفكري وأنماط القيم وأنساق الفكر والإبداع الأدبي والفني، بل والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك في المجتمعات الإنسانية المختلفة. عن الملتقى الدولي الأول حول وضعية البحث الأنثروبولوجي في العالم العربي في 9/12/2007 الجزائر/تبسة *2ـ الكوسمولوجيا" هي علم وصف الكون على ما هو عليه في حالته الحاضرة، ويبحث فيه عن القوانين التي تحكمه، بينما تعنى كونيات النشأة أو ببداية الخليقة |
الفصل السادس: الآخر : المفارقة الضرورية ..
قدمته : دلال البزري .. أستاذة في الجامعة اللبنانية ـ صيدا قد يكون لكل (آخر) تعريف خاص يوليه إليه من كان له به شأن. فما يعيشه الفرد أو يقرأه فهو (آخر) ذو معالم كثيفة، حادة، عدوانية ... يتحول غالبا الى مادة لقضية يَستغني العديدون عن حياتهم أو عن (موتهم) من أجلها: لاتقاء شره أو لتهدئة سطوته، أو للتصدي له ... بل أحيانا لإفنائه. تبدأ الكاتبة ورقتها بهذه الفقرة وترى أن تقسمها الى قسمين: أولا: ماهية نسبية واعتداد كوني ( ليحرقك الآخر، ذلك الذي لا يتوجب ذكر اسمه) : تلك هي لعنة رمتها (سالمبو) بوجه (ماثو)، غريمها ومنتهك حرمة إلهة قرطاجة) . بين الآخرين في هذه الدعوة بون شاسع، فالآخر السماوي، والآخر المدعو عليه! هناك مستويات وأعداد لا حصر لها للآخر الآخر : بصفته حاكما مستبدا لدى جورج أورويل في عام 1984: (الأخ الأكبر) وعينه الضابطة لتفاصيل حياة محكومية الدقيقة. الآخر: المحكوم في كتاب الأمير لميكافيللي وهو يسدي النصائح للحكام عن الكيفية التي يجب التعامل بها مع الآخر (المحكوم). الآخر : رب العمل عند (ماركس) في كتابه (رأس المال) ووسيطه في الاستغلال: فائض القيمة. الآخر: في الدين وهو الدين الآخر أو المفارق في المذهب بالدين نفسه. الآخر : في الجنس، المرأة آخر بالنسبة للرجل وهو آخر بالنسبة لها. الآخر: قوة عظمى تسعى للسيطرة على العالم، ومن يكتوي بنارها يعتبرها آخر، وتعتبره هي آخرا بالنسبة لها. الآخر : شرق وغرب الآخر : عند الصوفي هو غير المفكر فيه، الواجب سبر أغواره حتى بلوغ (العين). هكذا يكون الآخر، آخرا بالنسبة لموقع من يتعامل معه ويصنفه، وهي مسألة تلفت الانتباه لمن يريد اعتماد تلك التصنيفات بشكل أساسي لا يناقش ويسلم به. وأكثر تلك المسائل هي المعنية بالشرق والغرب، كيف نحدد الشرق؟ وبالتالي كيف نحدد الغرب؟ هل هي مسألة جهة جغرافية فحسب؟ لنتخيل أننا نعيش في اليابان ـ مثلا ـ فالشرق لنا هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب هو فلسطين مثلا! إن الشرق هو اختراع أوروبي غربي سيزول مع الزمن أو يتطور بتطور أشكال القوة الفاعلة بالعالم. كما تطور مفهوم (الإفرنجة ) عند العرب المسلمين حتى القرن الرابع أو الخامس الهجري، ثم أصبح (صليبيين) . من الأمثلة الأخرى التي لا ثبات ولا تسليم بديمومة الآخر فيها، هي ما حدث في لبنان (بالحرب الأهلية) فيكون الآخر للمسلم الساكن في بيروت الغربية، قد تحدد على ضوء وقائع الحرب، فهو من يقطن (بيروت الشرقية) أي حزب الكتائب وحلفاءه. وهذا المثال ممكن أن نشاهده في العراق، ولكن بصورة أكثر تعقيدا. فالآخر في البداية هو المحتل الأمريكي مع حلفاءه، والآخر هو الإيراني، والآخر هو المليشيات والآخر هو القاعدة والآخر هو الصحوة والآخر الحكومة المتعاونة مع المحتل، والآخر هو المقاومة، فأين يكون المتحدث يكون آخره حاضرا. ثانيا: الوعي بالآخر وقلة الإلمام به تقوم هذه المفارقة على معطيين بديهيين، هما بسرعة: الأول أنه لا يوجد (آخر) من دون الوعي بوجوده. يمكن لهذا (الآخر) أن يعيش طويلا في بقعة ما، في زمن ما، ولا نشك لحظة في أننا قد نلقاه يوما فيصير آخرا مختلفا، كما حدث للعرب المعاصرين عندما صدموا بالآخر الغربي بعد حملة نابليون 1798، فكان من بين زوايا النظر لهذا (الآخر) الزاوية العلمية، فأعجبوا بالآخر الغربي، واندفع أبناء العرب نحو الغرب لينهلوا من علومه. ومثال ثاني، هو بخصوص من تبقى من مخلفات (الهنود الحمر) في أمريكا وأنسبائهم عندما خرجوا في مظاهرات عام 1992 (بعد مرور 500 سنة على اكتشاف أمريكا) رافعين شعارا استنكاريا (لا تكتشفونا). أما المعطى الثاني، فهو أنه لا توجد علاقة بالآخر إلا على قاعدة غالب ومغلوب، ومن دون هذه القاعدة، يضمحل الآخر ويصبح عدما .. مندمجا تمام الاندماج . كانت دول أوروبا الشرقية قبل عدة عقود تشكل (آخرا) بالنسبة لأوروبا الغربية، اليوم الكثير من تلك الدول تدخل في مؤسسات الغرب (حلف شمال الأطلسي، والوحدة الأوروبية). فيما يخص اختراع الغرب للآخر، تذكر المؤلفة أنه بين عامي 1800 و 1950 صدر في الغرب كتبا وبحوث ودراسات عن الشرق تقدر ب 60 ألف مؤلَف، ليشرعن الغرب (عظمته) على الشرق (الآخر) [ أخذت الباحثة هذه المعلومات عن إدوارد سعيد]. سمات المعرفة بالآخر 1ـ الاختزال أكثر الصفات السوسيولوجية إلصاقا بالشرق (العربي والإسلامي) هي الاستبداد. وهو استبداد يرمز له بالخيمة والقبيلة. وعندما يحاول الشرقي إنكار تلك الصفات عنه ويحاول تذكير الغرب بما نقله له من علوم قديمة أعاد الشرق صياغتها لتكون صالحة للاستعمال من قبل الغرب، وإن كان بعض مصادرها من الغرب نفسه (الإغريق). ينكر الغرب تلك الخاصية على الشرق ويعترف بأنه نقلها، لكن دون أن يلتقط الجوانب الإنسانية منها! في حين يختزل الشرق صفات الغرب، ويصوره بأنه صليبي كافر وثني منحل الأخلاق. 2ـ الجنسنة Sexualisation يصور الخطاب الاستشراقي، الشرق بذكورية ترمز الى العلاقة العادية بين رجل وامرأة : فالشرق عنده صامت، واهن، خائر، رخو، سلبي، والأهم .. ساحر. كل ما بوسعه هو تلقي المبادرة الآتية من الغرب وقبول الاختراق بالتواضع نفسه الذي تتمتع به العذارى. هذا من دون إغفال اهتمام الغرب اللافت، راهنا، بالمرأة المسلمة الشرقية: أجلى تعبيراته التركيز على خطر التيارات الإسلامية بصفتها تهدد المرأة القاطنة في بلدانه وكأنها أهم الأخطار (معارك منع الحجاب ). من جانب آخر، يرى الشرقي في بنات الغرب وصورهن المتعرية في المجلات، أنهن مستباحات لكل باحث عن لذة عابرة، والصورة الغربية عند الشرقي صورة أنثوية، مقابل الصورة الذكورية عند الشرق بالجهاد والقوة والغزو والحرب. هذه الصور تتكرر في روايات الأدباء العرب (الحي اللاتيني: ليوسف إدريس، قصة حب مجوسية لعبد الرحمن منيف، موسم الهجرة الى الشمال للطيب صالح) 3ـ الزمن المفوَت يعيش كل من الغالب والمغلوب زمنا يشتبك فيه الماضي والمستقبل، بحيث يصعب عليهما امتلاك الحاضر: فالأول لا يكتفي بمصادرة تاريخ المغلوب والتكلم باسمه، بل يذهب الى ما وراء التاريخ، فيما الثاني لا يجد ذودا عن نفسه سوى اللجوء الى ما قبل التاريخ. يبقى المغلوب دائم الثبات على شفير الهاوية: على حدود التنازل عن أقرب حواضره، والغالب يقرر أنه لا وجود لمن يحتج على هيمنته بسبب فقدان الذاكرة وما يواسي الشرق العربي أنه زمانه السالف صنع ما يشبه هذه الهيمنة، وإذا ما قِيس ببؤس الحاضر فسوف يجد فيه معلما من معالم جبروته المحتملة. لذلك فهو دائم الاعتصام به والمناجاة له. ( خيبر ، ذات الصواري ، صلاح الدين، قطز الخ). خاتمة تختتم الكاتبة ورقتها بتساؤل: هل من حالة يغيب فيها هذا الآخر؟ أو، إذا شئنا الاكتفاء بما تيسر، هل من سبيل الى إضفاء بعض التلوينات الدقيقة عليه، تقربنا من إنسانيته، وفي اللحظة نفسها تدخلنا الى الدوافع العميقة لصراعيته؟ العالم الجديد الذي نحن بصدده، لم يستقر بعد على المنظومة الفكرية التي تسمح له بتعيين الآخر تعيينا مقنعا. أما المرشح للاعتراض على ملامح هذا العالم فهي النواة العربية الإسلامية، بشرية كانت أم جغرافية، وقد أخذت ملامح اعتراضها بالتجلي، ليستكين الغرب عند تصنيفه للعرب والمسلمين بأنهم (الآخر) القابل لمواصلة مناهضته. وعلى الشرق، لكي يربح نفسه كآخر غير متهم بل وفاعل ومنادد لغيره في العالم، أن ينتبه الى تقوية نسيجه الداخلي من حيث حقوق الإنسان وتناقل السلطة ومراقبة نمو في مختلف المجالات ليكون صورة لمرآة لأي آخر في العالم، وإلا بقي الشرق يحلق بأجنحة (استبداديته) المتكسرة. |
الفصل السابع: صورة الآخر المختلف فكريا: سوسيولوجية الاختلاف والتعصب
قدمه : حيدر ابراهيم علي : مدير مركز الدراسات السودانية في القاهرة وأمين عام الجمعية العربية لعلم الاجتماع .. يأخذ الكاتب في ورقته منحى مختلف عمن سبقه، فهو يستخف بفكرة الآخر البعيد (الذي من قارة أخرى أو من قطر آخر أو من قومية أخرى)، ويركز على أن الآخر في منطقتنا العربية أصبح رمزه مزروعا بيننا. لقد دخل أبناء الوطن العربي بعداءات فيما بينهم تفوق تلك التي مع أعداءهم، فأصبح من الملائم أن يُطلق عليهم (الأخوة ـ الأعداء). ويحاول الكاتب أن يمر بحيادية (عالم الاجتماع) على الظواهر المنتشرة في الوطن العربي، من عودة عنيفة متحمسة ومتعصبة للفكر الديني (الإسلاموي ـ أي الإسلامي المسيس)، ويذكر الكثير من الفئات التي تزعم أنها (الفئة الناجية) المنزهة من بين الفرق الإسلامية الكثيرة، وهي (أي كل فرقة تزعم ذلك) الوحيدة التي تملك الحق في إزالة وتطهير المجتمع العربي من كل ما دنسه من مظاهر ردة. ويشبه الكاتب تلك الدعوات والتي لم تقتصر على المسلمين في العالم، بل توجد لدى اليهود( شعب الله المختار) و المسيحيين (ملح الأرض ونور العالم) كما هي عند المسلمين (خير أمة أخرجت للناس) يشبه ذلك بفكرة النازية بموضوع الاستعلاء والأحقية في محو الآخر وقهره وإخضاعه. يقول الكاتب: يضعنا تأكيد الهوية الدينية أمام مجتمعين متناقضين: مجتمع الوحدة والإجماع أو النقاء والانسجام، مقابل مجتمع التعدد والاختلاف والتسامح. وفي هذه الحالة تحتل مسألة الهوية (Identity) أهمية محورية، إذ تعادل الأنا أو الذات، ولكنها تثير عدة أسئلة صعبة، منها على سبيل المثال: هل الهوية الدينية بالتحديد صراعية أم تواصلية، أي قادرة على قبول الآخر، أو هل هي إقصائية (Exclusive) تماما أم قد تتضمن الآخر (Includedness) ؟ قد تتحول الهوية في السياق الديني من مفهوم اجتماعي ـ ثقافي، أو حتى مصطلح سياسي، الى جوهر ثابت، وبالتالي قد يهدده التفاعل والتواصل مع المختلف الذي قد يخلط نقاءه أو يزحزح حدوده. أولا: صناعة مجتمع العودة والنقاء العودة بعد الاغتراب. نجد هذه الصفة واضحة في الحديث النبوي الشريف (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء) وعندما سُئل الرسول صلوات الله عليه قال: (هم الذين يحيون سنتي بعد موتها). وقد حاول الكثير من الفئات توظيف هذا الحديث لحصر أنفسهم بتلك المهمة. وصفة التطهير التي تنادي بها الفئات التي تعتقد أنها المعنية بأن تنذر نفسها لتلك المهمة، تتحول الى أيديولوجيا نهمة (Greedy Ideology) أي التي لا تكتفي ولا تشبع أبدا، وتصور نفسها بحالة ضعف دائم، وعليها النهوض لتواجه قوى الشر الكثيرة المحيطة بها، فلا تكتفي بمن هم واضحين في عداءها بل تتعداهم الى صفات متدرجة في سوءها لكنها تستوجب الإزالة (الكفار، الجاهليون، الزناديق، الفاسقين، المارقين، المجذفين، أصحاب البدع الخ). ينقسم الإسلاميون أو دعاة النقاء والعودة الى المجتمع (المثالي) الذي عرفه المسلمون في فجر الإسلام الى تيارين: أحدهما يدعو الى تربية الأفراد إسلاميا بقصد خلق المجتمع المسلم، ثم الدولة التي تحكم بشرع الله. أما الآخر فيرى ضرورة البدء بالاستيلاء على السلطة السياسية، ثم يستطيع بعد ذلك فرض التغيير على الفرد والمجتمع، وبالتالي لا بد من محاربة الدولة (الجاهلة) القائمة. وهذا الاتجاه الأخير هو الذي وجد قبولا وانتشارا بين الجماعات (الإسلاموية) النشطة. وقد شاع رأي يقول بفريضة القتال ضد كل أنظمة الكفر أو الجاهلية أو الطاغوت في البلاد التي تعتبر إسلامية. وانتشر مصطلح (الفريضة الغائبة) ويقصد بها (الجهاد)*1 لقد تطور هذا المفهوم في الثمانينات من القرن الماضي لتصبح تلك الثقافة شاملة لأهداف يجب تصفيتها ممتدة الى الجوانب الفكرية والصحافية والمسرحية فكان مثلا أفراد من تلك الأطياف يتعرض للذبح والتصفية في الجزائر وكأنهم جنود كفار. هذا الآخر الداخلي، قد ظهر منذ القرن الأول الهجري، عند الخوارج وبقي مستمرا معتمدا على توكيل جماعة معينة لنفسها في تطهير الأجواء الإسلامية بحجة منع الفتنة ويستشهدون بالآية الكريمة (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الأنفال 39. ثانيا: الطريق الى التعصب والتكفير تحاول الجماعات الإسلاموية المتشددة أن تركز على وجود أفراد ممتازين ومميزين داخل الحركة، فلا يكتفون بوجود أفراد متحمسين، بل بأفراد متفوقين وممتازين (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف). وتتكرر في كتاباتهم فكرة (الاستعلاء) انطلاقا من الآية الكريمة: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) آل عمران 139. يقدم هذا النمط الجديد من التفكير نموذجا للتعصب، وليس المتحمس فقط، ومن أهم تعريفات المتعصب: (هو من يريد تدمير المجتمع المدني ليقيم مكانه هنا والآن، ملكوت الله) والفرق بين المتحمس والمتعصب هو أن الأول يعتقد أنه ملهم من الله بينما المتعصب هو الذي ينتقل باسم هذا الإلهام الى الفعل*2 يستمر الكاتب في حديثه عن اختراعات الآخر الداخلي في المجتمع العربي الراهن وما ينذر به هذا الوضع من حمل السلاح في وجه البعض من قبل البعض الآخر، ويشير الى أن أسباب ذلك، هو ضعف أداء الدولة واستيعابها للنشاط الفكري وإقناعها للناس بأنها تمثلهم على أحسن وجه بما ينسجم مع عقيدتهم ويحفظ كرامتهم. هذا الوضع يساعد على تفريخ مثل تلك الجماعات التي تستغل حالة الترهل العامة لتبشر بدورها كمنقذ وحامي لحمى الدين والوطن. هوامش *1ـ الفريضة الغائبة/ محمد عبد السلام فرج/ ملحق في كتاب: نعمة الله جنينة، تنظيم الجهاد: هل هو البديل الإسلامي في مصر (القاهرة: دار الحرية1988) ص223 وما بعدها. [ تهميش الكاتب نفسه] *2ـ التعصب سيرة كلمة/ دومينيك كولا /مواقف/ العدد65 خريف 1991/ صفحة 132و135 [ تهميش الكاتب نفسه] |
الفصل الثامن: صورة الآخر في العلاقة: مواطن/أجنبي .. ملاحظات أولية .
قدمه: بيار باولو دوناتي : أستاذ في جامعة بولونيا ـ إيطاليا من يعرف علاقة (الأنت) وحضوره، هو وحده قادر على أخذ قرار، وحر هو الذي يتخذ قرارا لأنه يواجه (الوجه). مارتان بوبر (أنا وأنت) أولا: المواطنة بما هي توسط بين هويات اجتماعية ـ ثقافية مختلفة. 1ـ إن صورة الآخر هي دوما صورة متوسطة اجتماعيا. وضمن (العوامل) التي تتوسط العلاقة (أنا/آخر) هناك شعور بالاشتراك في مواطنة عامة أو بعدم الاشتراك. فإذا ما تفطن المرء الى وجود ما يتحدى هويته (دلالتها أو معناها أو عنوانها) أدى ذلك الى تغيير رؤيته للآخر، وكان ذلك شرطا لاهتمامه بصورته. فالمواطنة هي: مقياس إدماج الأشخاص في مجموعة سياسية (أو طردهم منها) هذا من زاوية سياسية. والمواطنة من وجهة نظر اجتماعية، هي ما هو مشترك بين أفراد شعب يُشَرَعْ لهم التصرف ك(رعايا بالكامل) ضمن المجال العمومي. 2ـ علينا أن نفكر في الطريقة التي يصبح بها الآخر أجنبيا عندما يُنظر إليه (أو إليها) بما هو ليس مواطن المجموعة السياسية نفسها. ففي العقود السابقة، مثلا، شاعت لدى السكان الأصليين في شمال إيطاليا مواقف تجعلهم يستقبلون القادمين من جنوب إيطاليا كمواطنين من الدرجة الثانية، وأحيانا يتساوى بعض المواطنين مع الأجانب من بلدان أخرى. ثانيا: الأزمة الحالية للمواطنة بما هي توسط. 1ـ إن المواطنة بما هي توسط اجتماعي في العلاقة بين الذات والآخر، هي في أزمة في كل مكان تقريبا. وتظهر معالم الأزمة في أوروبا ونظرة شعوبها للمهاجرين المجنسين بجنسيات بلدان أوروبية، كما تظهر في الولايات المتحدة، وقد حسم الصراع في موضوع المواطنة بجنوب إفريقيا بعد إراقة دماء كثيرة، لإعادة تأطير وتعريف المواطنة. وإن الضمانات للاندماج المواطني (نسبة الى المواطنة) والتي حددها (مارشال) تعود حقيقة على (الحضارة Zivilisation) لا على (الثقافةKultur) . 2ـ لقد اقترح (ب تورنر) دورا للمواطنة الثقافية فقال: (هي مكونة من تلك الممارسات الاجتماعية التي تخول للمواطن المشاركة التامة والفعالة في الثقافة القومية) وإن الفهم الحديث للمواطنة الثقافية قد حملنا الى: أ ـ تغذية نوع من الاستعمار الثقافي (فالطرق التي كانت تفهم بها المواطنة الثقافية وتمارس في المجتمعات الحديثة قد جرت الى تدمير ثقافات السكان الأصليين وتهميش العادات الثقافية) [ الولايات المتحدة، أستراليا ـ مثالان] ب ـ إخضاع كل الثقافات الطبقية أو استبعادها من قبل النخب الثقافية التي تحيط بالدولة. ج ـ هيكلة المشاركة الثقافية في الثقافة الوطنية على نحو يُخفي تَعَمُد أعتى أشكال الإقصاء الفعلي. 3ـ إن اللغة التقليدية لمواطنة الوطن/الدولة هي لغة يعارضها الخطاب المقابل لحقوق الإنسان والإنسانية كأرقى نموذج معياري للولاء السياسي. لقد ثبت أن النظام الخلقي للدولة قد يفتح الطريق أمام أخلاق إنسانية كونية، وهذه النظرة دعائية قديمة وقد ثبت أنها غير موجودة والواقع مغاير للادعاء. ثالثا: أسلوبان في الإجابة: نموذج الولايات المتحدة ونموذج أوروبا. يشير نموذج الولايات المتحدة الى نظرية (البوتقة)، أي أن كل الثقافات الفرعية تستطيع العيش معا بشرط التكيف مع عقيدة وطنية! [ من يرسم خطوط شكل تلك العقيدة الوطنية؟] أما نموذج أوروبا، فيستنبط مواطنة قومية مبنية على (أسس إثنية متشابهة). هناك صلة الدم (عروق: السلوفاك والجرمان والإنجلو ساكسون) أو الارتباط المذهبي (كاثوليك أرثوذكس، بروتستانت) وكلها ادعت النضال لإعلاء كرامة البشر على أساس هويتهم كمواطنين. أي النموذجين أفضل؟ لا يبدو أن أيا من النموذجين قد يكون صالحا، فكلاهما يلاقي صعوبات كبيرة، ففي الولايات المتحدة يبدو سكون الناس اضطراريا لإبقاء فكرة التعايش المواطنية قائمة، فالعزوف عن المشاركة السياسية والاعتراف بسطوة القائمين على إدارة الدولة، هو ما يخفي التبرم الكبير لدى السكان الفسيفسائيين. أما في أوروبا، فقد رأينا الاستفتاءات في أكثر من دولة لصهر كل شعوب أوروبا في كيان سياسي واحد كيف لاقت فشلا في أرقى الدول المنادية بالمواطنة (فوق القومية) ـ فرنسا، الدنمارك. رابعا: نحو نموذج جديد في المواطنة بين الإثنيات هناك أبعاد مختلفة للمواطنة تشمل: أ ـ الحقوق الاقتصادية (قانون المحاكم) ب ـ الحقوق السياسية (البرلمان) ج ـ الحقوق الاجتماعية (رفاهة الدولة) د ـ الحقوق الثقافية (الحقوق التربوية) حقوق الإنسان. يمكننا أن نذكر إلماحتين جديدتين قد يصح اعتبارهما إيجابيتين: (أ) المواطنة التعاملية وهي تخص الجانب المشترك بين الناس في تعاملاتهم المتبادلة، وهنا يكون الطابع الإنساني أكثر من الطابع غير الإنساني. (ب) مفهوم المواطنة كمصلحة علائقية مشتركة، وهي مصلحة لا يمكن إنتاجها أو التمتع بها إلا لمن يشتركون فيها. وهؤلاء يمكنهم أن يكونوا (آخرين) بعضهم عند بعض في بداية تعاملهم ولكنهم يصبحون (نحن) بقدر ما يوجهون أنفسهم لإنتاج مصلحة واحدة. [ليتأمل القارئ الكريم، النقطة الأخيرة ويحاول إسقاطها على ما تطبق الدوائر الإمبريالية في شمال العراق والسودان وتحاول في الأقطار المغاربية، أن تعزل مصالح الإثنيات عن بعضها لتوغر صدرها في المطالبة بالانفصال. ] خاتمة لقد كانت المواطنة في الماضي، أساسا، مجموعة قبائل تتفق على معاهدة لعدم التدخل في شؤون بعضها البعض. أما المواطنة الحديثة، فقد جلبت معها شيئا أكثر: عالم كوني مشترك. ولكنها لم تنجح في وضع عامة الناس معا. لقد كانت مشغلا من مشاغل الدولة لا إنجازا من إنجازات المجتمع المدني، تقودها أفعال الحياة القصدية. أما الآن فإنه يمكن أن تصبح المدينة (مدينة الكائنات البشرية) وهذا يتوقف على كيفية تعريف العلاقات العمومية (أي محتويات المواطنة). |
الفصل التاسع: ما بعد الأحكام المسبقة ..
قدمه: روبارتو سيبرياني و ماريا مانسي .. أستاذان في جامعة روما .. الثقافة والأيديولوجيا منذ أن اخترع الفرنسي (ديستيت دي تراسي ) مصطلح الأيديولوجيا عام 1804 كعلم الأفكار، والمصطلح يتذبذب بين مؤيد له كواقع ثابت، كماركس وإنجلز وبين من استنكره واعتبره ضربا من الميتافيزيقيا التي لا حدود لها ولا تعريف واضح، وكان نابليون أول المهاجمين لمخترعي هذا النمط من النشاط الذهني. كما أن الثقافة هي الأخرى لم تسلم من اجتهاد في تعريفها، ولا تزال حتى اليوم لا يستقر لها تعريف. وكان أول تعريف أنثروبولوجي للثقافة على يد (تايلور) إذ عرفها قائلا: (الثقافة أو الحضارة في معناها الاثنوغرافي الواسع هي هذا المجموع المعقد الشامل للمعارف وللمعتقدات وللأخلاق وللعادات ولغير ذلك من جميع الاستعدادات والعادات التي يكتسبها الإنسان بما هو عضو داخل مجتمع ما). لقد انتقينا هذه المقاربة من مساهمة العالمين الإيطاليين للتمهيد لما سيقولان في موضوعهما الذي حمل العنوان (ما بعد الأحكام المسبقة). الاختلاف الثقافي عندما نحلل الثقافات والعلاقات الاجتماعية نعثر على عناصر معينة ترتبط بالوظائف الأيديولوجية وما يتبعها من عدم تسامح يظهر في مظهر سياسي. وهذا سيؤدي لتكوين أحكام مسبقة عن مجتمع أو دين أو عرق. وهذا ما يحدث إزاء نظرة الآخرين للعرب. حالتان نموذجيتان لقد درس (هال Hall) و (وايت Whyte) على سبيل المثال، دلالات نبرة الصوت والمسافة والزمن. ففي مرات كثيرة يفسر أشخاص منتمون الى ثقافة مختلفة ما يفعله غيرهم تفسيرا خاطئا: ( إن ساكن العربية السعودية يخفض صوته حتى كأنه يكلم شفتيه تعبيرا عن احترام من هو أعلى منه مرتبة، كشيخ الجماعة مثلا). فإن حصل لنا أن نخاطب أحد الأثرياء الأمريكيين بهذه الطريقة، فإن هذه الطريقة تجعل التخاطب مستعصيا تماما. فمن منظور الحضارة الأمريكية، لما يرفع المتكلم صوته يترقب بطريقة لا شعورية من مخاطبه أن يرفع صوته بدوره، لذلك فإن الأمريكي يتكلم بصوت مرتفع دائما. هذا خلاف واضح في النمطين، لا يجوز بناء موقفنا من تصورنا لمن يخالف نمطنا. النموذج الثاني: الإلحاح في منطقة الشرق الأوسط. فإن أراد أحدهم إصلاح سيارته، سيمر على المصلح عدة مرات في اليوم أو الساعة ليبين له أنه على دراية بما يقوم به ذلك المصلح، هذا السلوك موجود في العالم العربي في مختلف المجالات، في حين أنه في بلاد الغرب يعتبر عيبا. التسامح وعدم التسامح: المباعدة الاجتماعية قد نجد أشخاصا موصوفين بالتسامح، ينقلبون فجأة لغير متسامحين، وتتوه القدرة على تصنيفهم، لماذا انقلبوا؟ إن هذا يحدث عندما يتواجد الفرد داخل جماعة مستفحل فيها الفصل الثقافي، كوجود أشخاص يناصر بعضهم البعض عندما يتعرض أحدهم لغمز من طرف مجموعة ثقافية مختلفة. (هذا يحدث بوجود أشخاص ينتمون لقومية داخل وسط مغاير لقوميتهم: مجموعة عربية داخل مجتمع فرنسي في المهجر، أو مجموعة كردية داخل مجتمع عربي، أو أبناء إقليم أو مدينة داخل مجتمع مغاير الخ). العلاقة الثقافية إن السلوك الثقافي المتبادل (الما بين ثقافي) مشروط بالدور الذي تؤديه الأطراف المتقابلة أكثر مما هو مشروط بمشاعر الأفراد. وبالتبعية من الواجب الانتباه للأشخاص الذين يلعبون أدوارا يشتركون فيها مع ثقافات أخرى. يورد الباحثان حالتين للتدليل على قولهما السابق. في جريدة (لوموند) وتحديدا في 25/9/1981 في الصفحة الخامسة تورد خبرا (أصدرت الحكومة التونسية منشورين حجرت بمقتضاهما على النساء حمل الخمار الذي له صبغة طائفية) في 28/9/1981 أي بعد ثلاثة أيام نطالع في الصفحة الثالثة من الجريدة عينها (أنه يُمنع على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب دخول المطارات في إيران). إن المراقب من خارج الدائرة الإسلامية، سينظر للواقعتين بطريقة تعود الى الزاوية السياسية (الدعائية) في تفسير الدين، وهذا ليس له علاقة بنمط الثقافة العامة للمجتمع بالقدر الذي تريد الدولة تفسيره. الوحدة والتنوع في الثقافة يجوز التسليم بفرضية التنوع داخل الوحدة، كما يذهب الى ذلك معظم فقهاء المسلمين، مستندين الى قواعد (الناس يتساوون عندما يركعون أمام الله في صلواتهم، وليس في ذلك فضل لعربي على عجمي) [ هكذا ترجمة النص: ومن المؤكد أنه كان يقصد أن الناس سواسية كأسنان المشط الخ الحديث]. ويقال أيضا إنهم متساوون دائما في الحقوق والواجبات، في حظوظ العمل وأمان العيش، في العدل وفي الوضع المدني. وتؤكد الثقافة الإسلامية (أن الإسلام لا يكتفي لا بتعداد مظاهر الإخاء الإنساني ولا بإدانة التمييز العنصري بشتى صوره، وإنما يقدم لنا أمثلة واقعية مستقاة من حياة النبي (صلوات الله عليه) وصحابته وخيرة التابعين له (يعتمد الباحثان على دراسة قدمها عبد العزيز عبد القادر كامل لليونسكو طبعت في باريس عام 1970). لكن هناك من يرى أن الاضطرابات التي مر بها سواء الماضي الإسلامي أو الماضي المسيحي، لا تعني باللزوم نهاية نسق ما، وإنما على العكس هي التي تجيز له ديمومة التغير: التغير نسبة الى نفسه ونسبة الى الآخرين ونسبة الى العالم. لكن تجميع الأجزاء في الكل لا يلغي التعددية بل على العكس تماما، إنما يشترط تعاونا بين كل الهويات الثقافية. وهذا ما يؤول الى التسامح. النزاع الثقافي وفهم الذات الجماعي إن التسامح لا يَصْدُق بين الشرق والغرب فحسب، وإنما على تحول ثقافة ما من ثقافة تقليدية الى ثقافة أخرى أكثر رقيا وعالمية. هذا ما استحضره (فون غرونباوم) في الآثار الأدبية لأحمد أمين (حياتي) وهيكل (مذكراتي) و طه حسين (الأيام)، فما جاء بمذكراتهم لا يهتم بالتغريب الثقافي بل بالنزاع الثقافي داخل الإسلام. هذه المسألة أشار لها (فون غروبناوم) عن أولئك الذين يتعايشون مع العرب، لكنهم لا يقبلون بسيادتهم القومية عليهم (أكراد، أمازيغ، مصريين مسلمين) لكنهم بنفس الوقت لا يريدون التنازل عما اكتسبوه من حضارة إسلامية أسس لها العرب. خاتمة لا يزال هناك في أوروبا وأمريكا وإفريقيا من يلصق بالعرب صفات سلبية كالتعصب وتكاد لفظة (عربي ـ متعصب) أن تكون واحدة. إن التحيز في سرد الأحداث يساهم مساهمة بالغة في إبراز سلوك العرب والمسلمين في مظهر سلبي عدواني متعصب. إن الدعوة التي أطلقها (أنور السادات) لحوار الأديان الثلاثة (في سيناء) تدعو الى التسامح الديني. ولكن لماذا الحديث عن أديان ثلاثة؟ ولماذا الحديث عن الأديان حصرا؟ ربما لأن الأديان تُجَوِز لنا أن نعرف الآخرين. ولكن وعلى نحو ما قال تودروف: (لن نتوصل أبدا الى أن نعرف الآخرين. .. فسيان أن تعرف الآخرين أو أن تعرف ذاتك، فهما شيء واحد) |
الفصل العاشر: صورة الآخرين كخلفية لتصور الذات في المجتمع الروسي ..
قدمته: آنا أندرينكوفا : أستاذة في معهد البحوث المقارنة ـ موسكو تتسم مساهمة الكاتبة ـ هنا ـ بأنها جاءت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي فتحمل في طياتها سمات التحرر والانطلاق من الرقابة الموجهة التي كانت سائدة قبل تفكيك وانهيار الاتحاد السوفييتي. لكنها في الوقت نفسه، ركزت على ربط الجانب السياسي مع الاجتماعي، ربطا لم نلحظه في كتابات من سبقها. صحيح أن الكاتبة قد أخذت النموذج الروسي في بحثها، لكن البحث يمكن أن ينسحب على غير روسيا. أولا: إطلالة تاريخية على الدراسات في السياسة الخارجية. في السابق، كان اهتمام علماء الاجتماع يأخذ السياسات الخارجية للبلاد من منطلق القوالب المجترة والجاهزة. لكنه في الستينات من القرن الماضي (ال20) انكبت الدراسات الاجتماعية في هذا المضمار على دراسة العلاقات الدولية، فتناولت الدراسات أثر العوامل النفسية في العلاقات الدولية. إلا أن دراسات الستينات لم تكن لتشير ولو مجرد إشارة عابرة الى مفهوم القيمة، ومفهوم التوجهات الأكسيولوجية (نظرية القيم) ومفهوم الثقافة السياسية. ويمكن تصنيف نظرية القيم التي انتشرت في نهاية الستينات الى صنفين: الأول يعني بالإشكالية العامة لمفهوم القيم. والثاني: يعني بتحليل نتائج الاستفتاءات والاستمارات الشعبية بهدف تبيان التوجهات (القيمية) في ميادين محددة مثل قيم العمل والقيم السياسية والقيم الأسرية وغيرها. ثانيا: ما هي توجهات السياسة الخارجية؟ ستقتصر الباحثة بحثها على النموذج الروسي. فتقول: تتشكل الثقافة السياسية من جملة من العناصر الفعالة نخص بالذكر منها: مساحة بلد من البلدان، وإمكاناته الاقتصادية والسياسية، وموقعه الجغرافي، وقوة البلدان المجاورة له ومساحتها وتجاربها التاريخية في التعامل مع غيرها من الشعوب، وأثر كل ذلك في السلوك السائد فيها. ثالثا: مكانة التوجهات السياسية الخارجية في نسق القيم الشخصية. تتحدد قدرة الوعي الجماعي على التحقق من المسلمات الأيديولوجية بواسطة الاختبار والتجربة في حقل الحياة الاجتماعية. غير أن الوعي الاجتماعي ليس بحوزته (مصفاة) يمكن بواسطتها تنقية وتعديل والحكم على السلوك في السياسة الخارجية. وتتدخل هنا التجارب الفردية أو القيم الأيديولوجية أو القوالب الجاهزة التي تمارسها النخب (من الدولة والمجتمع) على الإملاءات الموجهة للمواطن المتلقي في الداخل. رابعا: صورة الغرب القومية يعود مفهوم الصورة القومية التي يحملها الفرد (أي فرد) عن انتمائه القومي الى مصدرين اثنين: الأول قديم تمثل في الدراسات التي تناولت الشخصية القومية والصور القومية على أيدي مفكرين كبار. فهم في أوروبا (مثلا) مونتسكيو وهردر. وتطورت هذه الدراسات الى ما وصلت عليه. والثاني: حديث نسبيا بدأ مع مطلع القرن العشرين، حملت معها في مختلف بقاع العالم رؤية جديدة لتلك القضية، فحولت مراكز ثقلها الى مواقع مختلفة. وكانت روسيا والروس معها مواضيع دراسات تتناول البحث في الأسباب والمنابع القيمية والنفسية التي تكمن وراء التوجهات الاشتراكية والعقيدة البلشفية. خامسا: صور الآخر ودورها في بناء الوحدة النفسية الاجتماعية. كيف يتكون الشعور بالاندماج؟ ما هي أسس اندماج (الأنا) في الجماعة؟ من الشروط الأولية لبناء وحدة بسيكولوجية اجتماعية هو (إنشاء صورة الآخر). فبفضلها تتحقق نزعة الفرد الى خلق انشطار بين (نحن) و (هُمْ) . بعد هذا التسلسل تحاول الباحثة إسقاط ما تناولته على استفتاء قام به معهد الدراسات الاجتماعية المقارنة (موسكو) مع الجمعية الأوروبية لدراسات الأنظمة (الأكسيولوجية : أي القيمية) بين عامي 1984 و 1991 وشملت 1270 شخصا تفوق أعمارهم 18 عام. لن نطيل في تحليل تلك الدراسة، لكننا سنذكر الأسئلة التي شملتها عن بعض الشعوب : هل الشعب الفلاني أهل ألفة اجتماعية؟ هل هم جادون في عملهم؟ هل هم صادقون؟ هل هم مُلَطِفون؟ هل أخلاقهم حسنة؟ هل هم محبون للسلم؟ هل هم أهل ثقة؟ هل هم أثرياء؟ هل هم مثقفون؟ 50% ممن تم استفتاءهم أجابوا ب (لا أعرف) وكانت تلك الإجابة لأكثر من شعب، بما فيهم الشعب الروسي نفسه، وكذلك كانت الإجابة عن تصور الروس عن شعوب اليابان والولايات المتحدة وإنجلترا .. فكيف يستطيع شعب تحديد صورته عن شعب آخر وهو لا يستطيع تحديد صورته نفسها؟ إن هذه الدراسة تبين لنا أن من يرسم صورة الآخر، ليس الشعوب، بل النخب الرسمية وغير الرسمية. |
الفصل الحادي عشر: الإنسان والزمن ـ الآخر .. الزمن بين أسياده وعبيده ..
قدمه: جيندريخ فيليباك .. أستاذ في جامعة براغ ـ تشيكيا شعار نهاية التاريخ يخيم على العالم: إنه شعار ما بعد الحداثة. ما يُعاين أولا هو أن الحدود الفاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، بين الشبان والكهول والمسنين، بين الزمن المعيش والزمن الواقعي، هي حدود آيلة الى الزوال شيئا فشيئا. ومع انمحاء هذه الحدود ينمحي تدريجيا معنى الفعل الإنساني ليخلي المكان لموقف آني ذي نزعة نفعية: التمتع بكل شيء هاهنا وعلى التو. ((أن نعيش الهنيهة الحاضرة هو أمر دوما عسير، ولكن لا مناص لنا منه. إن الشخصية المتفردة التي نصبو إليها لا يمكن أن تتحقق إلا في "الآن" المعيش ... وما دمنا نعيش هذا "الآن" وهذا "الهُنا"، وما دمنا نعيش هذا الحاضر، فإننا نكون أسوياء)) [ اقتبسه الكاتب من أقوال غيره ـ ألماني اسمه رينير زول]. ((لكل واحد منا شفرته (كودته) ولكل واحد منا صيغته الخاصة، ولكل واحد منا أيضا "منظره" الآني (Look) ولكل واحد منا صورته، حتى لكأننا بهذا "المنظر" منظر تكويني)) [ اقتبسه الكاتب من أقوال فرنسي اسمه جان بودريار]. أولا: أزمة تصور الزمن تتأتى الأزمة الراهنة التي يشهدها تصور الزمن من المغالاة المجحفة التي تطبع (سيرورة) الزمن، أي في نهاية المطاف تخصيص الزمن على (الأنا وحده). أي تأويل الزمن من وجهة نظر ذاتية (فردية) أو ذاتية (جمعية) .. ليس هناك في الزمن نقطة صفر مطلقة، فميلاد الشخص له هالة من الاعتبار للشخص نفسه ينظر من خلال تأريخها الى ما قبل ولادته وما بعدها، نظرة لا تعني شيئا بالنسبة للآخرين. كذلك فميلاد السيد المسيح عليه السلام يعني لمجتمع المسيحيين وأبناء الديانة المسيحية مالا يعنيه عند غيرهم، فهو بالنسبة لغيرهم يوم من الأيام. كل (ما بعد) له (ما قبله) وكل ما بعد سيصير الى (ما قبل) بعد اكتشاف ما يبهت صورته البهية. ولو استمعنا لأحاديث أناس مختلفين لوجدنا: أحدهم يقول: الماضي أفضل مما نحن فيه. وآخر يقول: المستقبل سيكون أفضل من الحاضر. وواحد يقول: إن ما موجود اليوم ليس بعيدا عما كان موجودا في السابق. فيجيب الزمن: أنتم جميعا لا تسلمون بوجودي أنا [ اقتبسها الكاتب من فيلسوف صيني اسمه Lu Xun عام 1918] ثانيا: أسياد الزمن وعبيده ليست مناقشة تصور الزمن مسألة أكاديمية تهم حفنة من الفلاسفة، بل جميع الناس، فعليها يتوقف فهم القضايا الأم التي تواجهها الإنسانية. إن أزمة تصور الزمن واستخدامه تعتمل في قلب عالم يتطور فيه متوسط عمر الإنسان ويتقلص وقت العمل . كان متوسط أعمار الرجال بين عامي 1950ـ 1954 (العالم: 44.8 سنة ، البلدان المتقدمة 63 سنة، البلدان النامية 40.3 سنة) وبين عامي 1990 و 1994 كان (العالم 61.1 سنة، والبلدان المتقدمة 71.2 سنة والبلدان النامية 59.5 سنة). وخلال عقد من الزمن (1980ـ 1990) تقلصت مدة العمل بالسنين من 45 سنة الى 38 سنة، ونسبة الى العام الواحد من 307 أيام الى 250 يوما، وبالنسبة الى ساعات العمل من 10 ساعات الى 8 ساعات. تبين بعض البحوث الجادة أنه على الرغم من تمديد وقت الفراغ، فإن قسما مهما من السكان يشكو من نقص في الوقت ومن شعوره بالضيق تحت وطأة الحياة العصرية المتقلبة داخل التجمعات السكنية الكبرى على وجه الخصوص. لكن ورغم ما يسمى بالعولمة التي ننتقي وظيفة لها هنا بتطلب الحلول المتشابهة لكل مشاكل العالم، فلا يجوز أن نكتفي بفرحنا في تهدم جدار برلين، في الوقت الذي تقام فيه جدران مختلفة في أنحاء متفرقة من العالم. وعليه فإن نظرة الناس للزمن المستقبلي تختلف من مجتمع لآخر ومن شريحة لأخرى. إن الشرائح الاجتماعية الوسطى تؤجل إشباع حاجاتها الى وقت لاحق. في حين تنزع الشرائح الدنيا الى إشباعها في الوقت الحاضر. أما الأغنياء فيستحوذون توا على كل شيء ويستمتعون به. إن الناس المنكبون على اللحظة الراهنة هم أولئك الذين يجدون أنفسهم مدفوعين نحو مستقبل رسمه لهم غيرهم من الناس. إن المهن غير المؤهلة وغير المتخصصة لا تتطلب من المعارف المكتسبة مسبقا إلا النزر القليل. أما المهن ذات التأهيل الراقي، فتتطلب الأمرين معا (أي المعارف والقدرة على التوقع). إن كل حقبة من الزمن، وكل أمة وكل فرد له منظوره الزمني المخصوص: فالبعض يقيس الزمن بمقياس (النانوثانية : أي جزء من مليار من الثانية) في حين هناك أقوام لا تحتاج لشراء الساعة ذاتها، ما دامت وتيرة حياتهم لا تحتاج إليها. ثالثا: تملك الزمن في مفترق الطرقات من حسن الحظ أن الأزمة ليست تفككا فحسب، وإنما هي أيضا تربة خصبة منها تنبثق إمكانات الانطلاقة الجديدة. ففي أحيان كثيرة لما تشتد الأزمة توفر الشروط لميلاد الأفكار الجديدة والقوى الكفيلة بحلها. والأمر هو عينه بالنسبة لتصور الزمن: 1ـ ليس من الممكن للإنسان أن يصير سيد الزمن بلا نهاية، أي أن يصير سيد الطبيعة، من دون أن يدرك أن ما يأتيه من أعمال لا معقولة (كإهلاك الغابات الطبيعية) من أجل الربح الوفير والسريع سيؤدي الى حدوث كوارث بيئية تلحق الأذى بالسيد وسيادته. 2ـ كما أن المرء لا يمكنه أن يكون حرا عندما يدوس حرية الآخرين، كذلك لا يمكنه أن يكون سيد زمانه عندما يفتك بزمن الآخرين. |
الفصل الثاني عشر: أصل الشغف بالآخر لدى حركات الأنتلجنسيا الطلائعية في أوروبا..
قدمه: جوزي أنطونيو غونزاليس آلكنتود.. مدير مركز البحوث الإثنولوجية في جامعة غرناطة ـ إسبانيا .. عندما ندرس التيارات التاريخية والفنية والأدبية بأجيالها المتعاقبة في أوروبا نعاين أنها عاشت ضربا من الزهد الفكري باعتباره تحررا من الموانع القسرية التي يقيمها المجتمع البرجوازي، لتنخرط في عالمها الاجتماعي. وقد جاء التحرر من تلك القيود والموانع على ثلاث دفعات: التحرر الأول الذي تعزى نشأته الى التحليل النفسي (الفرويدي) على أيدي السرياليين*1 ومن بينهم (دالي). والتحرر الثاني انخرطت فيه معظم التيارات ومن بينها النزعات الدادائية*2 والتحرر الثالث: هو التحرر من الشكل، وقد انتشر هذا اللون من التحرر عند أنصار التجريد الهندسي المتمثل بأنماط الأبنية الحديثة وما صار يدخل في عالم تصنيع السيارات والأجهزة وحتى الملابس. من هنا وصف (إريخ كاهلر) ذلك بقوله: (لم يعد اللاوعي مجرد موضوع تتقصاه أفعال الوعي الاستكشافية، وإنما هو مستحوذ على العمل الفني وصار مشرعا للإبداع الفني) (1) أحست الطلائع الثقافية الأوروبية بعدم الاطمئنان لواقع الحضارة الغربية، فانبثقت لديها الحاجة لوجود (آخر) ذو نزعة بدائية، ليكون النشاط ضد هذا (الآخر) مصدرا لإلهام جميع الحركات، فكانت حالات الشغف بالاستشراق للتعرف على الوجه المتوحش والبربري للشرقي. فكانت تظهر أبحاث أوروبية مطولة تتحدث عن زيف الأقنعة التي تصنعها القبائل الإفريقية، ودخلت خطوط الأقنعة في لوحات الفنانين الغربيين كما دخلت ولا تزال في تصور أشكال أبطال الأفلام الخيالية والرسوم المتحركة. (2) لقد أشار (هيالسنبيك) أحد الدادائيين، الى أهلية من يريد أن يتكلم عن غيره من الشعوب الى أن يكون ذو (دربة) والدربة هنا هي المران [ أو الخطيطة بلغة ريف حوران، حيث تكون آثار الأقدام واضحة على أرض غير معبدة أو مزفلتة، فتكون الآثار هي الدليل للآخرين أن يمشوا على أثر من قبلهم في الخطيطة]. ويبالغ أحدهم(أنطون آرتو) في وصف إمكانياته بقوله: (بعد انتظار، مكثت على حالي، فلم أرجع بعد الى نفسي) يشير هنا الى كيفية عيش حياة من نذر نفسه لدراستهم. لقد رأينا آثار تلك الأعمال الفكرية، في الأفلام السينمائية التي انتشرت في القرن العشرين، فلم يأل كاتب القصة أو المخرج أو مجهز العمل السينمائي بالأزياء والأدوات والمساكن الخ، في تصوير الآخر أينما كان بالطريقة التي انطلقت في مراحل التحرر التي ذكرناها، سواء تكلموا عن الهنود الحمر (في أفلام الكاوبوي) أو تكلموا عن بلاد الغرائب، كما أنهم لم يوفروا جهدهم في تصوير الديانات التي لا يكنون لها احتراما، وقد ساهمت تلك الأعمال الفنية والإعلامية في تأسيس خطوط الرسم الحضاري التي تكلم عنها (صاموئيل هانتنغتون). مع اندثار الحركات الطلائعية ذات الوجود الصوري وزوال اهتمامها بالآخر، صارت مسألة (الآخر) تنطرح في حقلي الفلسفة والسياسة). وبعد سنين طويلة جاءت مرحلة تصفية الاستعمار، أنكر بعض الكتاب الغربيين على الغرب نزعته المركزية الشاملة فقال (فانون) : (لم تعد التهمة موجهة فقط الى أصحاب البنوك، والى أصحاب الشركات المتعددة الجنسية، بل الى المبشرين ورجال التعليم والكتَاب الغربيين والسياح أيضا). (3) إن الشغف بالآخر مثله مثل الشغف بالذات يطرح نفسه في الدوائر المثقفة وهو خال من البراهين الكلية. فالشغف بالآخر كان بالبداية خياليا وموهوما، كما كان مقصورا على حقل الاستشراق. لقد تحول الحب الذي يكنه الغربيون للشرق الى إيهام خيالي بوجود جنات شرقية ذات مصداقية جغرافية وتاريخية، وبالتالي فإن الشغف بالشرقي هو أولا وقبل كل شيء صفة من صفات النخبة. (4) النتيجة من الصور السابقة، هو أن تحول الخطاب الغربي الى نهج مليء بأخطاء تدخلت في شكل السلوك السياسي. وفي الحقيقة أن الصور المتكونة ـ حتى عند النخب ـ ما هي إلا هراء لا قيمة عملية له. وهذا قاد وسيقود الى أن يتوارى هذا الخطاب تحت التراب وانحلال الخطاب نفسه وتفككه. لأن ذلك كما أسلفنا هو نتاج النخب الحالمة. انتهى القسم الأول هوامش *1ـ السريالية "أي ما فوق الواقعية أو ما بعد الواقع" هي مذهب أدبي فني فكري، أراد أن يتحلل من واقع الحياة الواعية، وزعم أن فوق هذا الواقع أو بعده واقع آخر أقوى فاعلية وأعظم اتساعاً، وهو واقع اللاوعي أو اللاشعور، وهو واقع مكبوت في داخل النفس البشرية، ويجب تحرير هذا الواقع وإطلاق ما مكبوت فيه وتسجيله في الأدب والفن. *2ـ الدادائية: حركة فكرية فنية انبثقت في سويسرا عام 1916 لمعاداة الحرب العالمية الأولى والحروب بشكل عام، ولم يعرف أحد أصل اشتقاق الكلمة، إلا أنها كما يبدو من نشاط القائمين على تلك الحركة شبيهة بلفظ (دادا) عند بعض المناطق العربية التي تقال للطفل، فهي تعبر عند أصحاب الحركة لطلب الأمان والسلام والابتعاد عن الحروب. |
القسم الثاني: ما وراء الحدود: نظرة العرب الى الآخر ..
الفصل الثالث عشر: الآخر في الثقافة العربية .. قدمه: الطاهر لبيب (المحرر للكتاب) يستخدم الكاتب هنا مصطلح الثقافة العربية، دون (الثقافة العربية ـ الإسلامية)، التي لا يرى الكاتب مبررا للربط بينهما، بزعم أنهما بعدان مختلفان، فعندما يقال أن الإسلام ثقافة المجتمع، فليس هناك إضافة، كالقول عن الثقافة المسيحية في المجتمع الأوروبي، أو الثقافة البوذية في المجتمع الهندي، وأن إضافة إسلامي للمجتمع العربي المعاصر، هي صنيعة من صنائع المستشرقين لغايات معينة. ويعتبر بحث الكاتب أطول بحوث الكتاب، حيث يقع فيما يزيد على الأربعين صفحة، وهو أول البحوث الواقعة في القسم الثاني من الكتاب، ومن الصعوبة بمكان الزعم بأنه في المقدور أن يقدم هذا البحث في حلقة واحدة، أو أنه يقدم دون المساس بترابط المعلومات فيه. المشهد الأول لقد تناول الباحث دوافع الرحلات العربية الى أوروبا في العصر الحديث مبتدءا برفاعة الطهطاوي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) ومارا ب (محمد بلخوجة التونسي) في (سلوك الإبريز في مسالك باريس الصادر عام 1900). ثم يتناول الباحث ما قدمه (حسن حنفي في جدل الأنا والآخر). يذكر الباحث أن الصورة تكون حاضرة عند الزائر أو الرحالة أو المكتشف، دون أن تنتظر تقديم الصورة لنفسها، فكولومبس عندما اكتشف أمريكا أصر على أن الشعب الذي قابله هو (هندي!) وأبقوا صفة (الهنود الحمر) على سكان تلك البلاد الى اليوم. وهذا يحدث أن إسقاطات الكاتب أو المدون تلازم ما يكتب عنه، فمن يكتب عن الحيوانات (كليلة ودمنة) تكون صفة الأنسنة وعقل الكاتب ظاهرة فيما يكتب. ومن يكتب عن شعب يزوره، يحاكمه وينتقده ويصوره ضمن مفاهيم من يكتب، فرفاعة الطهطاوي مثلا، عندما يخرج من القاهرة حيث يسميها الناس هناك باسم (مصر) فإن باريس لديه هي (فرنسا) [أول رحلة للطهطاوي كانت 1826]. وهنا تحدد (الأنا) جغرافية الآخر. كما أن التداخل التاريخي لمن يزورون الغرب أو يتعاملون معه، هو من التعقيد بمكان، فنحن عندما نتذكر التاريخ الهجري بأننا في القرن الخامس عشر وفي التاريخ الميلادي القرن الواحد والعشرون، يتهيأ للبعض أننا نتخلف عن الغرب بما يزيد عن ستمائة سنة. الذات العربية (الأنا العربية) تعرب الآخر، هنا يذكر الكاتب ما توصل إليه (حسن حنفي) في إظهار الآخر وكأنه أحد المحتويات للأنا العربية، سواء من حيث اللغة (كما تناوله الطهطاوي في ترجماته الفرنسية للعربية). من الذي اخترع الآخر: الشرق أم الغرب؟ كما أن الغرب هو من اخترع شرقه، فإن الشرق هو اخترع غربه. ويتطير العرب من تناول الغرب (المستشرقين بالذات) للصورة التي يقدمونها عن الشرق والعرب بالذات، فيصفون الغرب بالتحامل على الشرق وعلى المسلمين والعرب، وينتقون فقرات مما يقدمه المستشرقون على صفحات الكتب والجرائد والتقارير والأفلام السينمائية والتلفزيونية. لكن العرب لا ينتبهون الى ما يكتبونه ويصورونه عن الغرب، ولو انتبهوا وقارنوا ما يكتبون عن الغرب لرجحت كفة ما يكتبه العرب من سوء الغربي عما يكتبه الغربي عن مساوئ العربي. لقد انتقى الكاتب جزءا مما كتبه (فؤاد زكريا) بمجلة (التبيين/ الجزائر 1992) واختار مثلا تونسيا دارجا (اليهودي إذا ما لقيت ما تعمل له اعفس على ظله). إن كان العرب يستنكرون على الغرب أن يقول عنهم ما يسوءهم، فهم يتغاضون عما يقولون عن أنفسهم، ففي كتابات ابن خلدون عن العرب ما يتفوق على ما قاله الغرب عنهم. وإن كان هناك من سيقول: أن ابن خلدون كان شاهدا على خفوت حضارة العرب فكانت كتاباته تأخذ ذلك الشكل الغاضب، فإن كتابات حديثة كالتي كتبها (حسين احمد أمين) في جريدة الحياة في 28/10/1997 صفحة 19، حيث قال: (العرب في واقع الأمر شعب لا يحسن غير التشدق بالكلمات). ثانيا: المشهد الثاني تعود المستشرقون، وعودوا غيرهم على استعمال المقابلة بين الإسلام والغرب، وبدرجة أقل بين الإسلام وأوروبا. وهي مقابلة في أحد أطرافها يتواجد المضمون الديني، في حين يكون في بعض الأحيان سياسيا أو جغرافيا. تساءل بعض الفلاسفة والمفكرين: عن سر الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مواقفهم تجاه بعضهم، أشار البعض أن توجه المسيحيين الى معرفة الإسلام ليس مرده التسامح المسيحي، لأن الإسلام كان أكثر تسامحا. كما لم يكن الغاية منه الأخذ عن المسلمين، لأن هذه المسألة انتهت منذ الحروب الصليبية، فلم يبق عند العرب والمسلمين ما يتفوقون فيه على المسيحيين من علوم وغيرها. هذه النظرة كانت لدى المسلمين في السابق، حيث أن حضارتهم كانت الأرقى في العالم، فماذا سيأخذون من الغرب؟ يستنتج من يبحث في هذه المسألة بأن حب المعرفة هو ما يدفع الغرب الى التعرف على الحضارة العربية والإسلامية. في حين أن العرب والمسلمين في الوقت الحاضر يتعاملون مع الغرب للاستزادة من علومه.[الباحث هو:برنارد لويس]. عمق الحضارة العربية هو وراء اهتمام الآخر رأى (بروديل) أن الإسلام هو قبل كل شيء وريث الشرق الأدنى بثقافاته واقتصادياته وعلومه القديمة (حضارات وادي الرافدين والنيل واليمن والشام) ويؤكد أن قلب الإسلام فضاء محصور بين (مكة والقاهرة وبغداد ودمشق). هذه النظرة يتشارك فيها معظم فلاسفة التاريخ (أوزوالد اشبنغلر وأرنولد توينبي)، لذا فإن التعرف على الحضارة العربية (كآخر) للغرب، يعني التعرف على حضارات تورثها العرب وانسيابها في سلوك أهل المنطقة واحتلالها مكانة في بواطن الثقافة. إن الرجوع الى الجاحظ (868م) والى التوحيدي (1010م) والى صاعد الأندلسي (1068م) يؤكد ثوابت هذه الصور المنمطة وتأسيس النظرة للآخر من زاوية (عربية). العرب يتعاملون مع الآخر الدخيل بمنتهى الدقة كان المسلمون (العرب) ولوقت طويل أقلية في البلدان التي حكموها، فضلا على أن العرب في بلاد العرب (العراق، سوريا وحتى إيران) لم يعتنقوا الإسلام حتى القرنين الثاني والثالث الهجريين. ومع ذلك اشترك غير المسلمين في ترسيخ أسس النهضة العلمية (ترجمة، طب، فلك). ومما يذكر أن عامل هشام بن عبد الملك على العراق قد بنى لأمه (النصرانية) كنيسة. وأن من أعجب الظواهر في أيام العباسيين الأوائل أن تفتح مراكز تبشيرية للنصارى في الهند والصين تحت رعاية الدولة العباسية الأولى( تاريخ العرب: فيليب حتي ص 424). لقد انتبه العرب لأثر الدخيل منذ الفتنة بين المأمون والأمين، وعلموا أن الدخيل (غير العربي: الأعجمي) ممكن أن يساعد في إثارة الفتن بين العصبيات العربية لإضعاف مكانتها في الحكم, وهو ما أصبح يطلق عليه (الشعوبية). ثالثا: المشهد الثالث: الآخر يصبح غربا لا تطول الذاكرة تجاه (الآخر) غير (الغربي) فالتعامل مع المغول بتاريخهم وغزوهم للعراق وتدميرهم للدولة العباسية، ضاع أثره والحقد على من قام به، بعد أن اعتنق المغول الإسلام وذابوا بين شعوب المنطقة. في حين تبقى النظرة ممزوجة بالحقد تجاه الغرب الذي (استعاد) حكم إسبانيا والبرتغال (الأندلس) وتبقى ذاكرة الحروب الصليبية قائمة. وقد كانت الحروب الأخيرة مثالا قائما على ما نذهب إليه، فبالرغم من اشتراك الكثير من دول العالم في العدوان على العراق، فإن ما يتذكره أو يذكره المواطن العربي هو الدول الغربية، ولا يذكر كوريا أو اليابان أو جورجيا، ويتناسى مساعدة العرب للغرب في غزو العراق، لأن مساعدتهم طارئة والثابت الآخر هو الغرب وحده. |
كاعادتك مميز فى موضوعاتك
هذا فيه من المغزى الكثير ويحتاج لقرأته بتمعن تقديري لما تقدم لنا ففيه كثير الافاده نلتقي على خير دوما لا اله الا الله |
حياك الله أخي الفاضل نزار
شاكرا لكم مروركم الكريم |
الفصل الرابع عشر: صورة الإفريقي لدى المثقف العربي: محاولة تخطيطية لدراسة (ثنائية قبول/استبعاد) ..
قدمه: حلمي شعراوي .. مركز البحوث العربية ـ القاهرة . يشكل موضوع (السود) في الثقافة العربية مشكلة كبيرة لا تختلف كثيرا عن تلك التي تحيط بموضوع المرأة. فهو موقف مرتبك بين الاعتذار عن السلوك تجاه هاتين المسألتين انطلاقا من سماحة الشرع والتعامل الديني الإسلامي مع هذين الموضوعين بشكل إنساني يشهد الجميع به حتى أعداء الإسلام، وبين موقف أو مجموعة مواقف مستمدة من التراث العربي قبل الإسلام وغيره من الروافد التي ورثتها الأمة. أولا: إيضاحات تعريفية: 1ـ يحس العرب بأن لسانهم الذي نزل به القرآن، وكتبت به العلوم الشرعية واللغوية والتطبيقية سواء بأيديهم هم أو بأيدي من دخل الإسلام من غير العرب، يعطيهم الحق في إسقاط نظرتهم لمختلف المسائل على غيرهم من الأمم التي دخلت في دين الله الذي نزل بلسانهم! ومن بين تلك المسائل ما يخص نظرتهم للزنوج والأحباش وغيرهم، التي تكونت لديهم قبل دخول العرب في الإسلام. 2ـ سوسيولوجيًا، ترتبك النظرة العربية بين القبول والاستبعاد للآخر الإفريقي، ولن يصمد تفسير السلوك (التصويري) العربي تجاه الإفريقي أو الآخر المسلم، الذي حث الله عز وجل في كتابه على اعتباره أخا، كما حث الرسول صلوات الله عليه على مثل ذلك. وفي نفس الاتجاه يميل العربي لقبول الآخر المسلم (عجمي، إفريقي، كردي) في حالات الإنجاز العلمي أو الفلسفي أو العسكري (ابن سينا، الفارابي، يوسف ابن تاشفين، صلاح الدين الأيوبي). من ناحية أخرى، تمتلئ الثقافات العربية أو المترجمة بتبرير السلوك المتعالي لعرق تجاه آخر، اليونانيون والبرابرة (أي غير اليونانيين الواقفين على حدودهم)، المكتشفون الأوروبيون لأمريكا وسلوكهم مع الهنود الحمر، الإيطالي الشمالي ونظرته لأهل جنوب إيطاليا. وقد تحدث عن ذلك باقتدار وتفصيل كل من (جرامشي) و(إدوارد سعيد). 3ـ قد يكون ما كتبه ادوارد سعيد حول هذه المسألة الأحدث والأشمل والأوسع إجابة عن ما هو معروف ب ((الثقافة الامبريالية))، حيث يتحدث عن أنماط من الكتابات الأوروبية وخطابها الاستشراقي أو نحو نظرتها الى إفريقيا والهند، إن مجموعة المؤلفين الذين اختارهم إدوارد سعيد ليكتب عن كتاباتهم يؤكون فيها أن استعمار بلادهم لغيرها كان من أجل نقل الحضارة لها، وعندما يكون الحديث عن رفض تلك الشعوب للاستعمار وثورتها ضده وردة فعل الغرب في قمع تلك الثورات، فإن الكتاب يقولون: ( إنهم برابرة .. ليسوا مثلنا .. ولذا يستحقون أن نحكمهم ونجبرهم على القبول بنا كأسياد عليهم)! (كونراد) .. وكونراد هذا، معروف بأنه معادٍ للإمبريالية! 4ـ إن علاقة ما ذكر سابقا بالكيفية التي ينظر العرب فيها الى الآخر، هي أن العرب كانوا في عينة من الوقت ينظرون الى غيرهم من الشعوب التي حكموها بأن حكمهم لتلك الشعوب رحمة لها وإنقاذا لها من جهلها. وبغض النظر عن صحة تلك المعلومة من عدمها، فإن تلك النظرة عاشت ولا زالت تعيش في نمطية تفكير المثقفين والكتاب العرب، ومن يطلع على أدب (الرحلات) سيجد أن الرحالين العرب ينظرون الى المناطق التي زاروها وفق ما ذكرنا. ثانيا: ظروف تأسيس الصورة: صراع/استبعاد كان لمجاورة الحبشة (إثيوبيا) لبلاد العرب الدور الكبير في تأسيس صورة الإفريقي عند العربي. وخصوصا أن الاحتكاك العربي الحبشي استمر زهاء سبعة قرون، بدأت قبل ميلاد المسيح عليه السلام بقرن من الزمان، وقد وجد ما يدل على ذلك في نقوش أكسومية تعود الى (مملكة الشجرى الأثيوبية) قبل المسيح بقرن، حيث نجد أن الملك الحبشي يذيل اسمه وتوقيعه ب (ملك أكسوم وحمير وريدان وحبشة وسلع وتهامة)*1 وانتهت بإحلال الفرس والروم محل الأحباش المستعمرين والحاكمين لجنوب جزيرة العرب (اليمن) والطامحين في محو رموز العربية في الشمال (مكة ـ وغزو أبرهة الأشرم). ويذكر الجاحظ في كتابه (فخر السودان على البيضان)*2 على لسان الزنج أنهم قالوا: (نحن قد ملكنا بلاد العرب من الحبشة الى مكة وجرت أحكامنا في ذلك أجمع، وهزمنا ذا نواس وقتلنا أقيال حمير، وأنتم لم تملكوا بلادنا. وبعد أن اندثرت قوة الأحباش وتشتت جموعهم، تحول كم هائل منهم الى عبيد أو مقاتلين مستأجرين لتجار مكة ومن حولها، وقيل لقد أعتق الزبير بن العوام وحده ألفا من العبيد الأحباش*3 لقد اتسمت معاملة العرب للسود بالتجاهل وليس بالعداء أو الاحتكار والتفاخر عليهم. فلم يجد أي باحث في المعلقات السبع ما يشير الى ذكر السود بسوء أو انتقاص. ويشير التاريخ أن السود لم يكن منهم شعراء كثر ويذكر التاريخ منهم أربعة أو سبعة، إذ أن الشعر كان له وظيفة النطق بلسان الشاعر عن قومه أو قبيلته، في حين أن السود إن نظموا الشعر لا يذكرون قبائلهم ولا يقولون: نحن بل (أنا) وهذا ما نلاحظه بشعر عنترة و خفاف بن ندبة وسليك ابن السلكة وأبو عمير بن الحباب السلمي. فهذا عنترة يقول: ينادونني في السلم بابن زبيبة .......... وعند صدام الخيل بابن الأطايب ويقول في موضع آخر: وأنا الأسود والعبد الذي .......... يقصد الخيل اذا النقع ارتفع نسبتي سيفي ورمحي وهما ......... يؤنساني كلما اشتد الفزع ثالثا: عصر الإمبراطورية العربية ـ الإسلامية : قبول/استبعاد أحس العرب أنهم قاموا بتأسيس ما يشبه (العولمة) في إمبراطوريتهم الواسعة، والتي لم يكن للعرب ذكر في اسمها، ولكننا نناقش تلك المسألة في لحظة معاصرة وبأدوات تقييم متأثرة بما يدور حولنا. حقا كانت السمة الإسلامية سائدة على وصف تلك الإمبراطورية، لكن لم تختف من تلك الأجواء المفاخرة العرقية، ففي حين كان يشعر العربي بأن الفضل في تأسيس أركان تلك الإمبراطورية يعود له وحده، دون مشاركة أقوام أخرى من غير العرب، فهم من هدموا أركان الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية دون مشاركة أحد. بالمقابل، فإن أقواما أخرى تتطير من إلصاق العروبة بالإسلام على النحو الذي يبرز دور العرب بشكل استثنائي، بل تذهب تلك الأقوام الى أبعد من ذلك حينما تربط التطور العلمي والأدبي والفلكي والفلسفي بما أتت به كأمم اعتنقت الإسلام ولها ماض حضاري عريق (الفرس) أو كقوى لها دورها في الفتوحات العسكرية وتثبيت حدود وشكل الإمبراطورية، (ترك، كرد، أمازيغ). هذا الأمر جعل العرب يزيدون من تفاخرهم، وإرجاع فضل تلك الثورات العلمية لهم هم كحاضنة أو رافعة هيأت لجهد المجتهدين. ومن يشكك بهذا القول رماه العرب بوصف (الشعوبي). لنعد الى الأفارقة، وطبيعة التعامل العربي معهم: لا شك أن ما مررنا عليه لوصف النظرة العربية تجاه الآخر الأفريقي، هو من الأهمية بمكان، بحيث أن مناطق إفريقية سوداء دخلت في الإسلام وتحت كنف الدولة المركزية لكنها لم تحظ بقدر كاف من الرعاية لها، وهذا من وجهة نظر الأفارقة آت من الإهمال المتعمد أو الشعور بالتعالي أو الاثنين معا. والأفارقة محقون بذلك، فقد عرف العرب مثل ذلك السلوك على أيدي الأتراك، عندما اعتنوا بحواضرهم وأهملوا حال المدن والقرى العربية. مستويات متعددة من موقف الدين أو وصفه للسود: 1ـ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (الحجرات 13)(الدعوة للالتزام بالمساواة بين المسلمين) 2ـ الناس سواسية كأسنان المشط .. .. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى (تأكيد موضوع المساواة) 3ـ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف 2) .. تخصيص للعربي 4ـ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (التوبة 24) أحقية الفاتح على المهزوم. 5ـ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه(آل عمران 106).. و (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين (الزمر 60) و (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا) النحل 58 إن تفسير تلك الآيات من لدن العلماء لم يشفع كثيرا في إزالة بعض الأذى الذي يلحق بالسود. كما أن تلك القصة التي تظهر بالتوراة وتتناقلها كتب التاريخ العربي من أن (حام) جد السود كان ينظر الى عورة أبيه (نوح) عليه السلام وقد وشى (سام) بذلك لأبيه فدعا عليه بأن الله (يسود وجهه)! لقد كتب أستاذ إفريقي مجتهد هو (آرشي مافيجي) عن تلك النظرة المتوطنة عند غير السود تجاههم شيئا جميلا يهمنا منه ما أطلق عليه: القيمة الاستعمالية (Use Value) وهو مصطلح استبدل به مصطلح (فائض القيمة) في الكتابات الاشتراكية. سنكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع. هوامش: *1ـ بين الحبشة والعرب/عبد المجيد عابدين/القاهرة: دار الفكر العربي 1947 *2ـ رسائل الجاحظ/ كتاب فخر السودان على البيضان/أبو عثمان الجاحظ/ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون/بيروت: دار الجيل 1991 *3ـ التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الاسلام/ الحبيب الجنحاني/ بيروت: دار الغرب الإسلامي 1985 |
الفصل الخامس عشر: جدل الأنا والآخر: دراسة في تخليص الإبريز للطهطاوي
قدمه: حسن حنفي : أستاذ ورئيس قسم الفلسفة ـ جامعة القاهرة. أولا: مقدمة، الموضوع والمنهج. كانت الحضارة الإسلامية عبر التاريخ في علاقة مستمرة مع الحضارات المجاورة، اليونان والرومان غربا وفارس والهند شرقا، قبل الإسلام وبعده، بل إن إبداعات الحضارة الإسلامية هي نتيجة لهذا التفاعل بين الداخل والخارج، بين الموروث والوافد، بين النقل والعقل، بين علوم العرب وعلوم العجم، بين علوم الغايات وعلوم الوسائل، أو بلغة العصر بين الأنا والآخر. في الفترة الأولى كان الآخر معلما والأنا العربية الإسلامية متعلما، وفي الفترة الثانية كانت الأنا العربية الإسلامية معلما، في حين كان الآخر متعلما، ثم جاءت الفترة الثالثة ليعود العربي المسلم متعلما على يد الآخر المعلم. في شرح حسن حنفي وتعليقه على كتاب الطهطاوي (تخليص الإبريز) يحاول معاينة العربي لصورة (نفسه) في مرآة الآخر الغربي على لسان الطهطاوي. ثانيا: الأنا إطار جغرافي للآخر. رغم أن كتاب الطهطاوي كان المقصود منه وصف الآخر (باريس)، من منظور (متمركز) في القاهرة أو الإسكندرية، ليعمم الآخر الأوروبي على حالة أهل باريس، من منظار من يزعم أنه يمثل الشرق العربي أو حتى الإسلامي. فلا باريس كل فرنسا ولا فرنسا هي كل أوروبا، حيث أن في أوروبا أنماط مختلفة بما فيهم المسلمين في شرقها الذي كان منه جزء من الدولة العثمانية (آنذاك)، وكذلك ليس القاهرة هي كل العرب أو كل المسلمين، فهناك أنماط متعددة من الشرق، الذي سيضم بين ثناياه (الدولة العثمانية) بجزء أوروبي من جغرافيتها! هذا النهج بدا جليا لا في كتابات الطهطاوي فحسب، بل سبقه إليها من هو أقدم منه، فظهرت بالتراث القديم من خلال كتابات السيوطي في كتابه (منتهى العقول) وكتابات أبي الفداء في كتابه ( تقويم البلدان، وكتابات حاجي خليفة في كتابه (كشف الظنون) وكتابات الخوارزمي في كتابه ( غريب الإيضاح في غريب المقامات الحريرية) والمسعودي في كتابه (مروج الذهب). وكذلك فإن الكتاب الغربيين قد تناولوا الشرق بنفس الروحية وكان هذا واضحا في كتابات البارون دي ساسي في كتابه ( تاريخ الدول) الذي ترجمه للعربية ابن الكرديوس. هذا النهج الذي اتبعه كتاب الشرق والغرب في نظرتهم للآخر أثر ولا يزال يؤثر في تحديد السلوك شعبيا ونخبويا لكل طرف تجاه الآخر. فلا زال المواطن والواعظ على المنابر ينظر للغرب على أساس أنه (غرب واحد)، فبلغاريا في نظر العربي لا تختلف كثيرا عن فرنسا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران في نظر الغرب و الصهاينة هي كالمغرب والعراق و باكستان! ثالثا: الأنا مرجع تاريخي للآخر يضع الطهطاوي الأنا في مسار تاريخها الهجري، ويلحق مسار تاريخ الآخر قبل أن يحدث الاغتراب في الوعي العربي الإسلامي ويصبح مسار تاريخ الآخر هو المرجع التاريخي لمسار تاريخ الأنا، فهذا الطهطاوي نفسه يؤرخ لسفره لفرنسا: خرج الطهطاوي من مصر في 8 شعبان 1240هـ الموافق 1826م. في حين كان العرب يؤرخون لاكتشاف أمريكا بخروجهم من الأندلس، وأرخوا فيما بعد عن الثورة التي حدثت في فرنسا بين أنصار الملكية وأنصار الجمهورية، فأرخوها مع الثورة الهمامية في صعيد مصر التي قادها شيخ العرب (همام) مع الفلاحين العرب ضد الدولة. رابعا: الأنا والآخر في المرآة الاجتماعية يتم وصف الأنا والآخر في مرآة الحياة الاجتماعية، وفق الحالة التي يتحدث بها الكاتب، فيكون الآخر منضبطا دقيقا ويكون الأنا منفلتا لا يحترم القوانين، وتكون النساء عند الآخر غير عفيفات بما فيه الكفاية وأزواجهن غيرتهم قليلة. ويكون الاختراع والعمل عند الآخر والكسل والخمول عند الأنا، ويكون البخل وعدم رغبة الآخر في مساعدة غيره، في حين يكون الكرم وحب المساعدة للغير عند العربي. وهكذا مئات بل آلاف الثنائيات التي استخدمت اجتماعيا ولا زالت. خامسا: الأنا وتعريب الآخر لما كان التقابل بين الأنا والآخر هو تقابل لغوي، بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، فقد استطاعت الأنا تعريب الآخر أكثر مما استطاع الآخر فرنسة الأنا. فعندما يتحدث الطهطاوي عن باريس يقول: هي كرسي أو تخت فرنسا (تمشيا مع استانبول تخت الدولة العثمانية)، ويقول عن القانون الفرنسي: الشريعة الفرنسية، ويتحدث أمر محتسب باريس الخبازين بصناعة الخبز. ثم إن أراد أن يتحدث عن مبتكرات لغوية لمسائل لم يعرفها الشرق العربي قال (الرسطراطورات) ويقصد المطاعم، وكذلك (الكرنوال) : اي الكرنفال. وقد سبقه العرب عندما عربوا الأمكنة حسب لسانهم فقالوا: قشتالة يعني كاستل. سادسا: علوم الأنا وعلوم الآخر لقد تفوقت الأنا في علوم الدين، في حين تفوق الآخر في علوم الدنيا، ويقول لقد كان سبب قوة الآخر هو العلوم الدنيوية فإن سبب ضعف الأنا هو ضياع هذه العلوم منها. لقد كان سبب استعمار الإفرنج لأمريكا قدرتهم على ركوب البحر ومعرفة قواعد علوم الفلك والجغرافيا وحبهم للسفر والطبيعيات بل أتقنوا ما وراء الطبيعيات وأقاموا البراهين على خلود الأرواح واستحقاق الدين والدنيا معا، وقد جهلنا الفنون أو العلوم العامة والخاصة معا. وإذا كان الغرب قد فرق بين العلم والفن وأبدع في كليهما، فإننا وحدنا بينهما وتأخرنا فيهما. وإذا كان الغرب قد برع في العلوم الرياضية والطبيعية ولم يهتد الى طريق النجاة في الآخرة، فإننا قد برعنا في العلوم الدينية ولم نهتد الى طريق الصلاح في الدنيا. سابعا: من أدب الرحلات الى علم الاستغراب ينتهي الأستاذ حسن حنفي مناقشة كتاب رفاعة الطهطاوي (تخليص الإبريز)، بأنه لا يعدو مستوى أدب الرحلات، فهو إسقاطات شخصية على مسائل عامة كبرى، فيقيس الجزء ويسقطه على العام دون برهان ثابت ومطلع. وهذا النوع من الفكر يصلح للتوجه للعامة لا للمختصين. ثم لا يخفي الطهطاوي انبهاره بالغرب وحضارته، فيتحول من رحالة الى مبشر بتقليد الغرب في كثير من الأمكنة في كتابه. الموضوع أوسع بكثير مما لخصته فيه وأخشى أن يكون تلخيصي يشوه روعة المادة .. اقتضى التنويه |
الفصل السادس عشر: صورة الآخر من خلال تقارير الرحلات السفارية المغربية الى أوروبا..
قدمه: عبد السلام حيمر ..أستاذ في جامعة مكناس/ المغرب كتب الأستاذ عبد السلام حيمر بحثه هذا بعد مرور 500 عام على خروج العرب من الأندلس، وقد تساءل في بحثه عن مغزى هذا التاريخ ودلالته بالنسبة للحاضر والمستقبل. وأراد أن يلقي الضوء على الرحلات المغربية التي تلت تاريخ خروج العرب من الأندلس، مؤشرا على صورة الآخر من خلال الرؤية التي كان يثبتها كل من هؤلاء الرحالة (بالطبع لن يتطرق الى ابن بطوطة) أولا: رحلة الموريسكي أحمد بن قاسم الحجري (أفوقاي) 1611ـ 1613م. (ناصر الدين على القوم الكافرين) يرى (جاك بارك) أن المغرب حتى القرن السادس عشر، لم يكن بعيدا كل البعد عن السيرورة الحضارية العامة التي هيمنت على بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط . بيد أنه ابتداء من القرن نفسه أخذت الشقة الحضارية بينهما تتسع وتتعمق الى الحد الذي يمكن القول معه بأن تقدم أوروبا كان شرطا مرافقا لتأخر المغرب، بل وتأخر كل البلدان العربية*1 من هنا تبرز أهمية النظر بكتاب أحمد بن قاسم الحجري (أفوقاي) : ((ناصر الدين على القوم الكافرين))، كون الكاتب الرحالة كان يعيش حياة (المناددة) لا حياة الشعور بالتخلف عن الغرب، وهو يمثل تصوير المسلم العربي للآخر الغربي الأوروبي. لقد كانت رحلة (أفوقاي) الى مدن فرنسية وهولندية مثل (باريس و بوردو وتولوز وأمستردام ولاهاي) معرضا لمزاوجة ما ذهب من أجله: وهو استرداد ما سلبه اللصوص الأوروبيين من (الموريسكيين: المسلمين الهاربين من أسبانيا الى المغرب وتونس)، مع انتباهه الى الحوارات والنقاشات الفكرية الدينية مع الرهبان والأحبار وبعض أفراد النخب الحاكمة في فرنسا وهولندا. من جهته يذكر الرحالة من قابلهم بأنهم أهل (دار الكفر) وعندما يتحدث عن نفسه أو قومه أو من يمثلهم ينعتهم بأهل (دار الإسلام)، لقد كان يتكلم باسم العرب والمسلمين والعثمانيين في مناظراته مع أهل (دار الكفر). صورة المغربي (العربي/المسلم) في مخيلة الأوروبي يذكر (أفوقاي) بأن مخاطبات سكان المدن الأوروبية التي زارها له: بقولهم (أنتم االتركيون) ولقبوا أفوقاي بالرجل التركي، لأن الأوروبيين في تلك الفترة كانوا لا يطلقون اسم مسلمين أو عرب أو مغاربة بل أتراك. والصورة عندهم عن هذا التركي بأنه محارب مرعب يسرق ويزني ويجبر زوجته على لبس الحجاب، ومع ذلك يبتعدون عن مباهج الحياة من خمر ولحم خنزير. هذه الصورة التي نقلها (أفوقاي) والذي كان يجيد الإسبانية والفرنسية ولديه اطلاع واسع في الديانات. صورة الأوروبي في مخيلة المغربي ـ (الموريسكي) الأوروبي هو أولا وقبل كل شيء مشرك كافر نصراني، خائن للعهود والمواثيق، ودليل (أفوقاي) على ذلك ما فعله ملوك الإسبان بالمسلمين. ثم يمضي (أفوقاي) بوصف التحالف بين الإقطاع والكنيسة (البابا)، فيقول هم وكبار الملاك يستخدمون الخدم والحشم ويقضون أوقاتهم في ترف ونقاشات في الدين وترجمة الكتب بما في ذلك العربية. ثم يذهب الى وصف المدن فيقول إن مدنهم لم ترق في جمالها وعمارها الى مصاف المدن العربية. لكن مدينة مثل (أمستردام) بها سفن (ذكر 6 آلاف سفينة). ثم يتحدث عن الإصلاح الديني، فيعرج على (لوثر ويسميه هو لطري) وكالفن وبسميه (قلبن). ويذكر أفوقاي (كل واحد من السلاطين النصارى يرتعد ويخاف من سلاطين الإسلام والدين ... وهم السلاطين الفضلاء العظماء العثمانيون التركيون)*2 ثانيا: رحلة الوزير محمد بن عثمان المكناسي توفي 1799م (الإكسير في فكاك الأسير) تمت هذه الرحلة عام 1780، وقد جاءت بعد أن حاول المغرب استرجاع (مليلة) عام 1774، حيث اعتقد المغاربة أن انشغال أسبانيا في حروب أمريكا اللاتينية وخلافاتها مع بريطانيا على جبل طارق، يجعل من ذلك التوقيت أمرا مرغوبا يمكن فيه تحقيق النصر، لكن الأسبان دمروا (مليلة) عن بكرة أبيها وألحقوا هزيمة نكراء بالقوات المغربية وأسروا من المقاتلين الكثير، والغريب أن المقاتلين كانوا أتراكا وجزائريين ولم يكونوا مغاربة*3. فذهب الوزير بمهمة استرجاع الأسرى. الوحدة والتشابه يتحدث ابن عثمان عن إسبانيا ولا سيما الأندلس بوصفها (دار إسلام) اغتصبها النصارى، فهي ليست بلادا غريبة عنه، إنها أرض الأجداد في رفاتهم ومنجزاتهم الحضارية لا تزال ماثلة للعيان، إنها جزء من تراثه وتاريخه. فالعرب ماثلون في أسوار المدن وأزقتها الضيقة وفي مكتبة الأسكوريال وفي الكتابة العربية التي تزين القصور والأبواب والأضرحة. ويكتشف ابن عثمان أن الأسبان يشاطرونه حبه وتقديره للآثار العربية الإسلامية، فعندما سأل الأسبان عن شيء تبقى من الآثار، أحضر بعضهم نقودا وخناجر وعندما فاوضهم على شراءها رفضوا ذلك بأي ثمن لأن تلك الآثار التي يتوارثونها عن الأجداد لا تقدر بثمن ولا يمكن التفريط بها. ويذكر ابن عثمان: أن هناك من جاءه يعلمه بأن أجداده عرب وأقاربهم بالمغرب، فأظهر له أحد أعيان نصارى أشبيلية أنه من أصل عربي وجده اسمه (قردناش) وفي مدينة (أندوخر) قالت له سيدة أنها من بنات (بريس) وأمها بنت (بركاش) وأعمامهم في المغرب.. ويكثر من تلك القصص. الاختلاف بعد أن أظهر ابن عثمان ما شاهده من علامات الفرح في وجوه من قابلهم للتشابه بينه وبينهم، يظهر الاختلاف فيما بين العرب والأسبان، من حيث دينهم الذي وصفه بالفساد، من حيث التثليث واقتصار الصوم على الامتناع عن أكل اللحوم، وارتكاب المعاصي والظن أنها تزول بالاعتراف أمام رجال الكنيسة. ثالثا: الرحلة الإبريزية الى الديار الإنجليزية 1860م و ((رحلة الى إنجلترا)) للحسن الغسال 1902م تمت هاتان الرحلتان بعد أن قويت قبضة أوروبا على دول الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط، فتلك حملة نابليون وتلك احتلال الجزائر، وهناك تربص بتونس، وهناك هزيمتان متتاليتان للمغرب في اسلي 1844 وتطوان 1860، فكان من نتائج ذلك اندماج المغرب بالنظام الرأسمالي من جهة وتتالي البعثات السفارية والطلابية الى أوروبا من جهة أخرى، وهاتان الرحلتان من هذا النوع. لقد تراجع تفكير الرحالة عن أن ما يجري في أوروبا هو من إنتاج المسيحية بعقيدتها وتنظيماتها، الى أن ما يجري هو من تدابير فكرية (اقتصادية واجتماعية وسياسية) واختراع طقوس لم تكن لا في أوروبا ولم يعهدها العالم الإسلامي من قبل، نقابات واختراعات (قطارات وغيرها). لقد كان السلطان في المغرب بأمس الحاجة الى نقل الرحالة لما يشاهدون في رحلاتهم. لقد كانت رحلة (الطاهر الفاسي) الى لندن سببها ما كان يُسمع عن الغرب بأنهم وجدوا علاجا للريح الأصفر (الكوليرا) التي انتشرت في (فاس). وهنا كان وصف الطاهر الفاسي للإنجليزي بأنه صانع للأدوات التقانية المذهلة التي يضيق النطق عن الإحاطة بها ووصفها، فقد مر على استعدادات الجيش الإنجليزي وتطوير صناعة الخشب والسفن والقطارات الخ. ويصف الطاهر الفاسي البابور (القطار) بقوله: (( والحاصل أنهم أتعبوا أنفسهم في إدراك المسائل النظريات، وكابدوا على تحصيلها حتى صارت عندهم ضروريات، ولا زالوا يستنبطون بعقولهم أشياء كثيرة، كما أحدثوا البابور وغيره. وسبب إحداثهم له، أن صبيا كانت بيده ناعورة صغيرة من كاغيد (ورق)، فجعلها متصلة بجعب في فم بقرج على نار، وبعد اشتداد غليان الماء فيه، جعلت تدور بقوة البخار، فرآه رجل وتعجب واستنبط هذا البابور))*4 خلاصة: إذا كنا قد اختصرنا الكثير مما جاء بالبحث، فإننا نستطيع تلخيص العبرة من آداب تلك الرحلات، أنها تركت انطباعين أحدهما طابع سوء الآخر ورداءة خلقه كما جاء في الرحلتين الأوليتين، واجتهاد الآخر وكده في ابتكار ما ينفعه كما جاء في الرحلات المتأخرة. وأن آثار ذلك لا زالت ماثلة في أذهان كل العرب، فبين الإعجاب واحترام قدرة الغربي على الابتكار والعمل، وبين الاحتقار واستصغار خلق وطبيعة ذلك الغربي المسبب للكثير من الأزمات في واقعنا. هوامش: *1-Jacques Berque, Ulemas, fondateurs, insurges du Maghreb, xvii siècle, la bibliotheque (2) arabe, collection hommes et societes (Paris: Sindbad, 1982 p.18. *2ـ ناصر الدين على القوم الكافرين/احمد بن قاسم الحجري أفوقاي/ تحقيق: محمد رزوق/ الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 1987/ صفحة 99. *3ـ من تعليق مقدم البحث: د عبد السلام حيمر في الكتاب الذي بين يدينا (صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه/ تحرير: د الطاهر لبيب/ مركز دراسات الوحدة العربية صفحة 317. *4ـ الرحلة الإبريزية الى الديار الإنجليزية/ محمد بن الطاهر الفاسي/ ص 28 * ـ الهوامش أعلاه ذكرها المؤلف (الباحث)، والهامش الأول كُتب بالحروف الفرنسية، وكون لوحة المفاتيح لا تمكن من الكتابة بالفرنسية، فكتبتها بالحروف الإنجليزية (اقتضى التنويه). |
الفصل السابع عشر: أثر الصورة الذاتية في الموقف العربي من دولة إسرائيل ..
قدمه: مهنا يوسف حداد..أستاذ في جامعة اليرموك/الأردن مقدمة: السؤال حول الذات العربية في متغيراتها "الذات الكلية" و "الذات الجزئية"، كون الأولى تمثل الذات العليا، والثانية تمثل الذات الفاعلة، وكما يبدو، سؤال محوري في محاولة فهم التطورات التي مرت بها الأقوام العربية في المائتي سنة الأخيرة. لقد وجد مفهوم القومية العربية أو نحت كذلك في القرن التاسع عشر على غرار المفهوم الغربي للقومية، ولكنه كان من دون محتوى مستمد من واقع الشعوب العربية في ذلك الوقت. وهنا يبرز سؤال: لماذا لم تصل فكرة القومية العربية الى ما وصلت إليه أي من الذوات القومية الأوروبية؟ يقول صاحب البحث: سوف نحاول في هذه الورقة تقديم النظرية حول الذات لتساعدنا في تحليل الذات القومية العربية، والتي من خلالها تفاعلت الذوات المكونة لها، ولو صوريا مع دولة إسرائيل، طارحين السؤال إذا ما كانت محتويات القومية العربية كونها ذاتا كلية هي التي كان عليها أن تشكل المضمون والهوية. صورة الذات تشير صورة الذات هنا الى موضوع الفكر، وتحتوي على جميع المعرفة والمعتقدات التي يملكها أو يستخدمها الناس لوصف تلك الشخصية التي يحملونها. هذه الذات الجمعية بحد ذاتها لا تختلف كثيرا عن الذات الفردية، وصورتها لدى الجماعة تبدي الخصائص نفسها التي تبرزها الذات الفردية مع الاختلاف بأن تصور هذه الذات يوجد لدى تعدد من الجماعات الإنسانية من أن يوجد لدى فرد إنساني واحد. وفي حالة مثل الذات العربية تتطور بناء على التطورات السياسية وتأثير الذوات الفردية الأخرى في الذات (للفرد). وبقدر ما تتراكم آثار المؤثرات الخارجية المحيطة في الذات الفردية فإنه سيظهر عدة مستويات من الانسجام مع داخل الذات أو الآخر: 1ـ عدم الانسجام، المثاليات الخاصة. 2ـ عدم الانسجام مع الأهداف الأخلاقية الخاصة. 3ـ عدم الانسجام مع مثاليات الآخر. 4ـ عدم الانسجام مع الأهداف الأخلاقية للآخر سنحاول تبسيط المسألة من خلال الابتعاد عن لغة المختصين، وتحويلها ـ بقدر الإمكان ـ لموضوع قابل لفهمه، معتذرين عن القفز عن الأمثلة المدعومة بقول علماء الاجتماع (العالميين) الذي استشهد بهم الباحث. 1ـ الذات الكلية العربية: البداية والمثال (1798ـ 1908) جاءت فكرة القومية العربية ردة فعل على التعسف التركي وتقليدا لحركة القومية أو القوميات في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وقبله*1. لقد أدخل (نابليون بونابرت) عاملين هامين في تكوين الذات العربية، هما: آلة الطابعة ومقاومة الاحتلال، مما هيأ للنخب ومن بعدها شرائح الشعب أن تلتف فيما بعد حول محمد علي باشا وابنه ابراهيم الذي استنهض الهمة العربية لبناء ذاتها من خلال استلهام ما عند الأوروبيين وبعيدا عن حالة التسليم والخنوع للإرادة التركية التي تجاهلت الشخصية العربية، وانصرفت لبناء المركز التركي دون الالتفات للأطراف العربية. إن انتباه أسرة محمد علي لإرسال البعثات التعليمية، الى أوروبا، وتأسيس نظام تعليمي في البلدان التي بسطوا نفوذهم عليها أوجد مناخا وبيئة ظهر منها رواد يهتمون بإحياء التراث و تمجيد القومية العربية .. فكان جناح إحياء التراث الإسلامي يتمثل ب (جمال الدين الأفغاني ورشيد رضا والكواكبي ومحمد عبده وغيرهم) وجناح القومية العربية الذي تصاعد فيما بعد وبالذات بعد أن ظهرت بوادر الهجرة اليهودية لفلسطين، مع ظهور الحركة الطورانية الداعية لتتريك الشعوب التي تحت الحكم العثملني ومنهم العرب. بالمقابل، فإن ظهور دعوات الكتابة والحديث باللهجات المحلية والابتعاد عن الفصحى، ومحاولات إحياء الفرعونية والشامية والإقليمية بشكل عام، كل هذا أوجد أرضية خصبة لنمو فكرة القومية العربية. إلا أن الاختلاف بين القومية العربية والقوميات الأوروبية، أن الأخير كان نموها رأسيا متتابعا، في حين أن القومية العربية كان نموا متعرجا مفتعلا منقطعا، كما أن القومية في أوروبا كانت صبغته علمانية حسمت قطع علاقتها بالدين، في حين أن القومية العربية التزمت باستعادة الافتخار بقوة أمجاد الدولة الإسلامية. 2ـ الذوات الفرعية: الوطنيات القومية لم تستطع الذات الكلية بمحتوياتها المتناقضة مع واقع المنادين بها أن تحقق ذاتها، فهي لم تمتلك آليات تشكيل تحقيقها في زمن لم يكن ليتناسب مع تلك المحتويات. وقبل أن تصل لنقطة بلورة ذاتها، عرفت الذوات القومية المناوئة (الخارجية وغير العربية) ومعها الذوات الوطنية والدينية (العربية والإسلامية) كيف توجه الأمور في اتجاه مغاير يختلف عن الطريق الذي انتهجه رواد النهج القومي. فبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت كيانات وتوجهات إقليمية لم يرق لها تقوية الذات القومية الكلية. فالهبة التي كانت في شرق المتوسط والتي قاد لوائها أبناء شريف مكة (الحسين بن علي) كانوا على غير الخط الذي كان في الجزيرة العربية ممثلا بآل سعود. كما أن انفصال السودان وانشغال أهل مصر بتلك القضية مع تثبيت وتطوير استقلال مصر. وكذلك فإن المناطق التي كان يشغلها نضالها من أجل تحررها من الاستعمار (الأقطار المغاربية) . كل ذلك أوجد شخصيات كيانات وطنية تقدم همها القطري على همها القومي، فتلتقي مع الهم القومي وتتناقض معه في نفس الوقت. لكن، كل تلك الحراكات التي وإن بدت متناقضة وغير مفهومة، اتفقت على عدوانية الصهيونية والنظر لها كآخر لا يمكن الوقوف في وجهه إلا في الاستناد لذات أكبر من الذات القطرية أو الوطنية. كما اتفقت على أن وحدة اللسان واللغة العربية هي نقطة تقدم النظام القطري (نخبه ودولته) الى المجتمع القطري أو المجتمع العربي الأوسع كورقة مرور لمشاغلة الذات في حالة تكوينها. كان هذا الشكل من السلوك إزاء الذاتين (الوطنية والقومية) والذي اتصف بعدم وضوحه واكتمال صورة ما يريد، هي ما أعطت صفة الوهن وعدم القدرة على إنجاز تكوين الذات القومية. لقد كان الفكر العربي بكتاباته بين فترة 1948 و1978 يكتب بمثاليات تتوحد فيه الصبغة الكتابية عند كل الكتاب في النظرة العدائية للصهيونية، في حين كان السلوك الرسمي يتماهى مع فكرة واقعية اتفقت عليها معظم الأنظمة العربية، أقل ما يقال فيها أنها لا تمت بصلة لما كان يكتب في المثاليات الأدبية. 3ـ الفترة الثالثة: بين الذوات المحورية والذوات الأقطاب استغلت الذات اليهودية حالة التناقض في المحيط العربي، وانتصرت في حرب 1967، مما جعل الخطاب القومي يتراجع خجلا من عجزه ووهنه. وقد علت مكانة القدرة الصهيونية لما دعاه (حامد عبد الله) ب (ربيع الظاهرة العبرية) ثم جاءت حرب أكتوبر 1973، بدأت بنصر وانتهت بالإدعاء بالنصر، وأخرجت مصر من الذات الكلية العربية، لتخفت أو تموت فكرة التحرير، عند الدول الوطنية. وأصبحت العلاقة بين دول الطوق (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر) وبين الدول النفطية الثرية، التي لا يفتأ أبناء دول الطوق أن يرددوا أنهم من أسس بنيان دول الخليج من تعليم وبناء ومؤسسات وغيره. فإن كان هذا الكلام يحمل شيئا من الصحة قبل عام 1978، فإنه تحول الى (بزنس) واغتنام الأموال من تلك العلاقة، على حساب الرسالة التعليمية والرسالة الأخوية. وقد اكتشف أبناء دول الخليج الدوافع المستجدة من أبناء دول الطوق، وعلموا كيف أن تلك العلاقة قد أوجدت لديهم حالة من الكسل والاتكال على غيرهم، وما دامت الأمور كذلك، لماذا لا يبحثون ـ هم بدورهم ـ عمن يخدمهم بأسعار أقل (جنوب شرق آسيا)، ولماذا لا يبحثون عن علاقات استراتيجية مع دول تحميهم وتضمن أمنهم! هذا ما حدث في الشرق العربي إزاء الآخر (الصهيوني، اليهودي، الإسرائيلي)، بدأ بخطاب لمنعه من الهجرة، ثم تطور الى التهديد باقتلاعه، ثم تطور الى القبول بقرارات الأمم المتحدة، ثم مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للقبول بها، ثم معاهدات صلح وتطبيع الخ. أما في الأقطار المغاربية، فكان تفاعل تلك الدول لا يرقى هو الآخر عن مرحلة التعاطف الوجداني مرة بشكل قومي (يستحي) من الإثنيات في تلك الأقطار، ومرة بشكل إسلامي ليبرر لتلك الإثنيات ضرورة التعاطف. هوامش *1ـ انظر: الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر/ السيد ياسين/ بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر 1981 |
الفصل الثامن عشر: صورة الإسرائيلي لدى المصري ـ بين ثقافة العامة والدراما التلفزيزنية
عبد الباسط عبد المعطي: رئيس قسم علم الاجتماع في كلية البنات/جامعة عين شمس ـ القاهرة ليس الإسرائيلي بالنسبة للمصري، كأي آخر، فالآخرين غير الإسرائيلي تصعد علاقاتهم مع المصريين وتهبط جودة وسوءا وفق معايير آنية، أما الآخر الإسرائيلي، فهو المرتبط بالعقيدة الدينية وهو المرتبط بالاعتداءات المتواصلة حاليا في فلسطين، ومصريا ببحر البقر، فإسرائيل لها اسم استفزازي دينيا وسياسيا وقوميا لدى المصريين. لقد قام الدكتور الباحث، بانتقاء عينات مختلفة من المصريين، منهم من تحت الثلاثين ومنهم من فوق السبعين، ومنهم من يعمل بقطاع النقل والسياحة ومنهم من خاض معارك بالجيش المصري ضد العدو الصهيوني، وركز في بحثه على مادة مسلسل (رأفت الهجان) ذائع الصيت. أولا: موجهات نظرية ومنهجية 1ـ تتكون صورة الآخر من خلال موجهات أيديولوجية وسياسية وخبرات مباشرة، في الذات الفردية أو الجماعية. كما أن الآخر كمادة (للآخر) يسهم في تشكيل تلك الصورة. 2ـ في لحظات تجلي الهوية الجماعية، يتم التركيز على سلبيات الآخر، الغدر والخيانة والبخل. وفي لحظات انحسار تجلي الهوية، يتم التركيز على إيجابيات الآخر، وهذا يحدث عند مخاطبة الذات لنفسها (جماعية أم فردية) فافتخار الأم بابنها أمام الآخرين، لا يمنعها من مقارنته بابن الجيران المجتهد، وكذلك يحدث بالسياسة عندما نلوم نحن العرب أنفسنا ونقارن وضعنا بوضع أعداءنا الذين يتناقلون السلطة فيما بينهم بطريقة أفضل. 3ـ في موضوعنا، من المنطق استدعاء الثوابت التاريخية في تاريخ المصريين مع اليهود (الإسرائيلي). 4ـ ثمة مصادر محددة أثرت في مدخلات إدراك صورة الإسرائيلي لدى المصريين، بجانب الخبرة المباشرة بمقدمتها النصوص الدينية والثقافة الشعبية والتعليم الرسمي ووسائل الإعلام المختلفة، والمنتجات الفنية والأدبية حول الإسرائيلي. 5ـ يتأثر استيعاب الفرد الاجتماعي المصري لما قدمته هذه المصادر من معلومات، بمستوى تعليم ذلك الفرد وكونه ينتمي للحضر أو الريف إضافة لعمر الفرد المعني. ثانيا: الوصل والفصل بين الديني والسياسي، في تكوين صورة الإسرائيلي. عرف عن المصريين تاريخيا تسامحهم الديني، تجاه بعضهم وتجاه الآخرين. وإن كانت البلاد قد شهدت بعض ملامح التعصب الديني خلال عقدين من الزمن، فهو من قبيل التعصب المُصَنَع والآني، والذي سرعان ما استوعب المصريون دوافع إنتاجه. إن حاملي الثقافة الشعبية والمثقفين المحافظين ذوي المرجعية الدينية يقومون بوصل بين ما هو ديني وما هو سياسي في تكوين الصورة عن الآخر (الإسرائيلي)، لدرجة التطابق، في حين يميز رجال الأعمال والمثقفين ثقافة جامعية بين ما هو سياسي وما هو ديني، لدرجة أن بعضهم يعول على بعض الهيئات المدنية الإسرائيلية أن تتعاطف مع القضايا العربية. ثالثا: الأسماء: المغزى والدلالات الأسماء عند العرب و منهم المصريين لها دلالات، فمنها له علاقة دينية كأسماء الأنبياء، ويكون اسم يعقوب ويوسف وموسى وابراهيم أسماء متداولة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، ويكون للمهنة دور في تكملة الاسم كفلان الحداد أو النجار أو الخياط، أو المحامي الخ، أو يكون للجد (عرقيا) كالأسماء المتصلة بأصل تركي (عصمت، حكمت، عفت الخ). أما اسم (كوهين) مثلا، فله دلالة وقعها يوحي بالمكر والخداع فوق أنه يهودي، وعند المصريين (كهين، كهن) تطلق على الماكرين الخبثاء. رابعا: الخصائص الظاهرة والتوظيف الأيديولوجي للجسد باستثناء العينة من المتعلمين تعليما عاليا التي شملها البحث، والتي لم تذكر فروقا بين اليهود وغيرهم من البشر من حيث الشكل واللبس، اللهم تلك القلنسوة التي يضعها البعض من اليهود على قمة رأسه، فإن الغالبية وضعت تصورها عن اليهود كما يلي: 1ـ اليهودي الذكر، أصلع أو قليل الشعر، أذنه طويلة، أنفه بارز، قصير لكنه ممتلئ. في حين كانت صورة الأنثى لدى العينات العامة ممشوقة القوام طويلة الشعر متسعة العينين دقيقة القسمات. 2ـ ملابس اليهود داكنة سوداء أو بنية غامقة، ونسائهم بلا ملابس أو يتباهين بعريهن، هذا ما أكدته العينة عن السائحات الإسرائيليات في مصر، حتى لو كن بعيدات عن الشواطئ. 3ـ تخبرنا العينة (في البحث) أن صوت اليهودي خافت، ويميل لاستخدام أنفه في مخارج الحروف حتى يظهر وكأنه (أخنف) . وتفسر العينة هذا السلوك لدى الإسرائيليين ليبينوا أنهم لطفاء ومساكين ليستدرجوا ضحاياهم. وكذلك تفعل نسائهم خصوصا في مخاطبتهن للآخرين على الهاتف. خامسا: الآخر سلوكيا وقيميا أجمعت معظم العينات على أن اليهودي يتاجر بكل ما هو ممنوع ومحرم، وهو مرابي ومسوق لكل ما هو غير أخلاقي، وأناني لا يحب إلا نفسه، وبخيل ويفاصل في الشراء ويبخس من قيمة ما يشتريه ولا يلتزم بصفقة. هذه صورة الإسرائيلي في نظر المصريين. [وقد شهدت فصلا قد تم في مكتب هندسي، كان يعمل به أحد المصريين الأقباط كمراسل براتب شهري قيمته (100 دولار)عام 1988، فسأل المهندس ذلك الشاب المصري (القبطي) لماذا لا تذهب وتعمل في إسرائيل براتب أفضل من راتبك هنا بكثير، فاغرورقت عينا الشاب المصري (الوافد) وصرخ غاضبا: أنا أذهب لإسرائيل وأعمل عند هؤلاء (الجزم)؟ (دول جزم يا بيه). وهذه الواقعة شهدتها بنفسي وتدلل على وحدة رؤية الشعب المصري بمسلميه وأقباطه تجاه إسرائيل] |
الفصل التاسع عشر: الذات العربية المتضخمة:
إدراك الذات المركز والآخر الجواني قدمه: سالم ساري/أستاذ في جامعة فيلادلفيا ـ الأردن لقد تضخمت الذات العربية، شكليا، وكان التغزل بالمكان والتاريخ والأمجاد يتجلى في كتابات المثقفين والتربويين، وكان يصور الآخر (العدو) بأنه مهزوم لا محالة وأن المسألة هي مسألة وقت لن يطول. كان هذا قبل حرب الخليج الأولى (دخول الجيش العراقي للكويت). لقد كان أولى بحركة الفكر العربي أن تتوقف عند تضخيمها لذاتها، وتتلمس إشكاليات الخلاف المسكوت عنه قبل أن تتفجر أي أزمة، ولكنها استمرأت التغني بالذات العربية دون الالتفات لبواطن الأزمات المرشحة للتفجير. وبعد تتبع لجذور أزمة الكويت الأخيرة وتطوراتها، وتمحيص لدوافعها وأبعادها، ترسخت قناعة متزايدة لدى بعض علماء السياسة والاجتماع بأن ما شهدته بلاد العرب مؤخرا، ليس في حقيقة الأمر إلا حرب إدراك خاطئ مارسته بلذة عجيبة، الذات العربية الواحدة نحو ذاتها المجزأة*1 تراجع تجسيد الآخر من الخارج الى الداخل بعد تلك الحرب، تضاءلت الإنجازات الحضارية وانحسرت القضايا المصيرية، وتراجعت الطموحات في الوحدة والتكامل والحرية والديمقراطية والأمن. وارتدت الذات العربية بإحباط مذهل لتنشغل بنفسها تفتيتا وتجزيئا مستبدلة آخرها الخارجي القديم العتيد (الغرب الثابت تاريخيا وثقافيا وسياسيا) بآخر داخلي جديد (العربي العائم ذهنيا ونفسيا ومجتمعيا). مبررات الدراسة بعد أن يؤكد الباحث ما سبقه من الباحثين أن الذات المركزية يتم التعرف عليها عادة من خلال تصور الآخر، يذكر مبررات تلك الدراسة التي أجراها بصبر على 200 عينة (أردنية وفلسطينية) بأعمار مختلفة ومهن مختلفة وجنس مختلف، لن نتوقف عند جانبها المهني وطريقة التحليل الإحصائي لها، رغم أهميته، لكننا سنحاول ربط موضوعه بمجموعة المواضيع المطروحة سابقا والتي ستطرح لاحقا، فيقول: إن العالَم الاجتماعي الثقافي السياسي اليوم لا تحكمه الأفكار العقلانية فقط، وإنما الأفكار العاطفية والإدراكات الزائفة أيضا. ولا تتحكم في علاقات أفراد المجتمعات المختلفة التصورات والصور الواقعية الصائبة فحسب، وإنما، بالقدر نفسه، تلك المغلوطة المشوهة أيضا. أولا: إدراك الذات العربية (المركز) لذاتها نصنع الذات الثقافية صناعة، عبر عملية التنشئة الاجتماعية الثقافية، كعملية تراكمية تفاعلية مستمرة من التأثير والتأثر. ويكون المجتمع، في هذه العملية الدينامية المتطورة، إطارها وبناءها المحدد، وتكون الثقافة مادتها ومحتواها، كما تكون الشخصية أداتها وهدفها في آن معاً. وعند اتخاذ المواقف من أي مسألة (خصوصا مسائل الخلاف بين العرب، والكاتب هنا يركز على أزمة حرب الخليج الأولى) فإن المواطنين العرب من المحيط الى الخليج سيفكرون من خلال ثقافتهم المتكونة وبواسطتها، وهو ما سمي بالمنظومة المرجعية (Reference System)، وبالتأكيد فإن شحن تلك المرجعيات سيتم قطريا (في كل بلد) وفق المتيسر من المعلومات والمواقف الشعبية والنخبوية السائدة. 1ـ الهوية الثقافية في سؤاله عن الهوية والانتماء تلقى الباحث 53.5% من الإجابات بأنا (عربي) و 18% (أنا مسلم) و 16% (أنا أردني) و الباقي 12.5% أجاب عن مهنته كما فهم السؤال (أنا طالب، موظف، طبيب الخ). 2ـ القيم الراسخة في سؤاله عن أنماط المبادئ الراسخة التي يتمسك بها من سألهم، جاءت إجابات 35.5% بأنهم متمسكون بمبادئ عربية، وجاءت إجابة 27.5% بأنهم متمسكون بالحفاظ على المبادئ الإسلامية، في حين من يتمسكون بالمبادئ الشخصية 21.5% ومن يتمسكون بمبادئ وطنية 15.5%. 3ـ صورة الإنسان والمجتمع العربي ـ كنمط مثالي في سؤاله عن مواصفات العربي المثالي، جاءت الأجوبة 28.5% من يحافظ على القيم العربية الأصيلة، و 27.5% من ينتمي عربيا، و 20% من يلتزم دينيا، و 17.5% من يعتز ببلده والمحافظ وطنيا، و 6.5% من ينفتح على الثقافات الأخرى. أما سؤاله عن صورة المجتمع العربي المثالي، كانت الأجوبة 33.5% المجتمع العربي الديمقراطي الوحدوي، و 33% المجتمع العربي الإسلامي حقا، و 15.5% المجتمع العربي الخالي من الشرور، و 10.5% المجتمع الراقي حضاريا، المحترم دوليا، و 7.5% المجتمع المحافظ على تاريخه وقيمه الأصيلة. وعندما تم طرح سؤال ما هي التضحيات التي تفرضها العروبة؟ أجاب 47.5% من أجل المستقبل العربي، و 27% من أجل فلسطين، و 17.5% من أجل المبادئ الإسلامية، في حين أجاب 8% من أجل المبادئ العربية. وعن سؤاله: ما هي هموم المواطن العربي اليوم؟ أجاب 52.5% الانحطاط السياسي، و 24% الرضوخ للأجنبي، و 11% الجهل والطبقية والإقليمية، و 6.5% الابتعاد عن الدين والقيم، و 6% الانهزام النفسي والخلقي. 4ـ صورة العربي ـ العربي رغبت كل العينات أن يؤخذ الإنسان العربي الجديد أمام العالم الخارجي، مأخذا جديا باعتباره صاحب حضور وحضارة، وأن تُحترم خصوصياته وأن تُثمن إنجازاته الماضية مع احترام طموحاته المستقبلية. وعند الإجابة على سؤال عن الصورة المفضلة للعربي أمام العالم الخارجي، أجاب 37.5% بأنه العربي العريق حضاريا، الواعي بتحديات المستقبل، وأجاب 26% بأنه القوي سياسيا، المستقل فعلا، وأجاب 15% بأنه القوي بدينه، الغني بقيمه، وأجاب 13% الوحدوي الديمقراطي، و 6% الأصيل ذو الصفات التقليدية و 2.5% ذو الهوية الوطنية المميزة. ثانيا: مصادر تكوين صورة الآخر تكونت صورة العربي كآخر أمام أخيه العربي، خلال حرب الخليج الأولى من خلال مصادر مختلفة تم الإجابة عنها من قبل العينات، بأن 23% من العينة أجابت بأن الصورة تكونت خلال حرب الخليج ومواقف الدول والشعوب، و20% حديث الأقرباء والأصدقاء المتعاملين معه، و 13% وسائل الإعلام المحلية، و 10.5% ممن أقاموا وعملوا في دول الخليج، و 10.5% من وسائل إعلام خليجية، و10% لكل ممن كونوا صورتهم من خلال لقاءات تمت في الخارج، ومثلها ممن اعتمدوا على وسائل إعلام أجنبية، في حين كان 3% ممن أجابوا بأن لديهم وسائلهم الخاصة. يتبع |
ثالثا: البحث عن مساحة لفهم الآخر
في الحديث مع العينات، والبحث عن نقاط الالتقاء بين أبناء الوطن العربي، وعن أوجه التشابه فيما بينهم، أجاب 32.5% بأنهم يلتقون في روابط العروبة، وأجاب 22.5% بأن اللقاء يتم في رباط الدين، وأجاب 22.5% أيضا، بأن اللقاء يتم في التاريخ والتراث واللغة، و12.5% أجابوا بأن اللقاء يتم في التشابه بالشكل الاجتماعي. في حين أجاب 10% بأنه لا لقاء في أي شيء. أما عن الأحاديث التي تدور بين أبناء العرب عندما يتحادثون أجاب 25% بأنها متعلقة بالعروبة والإسلام، و 12.5% عن ضرورة الوحدة العربية وإشاعة الديمقراطية، و12% حول السياسة وفساد أنظمة الحكم والتبعية، و 11% عن حديث تقليدي غير محدد، و7.5% حول تمويل المشاريع والمال والأعمال، و 3% عن السلوكيات السيئة في الخارج، في حين رفض 29% فتح أي حديث. وعن إمكانية التعايش فيما بين العرب، أجاب 15% بنعم لأنه عربي مثلي، و10% نعم لأنه فيه جوانب مشرقة، و10% نعم أثناء العمل فقط، و7.5% نعم بشرط الاحترام المتبادل، و 2.5% نعم ـ يمكن إصلاحه واحتواءه. في حين أجاب 27.5% ب (لا) لعنصريته وغروره وظلمه للعرب، و 10% لا لأنه غادر خائن خداع، و10% لا لاختلافات اجتماعية وفروقات مادية، و 7.5% لا لجهله وضيق أفقه ولا مبالاته. *2 هوامش *1ـ عبد الخالق عبد الله: (أزمة الخليج: خلفية الأزمة، دور الإدراك الخاطئ) ورقة قدمها للندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1991، نشر في مجلة المستقبل العربي بالعدد 153(ص 85ـ93). *2ـ كانت هذه الحلقة مأخوذة من الصفحات 373ـ 395 |
الفصل العشرون: تونس والعالم: موقف الشباب التونسي من البلدان الأخرى.. قدمه: ميخائيل سليمان .. أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كنساس هذه الدراسة هي محاولة لاكتشاف نظرة الشباب التونسي الى ذاته، وهذا ما يدل ضمناً على أنهم يعتقدون أن هناك اختلافاً بينهم وبين الآخرين. وترتكز الدراسة على معلومات وبيانات تم جمعها في بحثين ميدانيين استقصائيين وقد أجري البحث الأول على 1618 طالب من الصف الرابع الابتدائي الى الصف التاسع، كان ذلك عام 1988. أما البحث الثاني فقد كان على المعلمين وعلى موظفين في وزارة التربية والتعليم، من خلال مقابلات متعمقة أجريت عام 1994. وقد تم اعتماد مقياس لايكرت (Likert-Scale) في تقييم الأجوبة بالنسبة للدراسة الأولى. حيث تم طرح سؤال عن ميولهم تجاه 22 بلدا مختلفا من بينها 8 بلدان عربية هي: السعودية، فلسطين، المغرب، مصر، الجزائر، سوريا، ليبيا والعراق. في حين تم سؤالهم عن 14 بلدا غير عربي هي: اليابان، فرنسا، جنوب أفريقيا، سويسرا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، أسبانيا، باكستان، البرازيل، اليونان، كندا، (الاتحاد السوفييتي) و إسرائيل. (1) موقف الشباب التونسي من البلدان الأخرى (نسبة مئوية) في حساب النقاط، حصلت السعودية على المرتبة الأولى بين الدول ال 22، بنسبة قدرها 69.3% وهي الدولة العربية الأولى في نظر من تم توزيع الاستبيان عليهم، في حين كانت فلسطين ثانية(62%) والمغرب ثالثة(60.8%) ومصر رابعة(58.6%) والجزائر خامسة(58.3%) وسوريا سادسة(47.9%) وليبيا سابعة (46.7%) والعراق ثامنة والأخيرة بين الدول المفضلة عربيا(45.7%). أما الدول غير العربية، فاحتلت اليابان المرتبة الأولى (38.1%) وليلاحظ القارئ الكريم كم هو الفارق بينها وبين آخر دولة عربية(العراق). واحتلت فرنسا ثانيا (30.6%) وهي دولة استعمرت تونس زهاء 75 سنة، أما الولايات المتحدة فكان ترتيبها 14 بين الدول كلها ونسبتها 28.1% ومن الدول الإسلامية (باكستان 25.4%) وترتيبها 17 من الدول ال 22، في حين جاءت إسرائيل في آخر مرتبة 22 و بنسبة 7.1%. (2) العوامل المؤثرة في إجابات الشباب هناك عوامل عديدة لها تأثير مهم في موقف الشباب التونسي من البلدان الأخرى، منها: السن، والمستوى التعليمي، والخلفية الاجتماعية ـ الاقتصادية للوالدين، والجنس (ذكر/أنثى) وغيرها. فالموقف من السعودية وفلسطين لم يختلف من حيث الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، فقد بقيت السعودية في المرتبة الأولى للدول المفضلة، إلا عند أولئك الذين كانوا في الصف التاسع حيث احتلت المرتبة الثانية، في حين احتلت فلسطين المرتبة الأولى. والسبب في ذلك (حسب رأي الباحث) أن السعودية وما لها من علاقة وطيدة بمبعث الرسالة ووجود الكعبة وأصل العرب وغير ذلك من العوامل جعلها في المرتبة الأولى، لكل الفئات العمرية، وفلسطين بما تحتله قضيتها في الوجدان الشعبي وكونها قضية حية، جعلها تحتل المرتبة الثانية باستمرار عند كل الفئات، عدا الحالة التي أشرنا إليها. وعند كل الفئات جاء الكيان الصهيوني (إسرائيل) في المرتبة الدنيا عند كل الفئات مع ابتعاد واضح عمن سبقها باعتبارها أسوأ كيان. وتلاها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. (3) تأثير جنس الطلاب في الموقف من البلدان الأخرى اتضح من الدراسة أن الإناث غالبا ما يفضلن الدول الغربية على سواها من البلدان، وقد لوحظ أن الطالبات اللواتي يعبرن عن موقف إيجابي إزاء كل من سويسرا وأسبانيا وكندا وفرنسا واليونان، يفوق عدد الأولاد، وربما يكون السبب (حسب الباحث) أن الشابات التونسيات يجذبهن غالبا سحر هذه البلدان وجمالها الطبيعي الرائع، وربما يكون لانتشار المساواة بين الجنسين. لكن، اتفقت الإناث مع الذكور على اعتبار أن إسرائيل هي الأسوأ بين الدول المذكورة في الاستبيان، وإن كان بحدة أقل. خلاصة إن الترابط العربي، جعل الإجابات تجعل من الدول العربية المطروحة في الاستبيان في مقدمة الدول المفضلة، في حين رأينا كيف أن باكستان وإن كانت ترتبط دينيا مع العينات المشمولة بالاستبيان لم تحتل مكانة متقدمة، حتى على الدول الأجنبية. احتلت اليابان والصين والبرازيل المراتب العليا بين الدول الأجنبية، كونها دول جادة اقتصاديا وأثرها السيئ على القضايا العربية، بعكس ما هي عليه دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. كما أن الهند احتلت مرتبة أعلى من باكستان، لدوافع الإعجاب باستقرار الوضع السياسي وتناقل السلطة، والسرعة الهائلة في التقدم الاقتصادي ومعدلات الإنتاج. ومن الملاحظ أن فرنسا وإن كانت قد أثرت لعقود طويلة في الحياة التونسية، لم تحتل مكانة استثنائية، بل كانت مثلها مثل أي دولة من تلك غير المميزات في ميزان التقييم المعتمد في الدراسة. يتضح من الدراسة أن الشباب التونسي على قدر من الوعي الذي يعطي لشخصيته أبعادا تعرف حدود موقعها وتعلم امتدادها الحضاري والجغرافي وتعلم من هم أعداءها ومن هم غير ذلك. |
الفصل الحادي والعشرون: البعد الجغرافي وصورة الآخر: مقاربة أمبيرقية ..
قدمه: مصطفى عمر التير .. أستاذ في جامعة الفاتح ـ طرابلس ـ ليبيا (الصفحات 419ـ 429) من الكتاب فرضيات الدراسة يحمل أي باحث تصورا يكون محورا لفرضياته التي كونها قبل إجراء دراسته. والأستاذ مصطفى عمر التير صاحب البحث، يذكر أنه اطلع على كتاب جمال حمدان الذي يحمل اسم (شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان) والصادر عن عالم الكتاب عام 1980 بأربعة أجزاء مقتبسا منه [ أن المصري يحب أن يسمع عن نفسه فقط عبارات الإطراء، ويكره أن يُذَكَر بعيوبه وأن يوصف بأوصاف سلبية حتى ولو كانت هذه حقيقة]*1 ويضيف اقتباسه عن جمال حمدان [ فنحن معجبون بأنفسنا أكثر مما ينبغي والى درجة تتجاوز الكبرياء الصحي الى الكِبر المرضي... فنحن نضخم من ذاتنا الى حد السخف]*2 كما يذكر الباحث اطلاعه على دراسة مماثلة لسعد الدين ابراهيم تصف حالة التمجيد لأبناء الأقطار العربية لأنفسهم وما أسماه (التمركز حول الذات) إذ يقتبس منه [ هناك اتجاه غلاب نحو تمجيد الشعب الذي ينتمي إليه المبحوث واعتباره أفضل الشعوب على الإطلاق]*3 من هنا، افترض الباحث أن الشعب الليبي يتماشى مع تلك القاعدة الواردة في البحثين الذي اقتبس منهما الباحث ما أشار إليه. تقنيات الدراسة اختار الباحث عينات من طلاب وطالبات وأساتذة جامعتي (طرابلس وبنغازي) مناصفة وكانت أعمار المبحوثين بين 20ـ45 سنة، واختار نصفهم من الشق الغربي لليبيا والشق الشرقي. واختار الباحث خمسة دول أربعة من الدول العربية، هي (مصر: شرق ليبيا) و(تونس: غرب ليبيا) ولبنان: كونها من أكثر الدول العربية في الإنتاج الثقافي( حسب الباحث) وكونها عانت من حرب أهلية، وأخيرا الكويت: كونها بلدا بعيدا عن ليبيا وشغلت قضيتها مع الغزو العراقي اهتمام العرب أينما كانوا. ومن الدول غير العربية اختار سويسرا، كونها لم يُسجل عليها أذى للبلدان العربية قد يتأثر المبحوث منه. طبيعة الأسئلة العشرة الموجهة للمبحوث استخدم الباحث تطويرا على مقياس (لايكرت) في توجيه الأسئلة وأعطى خمس درجات لكل سؤال. والأسئلة تمثلت في صفات الذكاء والاجتهاد والأمانة والصدق في القول والكرم والشجاعة والنفاق والطموح والأنانية. وكان من بين الدرجات الخمس في التقييم (لا أعرف). نتائج الدراسة باختصار شديد احتلت صورة المواطن الليبي المرتبة الأولى بين العينات كلها، لكن بنسبة 8/20 لكل العينات، و 11.8/20 بالنسبة للذكور. كما احتلت صورة المواطن السويسري المرتبة الثانية 7.2/20 من كل العينات، و 10.5/20 من الذكور. أما صورة المواطن المصري فاحتلت المرتبة الخامسة بين الدول الست، وتونس المرتبة الأخيرة السادسة بين الدول، في حين احتلت لبنان المرتبة الثالثة والكويت الرابعة. (لا أعرف) بين الإجابات يُفترض أن تكون مجموع عدد الأسئلة لكل صورة ألف سؤال، فكانت نسبة لا أعرف عن صورة السويسري 42.3% تلتها صورة اللبناني 29.1% صورة الكويتي 25.3% ثم التونسي 15.9% والمصري 13.3% وأخيرا الليبي 10.6%. تفسير الاندهاش في الإجابات كان في تصور الباحث أن تكون إجابات الليبيين عن صورة الليبي تفوق ما جاءت عليه، فهي لم تبلغ حتى 50% من كل العينات، لكنه لم يوضح تفسيره لتلك النتيجة المتواضعة. كان في تصور الباحث، والذي شرح في الدراسة الانفتاح الليبي على العرب واستقبالهم للوافدين العرب العاملين والمقيمين، أن تكون صورة المصري والتونسي أكثر مما جاءت عليه، فكانت صورة السويسري تتفوق على كل العرب وكانت دولتا الجوار (مصر وتونس) في المرتبتين الأخيرتين. يقف الباحث عند تفسير رداءة صورة التونسي والمصري عند الليبي، فيعود لدراسة وضعها (نادر فرجاني) تظهر أن كثرة الاختلاط بين أبناء دول الجوار لا يؤدي بالضرورة الى تحسن صورة كل منهما لدى الآخر، وهي بنظر الفرجاني ترتبط ببعض ما يكون قد علق بالذاكرة من ذكريات قد لا تكون سارة*4 هوامش: *1ـ جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان ص 26/ج1 *2ـ المصدر السابق صفحة 27 *3ـ سعد الدين ابراهيم، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية/بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1980 صفحة275. *4ـ نادر فرجاني، سعيا وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل في الأقطار العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 1988 صفحة255. |
القسم الثالث: ما وراء الحدود: نظرة الآخر الى العرب..
الفصل الثاني والعشرون: العلوم الاجتماعية والاستشراق : صورة المجتمع العربي الإسلامي.. قدمه: محمد نجيب بوطالب أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس تنطلق هذه الدراسة من فرضية: أن الصورة التي ترتسم الآن في الرأي العام الأوروبي حول العربي المسلم، والتفاعلات مع تلك الصورة بتشوهاتها وحقائقها، ما هي سوى استمرارية وشبه استجابة للصورة التي تكونت عبر التاريخ الوسيط والحديث حول الشرق عموما، والعرب خصوصا. الصورة أو الصور المشوهة عن العرب (الشرق)، تبرز كلما بدا للعيان ترهل الأداء الحضاري العربي، فتكثر الدراسات لتنتهي بأن هذا النمط من الناس يحمل مواصفات (أنثروبولوجية) تجعل من الطبيعي أن يكون أداء الناس الحضاري بهذا المستوى المتدني والهزيل. لقد ساهم المستشرقون في تهيئة الأجواء أمام المثقفين الغربيين ليثبتوا تلك الصور عن الشرق، خصوصا أولئك المستشرقون الذين ظهروا في القرن 19 وقد كانت دراساتهم مغلفة بمصداقية مصنعة حسب نظريات علم الاجتماع فكانت شهاداتهم كشهادات الأطباء الذين يحذرون من نوع من الطعام أو يمتدحون صنفا من معجون الأسنان. المركزية الأوروبية لقد أقام الأوروبيون منذ القدم (ثنوية) تعارضية بين الشرق والغرب، وضمنوها نزعة مركزية أوروبية تمجد الغرب وتحط من شأن الشرق. وقد اصطبغت تلك النزعة بألوان متباينة، فكانت في البداية شعور بالنقص تجاه الإسلام والعرب الذين كانا متفوقين على الغرب، وأحيانا شعور بالخوف من هذا الشرقي أن يبسط نفوذه على الغرب (أوروبا). وأحيانا يكون الشرق مصدرا للإلهام لبعض الشعراء (غوته، لامارتين) وبعض المفكرين والأدباء (ديوالد، فولتير ...)، بل كان الإعجاب بالشرق يصل حتى حركات الإصلاح الديني الأوروبي، الذين كانوا يتطلعون الى النموذج في الإمبراطورية العثمانية على أنه رمز للعدالة، وهو أفضل من الاضطهاد البابوي. أما بعد التقدم الاقتصادي والسياسي والعلمي عند الأوروبيين، فتراجعت الصورة عن الشرقي ليصبح رمزا للتخلف والكسل، ويصبح موضوعا جديرا بالدراسة، شأنه شأن أي ظاهرة بيولوجية عند النباتات أو الحيوانات! الرسالة التمدنية أشار (فورييه) مساعد (نابليون بونابرت) في الحملة الفرنسية على مصر، أن غزو مصر هدفه " إنقاذ مصر من بربريتها وإعادتها الى عظمتها الكلاسيكية " و " تلقين الشرق طرائق الغرب الحديث " . إن فكرة الرسالة التمدينية ( Mission Civilisatrice) انطلقت كمبرر أيديولوجي لبدايات أزمة الرأسمالية التقليدية. ولذلك ظهرت بشكلٍ مُرَكَز في العشرينات من القرن التاسع عشر. وقد شارك في حملها كل التيارات (بيسارها ويمينها)، كما تجسدت لدى مُنظري الحقبة الاستعمارية، وارتبطت بشكل جلي بالاعتبارات الدينية (نشر المسيحية ومقاومة انتشار الإسلام). وقد وصف (كليرمون توتيز) استعمار فرنسا للجزائر بأنه (( عملٌ عظيم أنعمت به العناية على فرنسا لتمدين العرب وجعلهم مسيحيين)). المؤثرات الاستشراقية في سوسيولوجية فيبر حول الإسلام (1863ـ 1920) سنأخذ نموذجا من المستشرقين الذين تركوا أثرا في توجيه السياسات الاستعمارية لدى الغرب، كما أثروا على علماء الاجتماع والسياسة في تشكيل صورة العربي والمسلم لديهم. إنه عالم الاجتماع الألماني ذائع الصيت (ماكس فيبر)، وسنختصر ما دونه وما لاقى من اعتراض فيما يلي: الصور والأفكار والتبريرات التي خرج فيبر متأثرا بفرضيات المستشرقين: 1ـ انحطاط العالم الإسلامي وبناه الاجتماعية ونظمه السياسية المتصفة بالاستبداد. ويقول: (( الديانتان اليهودية والمسيحية كانتا ديانتين بورجوازيتين، بينما ليس للديانة الإسلامية سوى دلالة سياسية)) [ يقصد النزعة العسكرية التوسعية] 2ـ غياب الطبقات الاجتماعية المحققة للتحولات (الطبقة الوسطى)، وكذلك غياب الصراعات التاريخية، الطبقية، وأيضا غياب المدينة المستقلة ذاتيا. 3ـ ارتباط الدولة الدينية الوشيج بالأفراد وتحكمها فيهم، وفي سن القوانين، فهو يقول: ليس الإسلام كعقيدة للأفراد هو الذي أعاق التصنيع، ولكن بنية الدولة الإسلامية وتركيبة موظفيها وقوانينها وأجهزتها التي كانت مشروطة دينيا هي العائق. ويفسر الأسباب التي تقف وراء هذا الركود هي: أ ـ تَحَكُم الإقطاعية الشرقية عبر شرائح عسكرية تتميز علاقتها بالسلطة المركزية بالتضارب والصراع على الجباية. ب ـ اعتبر (فيبر) أن هذه التطورات داخل الدولة الإسلامية كانت السبب الرئيسي في فشل التحول التجاري والتطور الرأسمالي. ج ـ لقد أدى العجز في التوسع (الغزو) الى العجز عن دفع رواتب الجيوش وموظفي الدولة الشرقية، وهذا العجز يعني توقف الولاء للمركز. فالأزمة المالية متأتية من الإقطاع العسكري والتزام الضرائب*1 نقد وتقييم لنظرية فيبر من أهم الذين ردوا على فيبر المستشرق الفرنسي (مكسيم رودنسون) الذي أشار الى مبالغة فيبر عندما اعتمد على الأخلاق الدينية كمحرك للاقتصاد. وقال: أن الإسلام نفسه عرف قيم التقشف والعمل والربح، وبالتالي ازدهرت التجارة في العهود الأولى من الإسلام وتطور الاقتصاد معتمدا ليس فقط على الضرائب، بل كذلك على الإنتاج وتطور المبادلات، فضلا أن الإسلام حث على العلم والمعرفة وقد أشار المستشرق الفرنسي الى القرآن الكريم الحاث على إعمال العقل { أفلا تعقلون} وطلب العلم الخ. ويرى (هشام جعيط) في كتابه (أوروبا والإسلام) أن الغزو الاستعماري للمنطقة العربية استمد حركته من وعي موروث من القرون الوسطى، وعي يقوم على أسس انفعالية لتمثل الإسلام. وأن اطلاع (فيبر) على الإسلام قليل وقاصر ولم يكن اطلاع الباحث المجتهد.*2 هوامش *1ـ هذه الفكرة الأخيرة صائبة الى حد كبير، وهي لا تزال متداولة عند الأوساط العلمية العربية التي تبحث في أسباب سقوط الدولة العباسية. أنظر: محمد نجيب بو طالب/ الصراع الاجتماعي في الدولة العباسية/ سوسة: تونس: دار المعارف للطباعة 1990 [ تهميش المؤلف الباحث]. *2ـ جعيط: أوروبا والإسلام: صدام الثقافة والحداثة، الفصل1. كما يمكن الرجوع الى إدوارد سعيد: الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ص 290. [تهميش الباحث]. |
الفصل الثالث والعشرون: الفلاحون المغاربة في الإثنولوجيا الكولونيالية: بين الجمود وقابلية التحسن ..
قدمه عبد الجليل حليم.. أستاذ بجامعة مكناس/المغرب (الصفحات 449ـ 462 من الكتاب الذي بين أيدينا) (1) ((لما كانت الشعوب الأوروبية قد أبادت شعوب أمريكا، فلقد كان عليها أن تستعبد شعوب إفريقيا لاستخدامها في استصلاح الأراضي. فلو لم يُجبر العبيد على الاشتغال بغراسة النبتة التي تنتج السكر لكان ثمنه باهظا جداً. وهؤلاء العبيد سود من أخمص القدمين الى أعلى الرأس، وأنف الواحد منهم أفطس، وبلغ في ذلك حداً يعود من المحال علينا تقريبا أن نشفق عليهم. ليس من الممكن أن نُسلم بأن الله، وهو الموجود ذو الحكمة المنيعة، قد أسكن نفساً، ونفساً خيرة على وجه الخصوص، في جسد أسود برمته (...) ومُحال أن نظن هؤلاء القوم بشراً، فإن نظنهم بشراً نعتقد أننا لسنا بأنفسنا مسيحيين*1)) هذا الكلام ليس صادرا عن شخص من العامة، بل من مفكر هام من واضعي أسس الثورة الفرنسية، (مونتسيكيو) والذي من أقواله: لا يجوز قتل الغير بدون قانون، ولا يجوز تملك أرض الغير بدون قانون، ولا يجوز سن قانون دون اشتراك ممثلي الشعب بوضع القانون. ويبدو أن الفيلسوف الكبير لم يعتبر المغاربة حتى من الغير أو من البشر. وهو نفس التفسير الذي لجأ إليه الفرنسيون عندما غزوا مصر (حملة نابليون) عندما قيل لهم أن أرض مصر هي أرض غير ونفوس شعبها المعرض للقتل هم من الغير. أجاب المدافعون عن الغزو أن هؤلاء ليس ممن تعنيهم مبادئ الثورة الفرنسية. هذا الرأي عن الآخر الإفريقي، مثله (دوتي) صاحب كتاب (روح الشرائع) يترجم رؤية المتفوق والأقوى نحو من هم أضعف منه. (2) الآخر الإفريقي في وجهة نظر الفرنسيين، لا بد إلا أن يكون متوحشا، ومن البرابرة وبدائيا، وكافرا في أحسن الأحوال. وليس له الحق في أن يصبح مثقفا ومتحضرا، أو حتى ينتمي للإنسانية. أن يُحرم الإفريقي من ثقافته، وأن يُسلب من ملكيته، تلك أفضل الطرق لبتر جذوره وتشييئه (تحويله لمجرد شيء). فيسهل بعد ذلك احتواءه ودمجه في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي الجديد الذي يُراد أن يُفرض عليه. وفعلا كانت المغرب، كما هي الجزائر والبلدان المغاربية، منذ منتصف القرن التاسع عشر موضع أطماع القوى الأوروبية ويستلزم وضع الدراسات عنها من خلال الإرساليات، فماذا قدمت تلك الإرساليات من صور؟؟ (3) أشغل سكان الريف المغربي ببسالتهم وشجاعتهم في القتال كل المهتمين بالقضايا المغربية ممن كانوا يرسلوا لوضع تقاريرهم. سنعاين في البداية الصورة التي كونها الفرنسيون عن المغاربة. ونقرأ هذا التعبير: (( لا يمكن إزالة القاذورات اليابسة عن (البيكو) *2[...] إنهم متعنتون تعنت العميان في التشبث بطرق تفكيرهم وأفعالهم وعيشهم، فكل أفكارنا وكل أعمالنا تبدو لهم مقيتة، والحال أن ديانتهم هي التي تغرس فيهم هذه الآراء. من أجل تغيير طريقة عيشهم لا بد من القوة، فما أن نكف عن استعمالها يتهافتون مجددا في تقاليدهم المزمنة ليقبعوا داخلها ويزدرونا. إنهم قذرون وكذابون ولؤماء، وهم متشبثون بالمكوث على هذه الحال. أما الابتسامات التي يجودون بها علينا والآداب الحسنة التي يعاملوننا بها فليست إلا مسخرة وبهتانا. وبدلا أن يعترفوا لفرنسا بفضلها عليهم لا يكفون عن الرد في كل مناسبة بتظاهرات ينغرس فيها الحقد، علاوة على أن المتظاهرين هم أولئك الأكثر تعلما وتدينا من بينهم))*3 وفي دراسة ل (دوتي) أشار فيها عن الطبع المتوحش لدى المغاربة من خلال ما استقاه من عادات الزواج، التي رأى فيها (طبعا بدائيا مقدسا) يراد منه (حسب تفسير دوتي) درء المخاطر الوهمية التي يمثلها الزواج في نظر المغربي المتوحش. ويسهب الباحث في النظر لتلك المسألة ويستهجن عدم وجود علاقات غير شرعية بين الرجل والمرأة. ويستخلص نتيجة أنه إذا حضر الرجل مع زوجته فإن استقبال الآخرين له سيكون أكثر ودا واطمئنانا من حضوره وحده، وعليه فهو يوصي البعثات أن يرافق فيها الرجل امرأة فهذا يسهل مهمته. (4) إن السحر والبدائية متزاوجان مع الإسلام، ويولدان العصبية!. هذه العبارة ل (دوتي) ويقول أن طابع مقاومة الاستعمار بهذه الروح الهمجية التي تنظر الى قتال المسيحي على أنها عمل مقدس، صنع من هؤلاء (يقصد الشاوية والشلوح وسكان الأرياف) أبطالا، لا يهابون الموت بل يطلبونه. لئن اجتمع كل الكتاب في تلك الحقبة على اعتبار سكان الريف المغربي متوحشين وبرابرة، فلأن القبائل كانت تشكل في وجه التغلغل الاستعماري (العدو الأكثر شجاعة وإصرارا) على تعطيل ذلك التغلغل ومن ثم دحره. ثم يذهب دوتي، الى السخرية من الإنتاج الزراعي، ويصفها بأنها بدائية تعتمد على إشارة من شيخ (مولى التسهيل) لأن يبدأ الفلاحون بزراعة أراضيهم، وبعد ذلك يتركون الباقي (على الله). إنهم (في نظره) لا يفهمون معنى الدورات الزراعية، ولا يعلمون عن التسميد، ولا يعلمون عن أي فن من فنون الزراعة، فتنجرف تربتهم وتتدهور خصوبتها ويقل إنتاجها. (5) لقد تحدث (مونتانيو) عن الفلاحين المغاربة، فيذكر (الغرائز الفلاحية لدى الشلوح) فيقول: (لهذا القطيع الشاسع طبع تجميعي يجعل من ناحية أولى، ظهور موقف من الانفعال السلبي التام ممكنا ما دامت تبرره وتسانده قيمة الاستسلام والاستقالة التي جاء بها الإسلام، وهي من القيم الأخلاقية الموروثة عن التراث الديني لأهل الريف في شمال إفريقيا، والتي بقيت على صفائها الأول)*4 وفي الإجابة عن التساؤل حول الأسباب التي تقف وراء ذلك يقول (بارك): ( غالب الأمر في ذلك هو بكامل البساطة أن الجهاز العصبي للعربي والبربري ليس نفس الجهاز العصبي الذي يتمتع به العامل الصناعي [الأوروبي]، بسبب انعدام التكيف عنده وبسبب قصور تكوينه معا)*5 (6) ينتقد (جاك بارك) بروز الترحال الرعوي وما ينجر عليه من هشاشة في مجال الزراعة المستقرة ذاتها، وتناسي تقنيات كانت مزدهرة في وقت سابق، وظهور موجات الجوائح والاسترقاق التي تفرض على المرأة البدوية، وإنهاك التربة وتلاشي الغابات وعدم انتظام الأمطار وبالتالي ركود الجماعات الريفية، والتي تتشبث بالأراضي البور وتفضيلها الفقر ضد التحديث والعصرنة. تعليق: لو تمعن أحدنا بهذا النص، لوجده مليء بالمغالطات، فتفضيل الصمود المقترن بالفقر ليس رذيلة تُحسب على شعب المغرب، بل هي فضيلة كبرى، أما تدني مستويات الإنتاج الزراعي، فهي مقترنة بالاضطراب السياسي الذي سببه التدخل الغربي، فعندما يقول: تناسي تقنيات كانت مزدهرة في وقت سابق، فأي وقت سابق يقصد (جاك بارك)؟ إنه الوقت التي كانت فيه المغرب مستقرة بحكمها وإداراتها، وكانت تصدر العلوم الزراعية لأوروبا التي لم تنكر ذلك أصلا! |
(7)
لنبتعد قليلا عن أقوال الدارسين (في الإرساليات) ونتمعن بأقوال رجل ميدان عاشر الفلاحين المغاربة عن قرب، فإنه سيثبت لنا عكس ما قيل، (( إن ساكن البلاد الأصلي هو إنسان قابل للتحسن ومرن وراغب في التقدم الرغبة كلها، ويتكيف مع كل الاستحداثات ، فيستخدم المواد الصلبة في بناءه ويميل لاستخدام الآلات الزراعية ويتميز الفلاح المغربي بشجاعته وسعيه للرخاء))*6 هذا يثبت أن النظرة الغربية، والتي لا تزال تستخدم في تفسير كل ما يجري في غزة والعراق والسودان، على أن هؤلاء الناس متخلفون ويقعون في شر أعمالهم التي تمدهم بها عقائدهم، ما هي إلا ترهات أراد بها الغرب تبرير جشعهم الذي بات مكشوفا لدى كل شعوب العالم. هوامش (من وضع الباحث) مع مراعاة عدم القدرة على وضع الحروف الفرنسية *1ـ Charles Louis de Scondat Montesquieu, De l,esprit des lois (Paris Larousse, 1934. p 63 *2ـ شتيمة وقحة وعنصرية استعملها الفرنسيون لقذف العرب، وتعني الجدي [المترجم]. *3ـ A. Montagne La Revolution agaraire au Maroc CHEAM, p.29. *4ـ Robert Montagne, Naissance du proletariat marocain (Paris: Peyronnet et Cie pp.219-220 *5 ـ Berque "Vers la modernization du Fellah marocain p.16 *6ـ A. Montagne La Revolution agaraire au Maroc CHEAM, |
الفصل الرابع عشر: صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية..
قدمته: مارلين نصر.. باحثة من لبنان ( صفحات 463ـ 496) تقديم: هل التنظيم التعليمي الفرنسي التعددي والديمقراطي نسبيا بتعدد دور النشر فيه؟ وكيف يُصَوَر (العرب) و (المسلمون) في تاريخ علاقات الفرنسيين والغرب الأوروبي بهم عند الفتح الإسلامي والحملات الصليبية والتوسع الاستعماري (حالة الجزائر وشمال إفريقيا) وفي الصراعات المعاصرة كالحروب العربية ـ الإسرائيلية؟ هل تذكر كُتب الجغرافيا الفرنسية أن هناك منطقة عربية؟ هل هناك تناول للنصوص الأدبية العربية بطريقة تنصفهم فيها؟ كثيرة هي الأسئلة المطروحة في هذا الفصل. تحاول الكاتبة اللبنانية (مارلين نصر) التطرق لها. أولا: العرب: الزمن، المكان، الحضارة. 1ـ العرب في الماضي. السمتان السائدتان في مجموعة السمات التي تخص العرب هما (الماضوية) وتجنب العرب في الزمن الحاضر. فالحديث عن العرب يأخذ سمة دون مكان، أما الزمان فإنه يتحدث عن العصور الوسطى، ونادرا ما يوجد مصطلح حتى مثل (العالم العربي)، ولا ذكر للمدن العربية، فإن ذكرت إحداهن وصفت على أنها من المدن الإسلامية. أما الأدب فيتناول نصوصا دون تاريخ تنسب للماضي السحيق، وإن أرادت المناهج أن تتحدث عن أدب معاصر فتتناول أدب المهجر، وذلك النوع المتعلق بالعمال العرب المهاجرين، أو سكان أحياء الصفيح في المدن العربية. 2ـ العرب: من دون مكان ولا أراضٍ في مناهج المدارس الابتدائية، يوصف العرب بأنهم يتنقلون كالغجر في صحراء لا حدود لها. وفي مناهج المدارس المتوسطة يذكر مؤلفو الكتب أن العرب استطاعوا احتلال أجزاء من ثلاث قارات وأقاموا عليها إمبراطوريتهم، وهي عندما تتكلم عن الغزو الصليبي واحتلال البلدان العربية، لا تتحدث عنها وكأنها بلاد لها أصحاب يقطنون فيها. أما عن فلسطين، فهم يتكلمون عن ضم الأردن للضفة الغربية، وضم مصر لسيناء ولا يعتبرون احتلال الكيان الصهيوني لهما على أنه احتلال، بل هي أراض لا مالكي لها! في كتب الجغرافيا، يتحاشى المؤلفون ذكر أقطارٍ، بل يذكرون الصحراء الإفريقية الكبرى الحارة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشرق المتوسط. وإن أرادوا التكلم عن مخيم للاجئين الفلسطينيين لا يحددون مكانه بل يذكرون أنه يبعد عن حدود إسرائيل بمسافة كذا. بالمقابل تمتلئ الكتب بلفظ مثل العالم الإسلامي. تجيب الباحثة عن سؤال: لماذا يتجنب المؤلفون ذكر كلمة بلدان عربية أو ذكر وطن عربي، ويركزون على العالم الإسلامي (بشريا) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانا، بأن وراء ذلك ترسيخ فكرة أنه لا ملكية لتلك البلدان من العرب، وأن التوسع الاستعماري الصهيوني ومحاولة قضم أطراف البلدان العربية، ما هي إلا مسألة طبيعية، يتم فيها ما تم في أستراليا أو أمريكا. 3ـ حضارة إسلامية أو حضارة عربية؟ اتجهت كتب التاريخ في (الجمهورية الثالثة) الى اعتبار المسلمين لم يحققوا خَلْقاً أو إبداعا، بل نقلوا وحفظوا ما أنتجه غيرهم، ولم تكن إضافاتهم ذات قيمة. أما النظرة الى الإسلام فهي تتلخص ب: الإسلام دين القواعد والخضوع التوسع السريع للإسلام من دون اهتمام بشرح أسبابه الجغرافية السياسية وسياقه التاريخي. التأكيد على أن تاريخ الحضارة الإسلامية هو تاريخ لانقسامات مستمرة. أحادية ثقافية وعرقية للعالم الإسلامي مع تقليصه الى المكون العربي فيه من دون ذكره بالاسم. المزج والترادف بين (العربي) و (الإسلامي) المدنية والفنون غير متوافقة مع (العروبة) المجتمع الإسلامي مجتمع عبودي ثانيا: العلاقات بين (الفرنسيين) و (العرب) في الكتب المدرسية. 1ـ قصص مجابهة تتحدث كل المناهج المدرسية، عن مجابهات بين العرب والفرنسيين، منذ معركة بلاط الشهداء حتى حرب أكتوبر 1973، وتتلخص كلها في أن العرب هم من يبدءون بالاعتداء ثم يهربوا خاسرين الى عالمهم السحري، ولا تستثني تلك المنهجية الحروب الصليبية أو احتلال مصر أو احتلال الجزائر، وحتى الحروب مع إسرائيل، فكلها بنظر المؤلفين بسبب عدوانية العرب، ويردهم الأبطال الفرنسيون! 2ـ العرب والفرنسيون ثنائي متعارض أ ـ عدم تعادل في إثبات هوية الفاعلين في التاريخ لا تذكر كتب التاريخ الفرنسي اسم أي شخصية عربية أو إسلامية سوى اسم الرسول محمد صلوات الله عليه. في حين يتردد اسم (شارل مارتل) القائد الفرنسي المنتصر في معركة بلاط الشهداء، وشارلمان وأسماء قادة الحملات الصليبية كلهم، في حين لا يذكر من القادة العرب أو المسلمين أحد، حتى صلاح الدين ذائع الشهرة. كما لم يُذكر من اشترك في الحروب ضدهم من شعوب إسلامية، لا أكراد، ولا أتراك ولا غيرها. في حين تتناول الكتب القادة الفرنسيين ومعاونيهم وعائلاتهم ومهنهم التي كانوا يزاولونها قبل غزواتهم. ب ـ دونية (العرب) ولا فاعليتهم مقابل تفوق الفرنسيين وفاعليتهم. تصور الكتب المدرسية العرب بأنهم يتسابقون لإرشاد الفرنسيين على كيفية الدخول لاحتلال أراضي بلدانهم، وتصور حتى شيوخهم وسادتهم كيف يتمتعون في خدمة الفرنسيين. ج ـ العرب فاعل سلبي، الفرنسيون أو الإسرائيليون فاعل إيجابي. يبرز الكتاب أن البربر أو العرب (هم لا يفرقون بينهما) متدنيين مستسلمين، في حين يكون الفرنسي أو الإسرائيلي فيما بعد، هو السيد الذي يبحث ويخطط ويبني ويدافع، أمام العربي/البربري الذي يهدم ويعتدي ولا يريد أن يتعلم. هم هنا يعتبرون أن كل الصراعات التي دارت بين العرب وغيرهم سببها العرب كمعتدين! ثالثا: تضارب المواقف بين الناشرين 1ـ قوالب معادية للعرب اندثرت. أخذت بعض القوالب في الاندثار مثل: (العرب متأخرون أو بدائيون) أو (العرب متعصبون) أو (العرب لصوص نهابون). 2ـ قوالب معادية للعرب محل خلاف يختلف الناشرون الفرنسيون في الوقت الحاضر على عدة قوالب فمنهم من أبقاها ومنهم من نقضها، مثل: ( الإسلام يقوم على التعصب) أو (الإسلام متسامح). العرب يؤمنون بالخرافات وقدريون. العرب خوافون وجبناء. العرب متنقلون لا أراض لهم، وهم دخلاء على أراضي الغير ويطمعون في ثروات الآخرين. العربي بطيء وكسول وضعيف الإنتاج. 3ـ القوالب الراسخة المعادية للعرب العربي سلبي وغير مبادر، يميل الى التمرد، لكنه لا ينتصر. |
الفصل الخامس والعشرون: اليهود والعرب: صورة الآخر وآثار المرآة ..
تقديم: ريجين عزرية : باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي cnrc باريس . مقدمة: تنبثق صورة الآخر عند كل من العربي واليهودي من تشابك علاقات معقدة تتداخل في طياتها الأسطورة والتاريخ مع الأحداث الراهنة النازلة بثقلها الآن، تداخلا لا فكاك منه وصل الى حد الإيحاء بأن اليهود والعرب في قبضة ضرب من ضروب القدر المحتوم، فقضي عليهما بملاقاة الآخر أبد الدهر. ينتمي العرب واليهود الى ذرية منحدرة من ابراهيم الخليل، وأمين متضارتين (سارة وهاجر)، ويبدو النزاع فيما بينهما أحيانا وكأنه حول شرعية نسب الأبوة، أو تدخل طرف ثالث وهو الله في تعزيز تلك الشرعية فالله عز وجل خاطب بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين كما خاطب العرب الذين حملوا لواء الإسلام بأنهم خير أمة أخرجت للناس. لننظر كيف صاغ الغرب صوره عن اليهودي وعن العربي: أولا: لليهودي والعربي صور كثيرة 1ـ في التمثلات الغربية يشترط لفظ (غرب) أن يفهم ههنا بمدلوله الديني، أي الغرب المسيحي، وفي مدلوله الشائع نسبةً الى مفهوم الحداثة. الخصومة بين الغرب واليهود تعود الى عصر أثينا المزدهر، أما في أيامنا الراهنة، فإن ما حدث، وإن كانت اليهودية والمسيحية تعتبران فرعان لمنبت واحد هو العبرية، إلا أن اليهودية أصرت على ثالوث الانعزال ( الشعب ـ الأرض ـ الشريعة)، في حين تخلت المسيحية عن ذلك ونزلت الى العالم التحتاني لتحقيق رسالتها شعبيا بما يرضي الله. أما فيما يتصل الأمر بصورة العربي في التمثلات الغربية، فإن فيه مشهدان: الأول عندما فرض العرب (المسلمون) سلطانهم على الغرب المسيحي، والمشهد الثاني عند ازدهار العصر الكولونيالي (الاستعماري) الغربي، عندما حاول الغرب طمس آثار المسلمين ومحو تأثيرهم في التراث العالمي، إلا فيما ندر من إبقاء بعض آثارهم الرائعة في غرناطة، أو الإشارة الخجولة لعظما علماء العرب المتبحرين الذي لا انفكاك من ذكر أثرهم في التطور الحضاري العالمي. 2ـ في التمثلات اليهودية والعربية إذا كان احتكاك الغرب بالعرب هو احتكاك عدائي ومؤقت في نفس الوقت، وأن صورة الآخر عند الطرفين قد تم تكوينها على استعجال وعن بعد، فإن المسألة عند اليهود واختلاطهم بالعرب مختلفة. فاليهود أصلا من منشأ يعود للمنطقة العربية، فالحنين للماضي وألوانه وروائحه وموسيقاه ومذاق مأكولاته يلف كيان اليهود الذين عاشوا في مناطق تمتد من اليمن والبحرين لتصل الى المغرب، ولكنه حنين مخلوط بكراهية تاريخية. في حين أن اليهود الذين تنحدر أصولهم العميقة الى الغرب وبالذات روسيا وبولندا وهم الذين باشروا في إقامة المستوطنات في فلسطين عند بداية المشروع الصهيوني، لم تكن صورهم واقعية بل صور تم تشكيلها تثقيفيا ودعائيا. ثانيا: العرب والإبادة الجماعية 1ـ قبل حرب حزيران/يونيو 1967: شبح الإبادة نتيجة لما آل إليه وضع اليهود بعد الحرب العالمية الثانية من إبادة وعنف على يد الألمان، ونتيجة لما كان يحظى به (هتلر) من تأييد عربي علني وسري (رشيد عالي الكيلاني في العراق) وابتهاج الصفوة العربية بما كان يمارسه هتلر ضد اليهود، ونتيجة للخطاب العربي الذي سبق عام 1967 بالتهديد برمي اليهود بالبحر، نتيجة لكل ذلك قام الغرب بتأييد لليهود لتحقيق ما يلي: أ ـ تبرئة نفسه تجاه اليهودي، مكتشفا فيه الإنسان ذا الأنفة الذي أصبح عليه. ب ـ تنزيه نفسه عن خطيئة معاداة السامية وإلصاقها بالعرب. ج ـ نعت العربي بالمحرض على العنف والاضطرابات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 2 ـ بداية الحرب 1967: ازدواج الاستخدام المصطنع للإبادة العرقية. منذ حرب 1967 ولغاية الآن تم تبادل الصور بطريقة أثرت على وقع الأحداث على المراقب العادي عالميا، فبعد خطابات عبد الناصر النارية المهددة لليهود وخطابات احمد الشقيري وأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وامتلاء الفضاء العربي بجو مفعم بالعدوان، استغل اليهود ذلك المشهد ليعيدوا صورة (داوود وجالوت) كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فصوروا للغرب أنهم أمام تهديد سيحدد مصيرهم في الحياة. وبعد 1967، قلب الفلسطينيون تلك الصورة بالانتفاضة ليقولوا للعالم نحن أمام (جالوت الطاغية) ونحن داوود وفئته القليلة. ثالثا: الشتات ورابطة الأرض والفضاء في أوروبا الغربية يتشابه وضع اليهود والعرب، بكونهم مهاجرين حديثين في عدة أوجه، توحي تلك الأوجه لأول وهلة أن الطرفين سيكونان على تفاهم في تماثل أوضاعهما: 1ـ الأقلية يشكل اليهود والعرب في أوروبا أقلية طائفية، أو أقلية عرقية دينية. لكن اليهود استطاعوا التواجد في كل شرائح المجتمع، باستثناء الريف، في حين يعيش العرب والمغاربة على وجه الخصوص ظروفا صعبة تتعلق باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة ومهمشة في نفس الوقت. 2ـ الوسم في نهاية القرن التاسع عشر، عندما تتابعت الهجرات اليهودية من روسيا وأوروبا الشرقية الى أوروبا الغربية، كانت الثقافة الأوروبية متهيأة لوسمهم بأسوأ العبارات، فنعتوهم بالبرابرة الغزاة والقذرون وأصبحوا مثار للسخرية بسبب ملابسهم ولغتهم القبيحة ومظهرهم المزري. اليوم، يمارس الغرب الأوروبي نفس الطقوس التقييمية تجاه العرب والمسلمين، في حين خفت حدة نظرتهم تجاه اليهود، الذين استطاعوا تثبيت أقدامهم لاتقاء مثل تلك الممارسات. 3ـ التشتيت تحاول الكاتبة هنا، أن تصل الى ما أسمته (نظريتها) وهي أن كل الأقوام المبعثرة والمشتتة لا بد أن تعود الى منشأها، وهي وإن حاولت في كل ذلك البحث أن تظهر بمظهر المحايد إلا أن استنتاجها هنا في الوصول لتلك النظرية التي نسبتها لنفسها أن تبين انحيازها لجانب اليهود. (حاولت أن أجد تعريفا لتلك الكاتبة غير المذكور في الكتاب لكني أخفقت) فتقول: إذا كان يهود روسيا وبولندا لا يستطيعون العودة الى بلدانهم، فإن المنشأ الأصلي الذي يستوجب العودة إليه هو (فلسطين)! ثم تذهب الى العرب والمسلمين في أوروبا، فتقول أن هؤلاء لا يمكن دمجهم بالمجتمعات الأوروبية وبنفس الوقت يستطيعون العودة الى بلدانهم الأصلية وهي موجودة (البلدان العربية) فلماذا لا يعودون؟؟؟ |
الفصل السادس والعشرون: الكنيسة الكاثوليكية والإسلام ..
تقديم: آنزو باتشي .. أستاذ في جامعة بادوفا ـ إيطاليا من الجائز أن يصبح تحليل الصورة التي تنحتها الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا عن الإسلام المعاصر موضوعا (سوسيولوجياً) مفيدا شريطة أن ندرس هذه المسألة في سياق ما استحدثته هذه الكنيسة من استراتيجية على إثر سقوط جدار برلين. ما هي استراتيجية الكنيسة الكاثوليكية؟ بادرت الكنيسة الكاثوليكية بعد انهيار الشيوعية، الى إعلانها أن ذلك يعود الى انتصار ملكوت الخير على ملكوت الشر، وذكرت العالم بنشاطها من أجل دحر الشيوعية. ثم قامت الكنيسة الكاثوليكية لتعلن نفسها رائدة على صعيد العلاقات التواصلية، فإرادة الحوار التي يجب أن تسود العالم لا بد لها من أن يكون لها ممثلٌ عن الغرب المسيحي، وتقدم الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها الأكثر جدارة بهذا التمثيل عن كل المسيحيين بما فيهم الأرثوذكس والبروتستانت. إن الكنيسة الكاثوليكية بذلك التوجه الاستراتيجي، تريد أن تفرض هيمنتها على الكنائس الأخرى، ولكنها تحاول تغطية ذلك الاستحواذ بغطاء أخلاقي، يظهر الرغبة في سيادة السلام والمحبة في العالم، ومن جانب آخر تريد إظهار الإسلام كعدو لا تستطيع أي كنيسة التعامل معه كما تتعامل الكنيسة الكاثوليكية. وساطات الكنيسة الكاثوليكية وتدخلاتها في سعي بعض الدول الإسلامية للاندماج مع الكتلة الأوروبية الغربية، أو أخذ حظوة استثنائية منها، كما حدث في مطالبات المغرب بذلك سابقا، أو ما يحدث مع تركيا اليوم، فيجب على تلك الدول القبول بوساطة الكنيسة الكاثوليكية، أي القبول بأرضية حوار تقلل من المزاعم التبشيرية للاسلام في أوروبا، كما ذُكر في كتابات (Bastenier) و (Dassetto). نشاطات الكنيسة الكاثوليكية فيما يخص الإسلام تعتبر نشاطات الكنيسة الكاثوليكية حديثة العهد بالنسبة للإسلام، وتعود بداياتها (الحديثة) الى اهتمام (مجمع الفاتيكان الثاني عام 1963) وتبعه طائفة من الأحداث لها مضمون رمزي هائل مثل: 1ـ خطابات البابا بولس السادس في آب/أغسطس 1969 في أوغندا. 2ـ العديد من المنتديات الإسلامية المسيحية التي صارت تغذي المعرفة المتبادلة على المستوى اللاهوتي وبين علماء مسلمين، ابتداء من منتدى طرابلس 1976. 3ـ لقاء البابا يوحنا بولس الثاني مع ملك المغرب الحسن الثاني 1985 4ـ الصلوات المسكونية التوحيدية المقامة عام 1986 و 1992 في آسيزي. 5ـ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للسودان 1993. لنلقي نظرة على التطور الحاصل في إنشاء صورة الإسلام داخل الكنيسة المسيحية الأوروبية: أولا: الصورة المشوهة كانت الصورة القديمة عن الإسلام في أوروبا من قبل الحروب الصليبية ولغاية العصر الراهن تتمثل بما يلي: 1ـ الإسلام عبارة عن (هرطقة مسيحية) هذا ما قاله: يوحنا الدمشقي في الماضي. وهو ما قيل عن المسيحية من قبل اليهود على أن المسيحية عبارة عن هرطقة يهودية. 2ـ يلقب محمد صلوات الله عليه، بألقاب أطلقها المسيحيون على اليهود بالدجل والتضليل. 3ـ نعت المسيحيون الديانة الإسلامية بأنها ديانة المتعة الجسدية (مقابل المسيحية بأنها الديانة الروحانية). 4ـ وعليه فإن الديانة الإسلامية أدنى مرتبة من الديانة المسيحية حسب (لاغرانج) ويصف (برنارد لويس) و (عبد الله العروي) أن بين الإسلام والمسيحية قامت (لعبة مرايا) تقليدية لا فكاك منها، إذ تصف كل ديانة الديانة الأخرى بالكفر والجهل. ثانيا: الصورة المصححة أعلن مجمع الفاتيكان الثاني وثيقة أسماها (إعلان القطيعة مع الماضي في 28/10/1964 سنلخص أهم ما جاء فيها: 1ـ تكن الكنيسة الكاثوليكية للمسلمين تقديرا ساميا لأنهم يعبدون الرب الأوحد الحي الذي تكلم الى الإنسانية. وهم يخضعون لله شأنهم شأن ابراهيم عليه السلام. 2ـ إنهم يكرمون عيسى المسيح عليه السلام باعتباره نبيا، كما يكرمون أمه مريم باعتبارها قديسة. على الرغم من أنهم ينكرون أن المسيح هو الله، حيث يصفونه أحيانا بالتقوى ومخافة الله. 3ـ إنهم ينتظرون يوم الحساب عندما يجازي الرب كل العائدين. ويقدرون الحياة الأخلاقية ويعبدون الله صلاةً وصدقةً وصياماً. 4ـ تنهي الوثيقة القول: لننس الفتن والأحقاد، ولننهض مدافعين معا عن العدل الاجتماعي والقيم الأخلاقية والسلم والحرية بين البشر. خاتمة يختتم المؤلف (الباحث الاجتماعي) ورقة عمله بالقول: إنه انقلاب هائل حدث من قبل الكنيسة الكاثوليكية (حسب اعتراف كافتارو: مفتي سوريا 1989). وبهذا تم إدراك المسيحيين أن الدين الإسلامي هو دين سماوي له وزنه وتأثيره في المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي. كما أقر الباحث أن المسلمين ينظرون للديانة المسيحية على أنها كديانتهم ديانة سماوية لها وزنها في كل المجالات. |
الفصل السابع والعشرون: المغرب العربي في رؤية بلدان الشمال..
(الصفحات من 519ـ 529) تقديم: تيومو ميلازيو .. باحث في معهد العلوم حول السلم ـ فنلندا مقدمة ينتمي أغلبية العالم العربي والمغرب العربي الى مجموع البحر الأبيض المتوسط الذي كان دائما وبطرق مختلفة يستجلب اهتمام بلدان الشمال والبلدان الاسكندينافية. ويعود اتصال الشعوب الاسكندينافية الى القرن الرابع قبل الميلاد، أي الى رحلة الجغرافي المارسيلي (بتيا Pitea) في القرن الرابع قبل الميلاد، كما عرفت بلاد المغرب العربي كخصم شرس للإمبراطورية الرومانية، وذلك في عصر الفينيقيين. وبالمقابل فإن (الفيكينز Vikings) قد بلغت مغامراتهم شمال إفريقيا، مرورا بمضيق جبل طارق أو مرورا بالبحر الأسود سالكين الأنهر الروسية، وقد عرف سكان المتوسط (الفيكينز Vikings) كتجار ممتازين للعنبر. وقد وجدت قطع نقدية (شرق أوسطية) قديمة في البلدان الاسكندينافية. ويذكر الكاتب (تيومو ميلازيو) الإدريسي وابن خلدون ويشهد بمعرفتهما بالشعوب والبلدان الاسكندينافية. ويذكر أيضا أنه بعد تنصير (الدول الاسكندينافية) في القرن التاسع، قد انخفضت وتيرة العلاقات بينهم وبين العرب. أولا: الوسط الفني استرعى المغرب العربي منذ القرن التاسع عشر اهتمام عدد من الفنانين الشماليين. وهم على وجه الخصوص من الرسامين والكتاب الذين يترددون على المغرب الكبير. فما هو مضمون صورة المغرب الكبير التي نقلوها الى جمهور الناس في الشمال وما هي دلالتها؟ فيما يتصل بالأدب، حاول (ميكا والتاري Mika Waltari) على سبيل المثال، أن يرسم في أثره الروائي صورة عن مدن كتونس والجزائر، عندما كانتا تتبعان الإمبراطورية العثمانية. كذلك فعلت الكاتبة (آينو كالاس Aino Kallas) التي أقامت أعواما كثيرة في المغرب في العشرينات من القرن العشرين، في صحبة زوجها الدبلوماسي، فتحدثت في كتابها مفاتن المغرب (Marokon Lumoissa) بشكل إيجابي عن المغرب، وكانت تكتب عن النساء المغربيات اللواتي التقت بها، فكانت تشبه المرأة المغربية ب (نبتة السحلب الجميلة [أوركيدا: Orchidee) التي تمكث متحفظة دون أن تبوح بخوالجها وحركات النفس داخلها. كانت (آينو كالاس Aino Kallas) قريبة جدا من الحركة الفنلندية المسماة ب (حملة النار Tulenkantajatt) وهي حركة صوفية نحتت صورة عن الشرق وفتنت بها دون أن يكون كل أعضائها قد زاروا الشرق لكن اطلاعهم على العرب والبربر والموريين كونوا خيالا لدى أعضاء تلك الحركة. بالمقابل فإن أعمالا أدبية لكتاب مثل: (الطاهر بن جلون أو محمد ديب) قد ترجمت أعمالهم الى اللغة السويدية والفنلندية. وفيما يخص الرسم، فقد جاب الفنان الفنلندي (أكسيلي غالين كالالا) المنعوت بالرسام القومي لفنلندا البلاد التونسية بصحبة عالم الاجتماع (أدفارد واسترمارك). والرسام (باكمانسون) الذي قضى سنوات في المغرب وفي (فاس) بالذات حيث رسم (بورترييه) للسلطان (مولاي حافظ) عام 1909. ثانيا: الوسط العلمي تطرقت العلوم في البلدان الشمالية منذ القرن التاسع عشر الى ميادين علمية كثيرة تتعلق بالمغرب الكبير. وقام عالم الحيوان (ساهلبيرغ) بالسفر ودراسة الكائنات الحية وبالذات الحشرات في المغرب لحساب جامعة (توركو). كما قام مجموعة من العلماء بدراسة الأوضاع الاقتصادية فيما يخص البربر والطوارق حتى أصبح هذا المجال وكأنه تخصص تقليدي لعلماء الشمال أمثال (غوستا موبارغ). كما تشكلت جمعية لدراسات الشرق الأوسط في بلدان الشمال عام 1989، وقد عقدت مؤتمرها عام 1992 تحت عنوان (الشرق الأوسط: التنوع والوحدة)، تم مناقشة 120 بحثا فيه. ثالثا: الوسط السياسي تدلل الأعداد الوفيرة من (الفرمانات المغاربية) الموجودة في الأرشيفات الشمالية والتي تعود للحقبة العثمانية على العلاقات القائمة بين هذين الجزأين من العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما في الفترة الاستعمارية، فتدلل كثرة القنصليات الشمالية في البلدان العربية والمغاربية على كثافة الاهتمام الشمالي. وقد ابتدأ (أولف بالم) رئيس وزراء السويد حياته السياسية بالنضالات الشعبية التي سببتها (حرب الجزائر) وكانت صحيفة (المجاهد) الجزائرية لسان حال جبهة التحرير الجزائرية، تترجم الى اللغة السويدية لمدة أربع سنوات. كما أن الزيارات التي كانت تتم أثناء حروب التحرير المغاربية الى الدول الشمالية (الحبيب بو رقيبة) أو زيارة الرئيس الفنلندي (أورو كاكونين ) الى تونس تدلل على عمق التواصل والاهتمام. كما علينا أن لا ننسى ارتياح العرب للإقامة بحرية في الدول الشمالية، والأوساط الحميمية التي يعيشون فيها. لم يذكر الباحث اتفاقية أوسلو ليدلل على ذلك، لكنها تدلل على ما ذهب إليه. |
الفصل الثامن والعشرون: في معضلة الباحث ووضع البحث في العلوم الاجتماعية حول العالم العربي في الجامعة الفرنسية..
صفحات (531ـ 544) تقديم: اليزابيث لونغنس .. باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي cnrc باريس . ال (1) كان العالم العربي في أعين الجيل الذي بلغ من العمر عقدين سنة 1968، يعني أولا وقبل كل شيء الجزائر و فلسطين. أما العربي فكان يعني عنده (فرانز فانون)*1 و (عبد القادر)، ذلك المكافح من أجل تحرير بلاده ضد الهيمنة الاستعمارية. بعد تصفية الاستعمار ودخول العالم في الحرب الباردة، عاش الفرنسيون حياة ممزوجة بين عظمة الإمبراطورية وبين انحطاطها. فما من فرنسي إلا وكان له أخ أو عم أو خال كان ضمن المسيرين أو المبعوثين أو المبشرين في المستعمرات، وما أن جاء عام 1960 حتى دخل الفرنسيون في مرحلة تأمل في ماضيهم الاستعماري وخطابهم الإنساني. تنامى عدد الطلاب الفرنسيين باطراد فقفز من 100 ألف طالب الى 600 ألف طالب، خلال 15 سنة، وكان هؤلاء الطلبة ليسوا من أبناء العائلات الأرستقراطية بل معظمهم من عموم الشعب، ومع تيسر الحصول على الأخبار من وسائل الإعلام الحديثة، اتخذت الدراسات الاجتماعية المهتمة بعلوم الاجتماع للشعوب طريقا مستقلا، وأصبح (سارتر) و (هنري لفيفر) و (ألتوسير) و (فوكو) و(ليفي شتراوس) منارات للحياة الفكرية والجامعية. وبنفس الوقت كانت البلدان العربية تتغير هي الأخرى، فخرج منها أشخاص يهتمون بالطب والعمران والعلوم والسياسة وكان هناك من مصر وتونس وأقطار عربية أخرى أشخاص يكتبون عن الفكر المقارن، ويؤشرون على ثغرات في الفكر الغربي والفرنسي بالذات. (2) تقدم الباحثة الفرنسية نفسها، لتربط هذا التقديم ببحثها، فتذكر أنها تنتمي للفكر الشيوعي، وقد عاشت في منطقة سوريا ولبنان وصاهرت اللبنانيين، وعليه فإنها ستكون في موضع يسمح لها وكأنها تتكلم من الداخل العربي، بروح ماركسية، حتى وإن كان تمويل بحوثها من دولتها المنتمية للفكر الليبرالي الاستعماري. وتعرج الباحثة على الماركسيين العرب، فتقول: أنهم أخطئوا إذ قدموا أنفسهم على أنهم يلتزمون بفكر مستورد، مما جعلهم لا يتقدمون في نضالهم، وكان أولى بهم أن يراعوا واقعهم العربي ويكيفوا أفكارهم التي من خصائصها وحدة النضال العالمي وتلاحم مشاكل المضطهدين في كل أنحاء العالم، ويجعلوا تلك الأفكار منسجمة مع واقع مجتمعاتهم وطبيعة تفكيرها، وأنهم لو فعلوا ذلك، لما كانت تلك الحركات الأصولية المتطرفة لتظهر في المنطقة العربية. لذلك، عليهم مراجعة مسلكهم النضالي مراجعة دامية حتى يستطيعوا إعادة تقديم أنفسهم بشكل مقنع لشعوبهم. وبعد عودتها لفرنسا، تقول الباحثة: أنها عاودت التفكير الى واقع المنطقة العربية بعيون فرنسية، وليس كما كانت تتناول ذلك الواقع وهي تعيش في لبنان. (3) في فرنسا، صارت المسألة المتعلقة بدراسة مجتمع ما، تنكب على معرفة الشروط التي بمقتضاها يمكن إنتاج نوع من المعرفة حول ذلك المجتمع. وصار السؤال هو: كيف يمكن للجامعة الفرنسية وللأشخاص الذين ينتمون الى حرمها أن ينتجوا، على وجه الحصر والتحديد، معرفة المجتمعات العربية؟ وما هي شروط هذه المعرفة وما هي أهدافها؟ سابقا، وعلى الأقل حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين، كانت العلوم الاجتماعية متأثرة بالحوارات الأيديولوجية السياسية أكثر مما هي عليه اليوم، وكانت المواقف النظرية تنحو منحى شمولياً وإقصائياً. وكان الأمر يصدق على جميع الماركسيين صدقاً أشد. وكانت النزعة الفردية للباحث تظهر في المساجلات بين المتحاورين. إن الخطاب الغربي حول المجتمعات العربية يتأثر بالضرورة بتطور المجتمعات العربية وبتطور المجتمعات الغربية على حد سواء. ويمكن القول بأن الاستشراق الكلاسيكي قد زال من الوجود، بزوال موضوعه، أي أن الاستشراق الذي يمكن لصقه بما يسمى (ثقافة العلماء) الذين يكونون مواقفهم من خلال مواقف وثقافة علماء آخرين. لقد تغير هذا النمط من المعرفة والثقافة تجاه (الآخر) بتغير وسائل ومصادر تلك المعرفة، وظهر جيل من العلماء أقل شهرة ممن قبلهم، لكن إنتاجهم ليس بالضرورة أن يكون أقل قيمة من إنتاج من سبقهم. (4) بعد التشظي الذي حصل في جهود المستشرقين، وبعد تشابك الجهود بين المفكرين في العالم الغربي والبلدان العربية، فإننا لا زلنا ننتظر إعادة صياغة الصور النهائية لتلك المعرفة الجديدة حول الآخر (العربي). ثمة من الناس من يكتب، وثمة من يتكلم، وثمة من نتكلم عنهم، وثمة من نُقَوُلهم وثمة من يُعَلِم الآخرين، وثمة من نرسم لهم الكتب والمصادر والمراجع لنسوقهم لمعرفة نحن نحدد شكلها. وكما أنه في فرنسا من هو مهتم باستمرار في مثل تلك البحوث أمثال (أوليفييه كاري) و (برونو إيتيان) و (جان لوكا) على سبيل المثال لا الحصر، فإن في الوطن العربي شخصيات معترف بها عالميا مثل (سمير أمين) و (غسان سلامة) و (جورج قرم) .. وهناك آلاف الطلبة العرب الذين يعدون لشهادات الدكتوراه في فرنسا، وهناك الكثير من المفكرين في الجاليات العربية في فرنسا، وهناك في البلدان العربية من العاملين كالنمل باجتهادهم وبتواضع أكبر وفي الخفاء يقومون بعملهم بعيدين عن الاستعراض المسرحي، كل ذلك يجعل الصورة الحالية متشابكة ومتفاعلة في انتظار توضيح معالمها. (5) للبحوث الاجتماعية، مطلبان: الأول يستدعيه الوضع السياسي الراهن ويعبر عنه رجال السياسة والمثقفون ويرتبط بالإعلام. والثاني، مطلب علمي يصدر عن الهيئة الجامعية والعلمية. في المطلب الثاني، تعني البحوث في فنون العمارة والنقل والري والصحة ولكنها ليست بعيدة عن المطلب الأول، كذلك تعني البحوث المهتمة بالمرأة والأسرة وغيرها. في الستينات من القرن الماضي، كانت المشاكل المطروحة تعني بالتحرر والتخلص من التبعية الاستعمارية وتستدعي حشد الجهود لتحقيق تلك الأهداف، ولم تكن تنتبه الى قضايا تفصيلية متعلقة بالمجتمع والبناء والموسيقى وغيرها. (6) تقول الباحثة: قادتني دراسة حول المهندسين العرب، الى التفكير في تعريف الوضع المهني، فنموذج المهندس في عقلية الغرب هو المهندس الذي يستكمل سياقات منهج التعليم الهندسي في البلدان المتقدمة. في الحالة العربية، يعبر المهندس العربي عن مهنته تعبيرا قد يختلف عن التعبير عند الفرنسي، وعلينا أن نقبل بذلك كما نقبله عند المهندس الأمريكي والياباني والمهندس الإفريقي. هذا الوضع يجعلنا نتروى في إعلان تشخيصنا لبعض المشكلات العربية، كما فهمناها من خلال مخزوننا المعرفي، وبالتالي فإن المدارس والجامعات التي تخرج مثل هؤلاء المهندسين في البلدان العربية ليست مطالبة بالالتزام بتدويل وعولمة المعرفة الهندسية. (7) تختتم الباحثة بحثها بالقول: المطلوب إذن هو أن نركز تفكيرنا من جديد في شروط إنتاج المعرفة وفي ما تفرضه الخطابات العلمية من رهانات على كل سياق قومي. ويبدو لي (الكلام للباحثة) أن قراءتنا نحن الغربيين للمجتمعات العربية لن تكون أبدا سوى قراءة متأثرة بقراءتنا لمجتمعاتنا. وتتساءل الباحثة: هل يجوز لنا أن نتجاهل كيف تخلط وسائل إعلامنا بين الإسلام والإسلاميين، وتتناسى غالب الأحيان أن وراء طاغية ما يوجد شعب هو أول ضحاياه. وعليه فإن المطلوب أن نطور بحوثنا هنا في فرنسا حول الوطن العربي، وأن لا نجاهر بالنتائج قبل التيقن أننا كنا غير متحيزين لصور قُدمت لنا مشوهة. هوامش *1ـ فرانز فانون، طبيب فرنسي وفيلسوف أسود من مواليد (المارتينيك)، عمل مع الجيش الفرنسي في الجزائر ولكنه انضم الى جبهة التحرير الوطني الجزائري، والتي عين سفيرا لحكومتها المؤقتة في غانا، ترأس صحيفة المجاهد الجزائرية، وتوفي بعد مرض عضال عام 1961 عن عمر 36 سنة. |
الفصل التاسع والعشرون: صورة الآخرين: المخاوف الحقيقية والكاذبة في العلاقات العربية ـ الأوروبية ..
تقديم: سيغوردن سكيرباك .. أستاذ في جامعة أوسلو النرويج الصفحات (545ـ 558) أولا: الحكم المسبق عن الآخرين لم يأتِ الباحث هنا بجديد، فقد ذكره من قدمناه، فهو يؤكد وجود قوالب جامدة لدى الناس أو الأفراد، تجاه الآخرين، وهذا يشمل العلاقات العربية الأوروبية. ثانيا: برنامج الأنوار أن تفهم كل شيء هو أن تغفر كل شيء. هذا نمط من الإقرارات المتفائلة التي أطلقها أحد ألسنة الأنوار. إن مزيدا من الفهم الحاصل من خلال المعرفة والاتصال لا بد أن يؤدي الى مزيد من الصداقات أو على الأقل الى المزيد من التسامح بين الناس. لا شك في أنه من البسيط جداً أن نقول إن الحكم المسبق ينبني أولا على الجهل. فقد كان تقييم الآخر بالماضي يرتكز على تجارب شخصية تم تعميمها وتوظيفها بروافع سياسية أو أيديولوجية. وقد مهد عصر الأنوار الى تصويب ما تم تشكيله في السابق، وبات الفرد في هذه الأيام أن يتنقل بين عواصم كثيرة ويطلع من خلال وسائل كثيرة على الآخر الذي كان قد زُوِد بصورة غير واضحة عنه. ثالثا: ثقافات مختلفة ورؤى مختلفة ليست الثقافة إلا جهاز رموز جماعياً وقع توارثه عبر الأجيال. وقد تكون الثقافات العديدة مختلفة، ولكنها لا تختلف كلياً. فالثقافة المحلية هي نوع من الثقافة القومية، التي هي بدورها نوع من دوائر ثقافية أكبر على مستوى حضارة ما. وحتى الحضارات المختلفة كالحضارة الأوروبية والحضارة العربية، فإن لديها عدة خاصيات مشتركة. ويتمثل الخلاف بين الحضارات في جذور التاريخ الثقافي. فلقد كانت الحضارة الأوروبية مزج إرث فلسطين القديم (من خلال المسيحية) واليونان وروما. والحضارة العربية بأسسها الروحية الإسلامية، قد تكون أكثر توحدا في مسألة الروحانية من الحضارة الأوروبية. رابعا: صور أوروبا عند العرب يلتمس الباحث مقدما العذر في أن ما سيتكلم عنه في هذا الباب، سيكون (تخمينا) مبنيا على مشاهداته، وقد تختلف الصورة من بلد عربي الى آخر، وقد تختلف من جيل الى آخر. أوروبا عند الشباب العربي (في نظره) من خلال مشاهداته التلفزيونية، قد تكون مكاناً شديد الجاذبية، وقد تبدو البلدان الأوروبية غنية وعاداتها الاجتماعية متحررة جداً، وإمكانيات تحقيق الذات فيها كبيرة. هذه الصورة توازي بشكل ما الصورة التي كانت لدى العديد من الأوروبيين لأمريكا (التي كانوا يكونوها من خلال أعمال هوليود السينمائية)، ولعل تلك الصورة قد أصبحت قاتمة عند الأوروبيين عن أمريكا بعد أحداث (لوس أنجلوس)، كذلك هي الصورة عند العرب عن أوروبا بعد معاناة المهاجرين والتمييز فيما بينهم وبين الأوروبيين، ومع ذلك بقيت صورة أوروبا تشد الكثير من أبناء العرب. لكن، هناك من العرب (خصوصا كبار السن) من ينظر الى أوروبا على أنها أنانية وعدائية ومادية، ومتدهورة أخلاقيا، وهؤلاء أنفسهم يعترفون بتفوق أوروبا تقنيا وعسكريا. على أنني أخمن (يضيف الباحث) أن هناك من العرب من ينظر الى أوروبا وأمريكا نظرة بها منافسة غامضة، فهو يعترف بتفوقها ولكنه يراهن أن لديه الإمكانية للتفوق عليها، فتنشأ نظرة ممزوجة بين الرغبة في إقامة صلة مع الغرب لنقل تكنولوجيتهم وإبقاء حالة التوجس واعتبار الغرب مصدرا خطيرا يهدد العرب. وهنا يسأل المؤلف: هل أن نظرة العرب عن أوروبا صحيحة؟ وهل كل الغرب غني؟ فيجيب: ليس صحيحا تلك النظرة، بالقدر الذي تحمل معه شيئا من الصحة. فالغرب وإن كان متفوقا على العرب بعلاقات الإنتاج وإدارته، لكنه يحسد العرب على عدم تفككهم اجتماعيا وبقاء قابليتهم على الإنجاب والتكاثر والحفاظ على العلاقات الأسرية. خامسا: تصورات الأوروبيين للعالم العربي يقول الباحث: أن الإلمام بمعرفة الصور التي يكونها الغرب عن العرب ليست بالسهولة بمكان، فالكاتب كنرويجي يؤكد أن احتكاك أهل شمال أوروبا بالعرب ليس كأهل أوروبا على سواحل المتوسط، فالصنف الثاني على صلة جغرافية وتعاملية تاريخية قديمة، في حين قد ينقضي عمر ابن الدول الاسكندينافية دون أن يقابل عربيا، هذا في الماضي القريب. ويزعم الكاتب أن العالم العربي عند الإنسان الغربي له قيمة مزدوجة، فهو مغامر ومخاطر معا. ويمكننا أن نجد هذا النوع من الأحكام المزدوجة في الوثائق التاريخية والعبارات المعاصرة. يشكك أبناء الغرب في أن العرب سيتقبلون الحداثة بما يعيشها الغرب، فالاقتصاد والعلوم وممارسة الديمقراطية تحتاج الخروج مما هم العرب فيه من سوء اختيارهم لمن يحتل المناصب القيادية، فالطريقة التي يعتمدونها بعيدة عن مقولة (الرجل المناسب في المكان المناسب)، فمن يحتل المواقع القيادية يأتي من خلال عائلة حاكمة أو من خلال الدائرة المحابية للحاكم حتى غدا شكل التراتب الاجتماعي الممارس عند العرب من أكبر العوامل المعيقة للحاقهم بركب الحداثة. سادسا: المخاوف الحقيقية والكاذبة ينتهي الكاتب الى القول أن الصور التي كونها الغرب عن العرب أو العرب عن الغرب، هي في مجملها صور كاذبة. وقد يكون واضعو تلك الصور من الأشخاص ضيقي الأفق في أفكارهم وتجاربهم، ولكنهم نادرا ما يقصدون مباشرة الى الشر. وقد تكون تلك الصور هي نتاج متراكم عن مقولات مبتورة. ويلعب الإرث الديني والثقافي في تثبيت تلك الصور من لدن الطرفين، وإن الخوف من المستقبل آت بالدرجة الأولى من النظرة التي ينظرها الغرب الى العرب الذين يتضاعف سكانهم كل 25ـ 35 سنة، ولهم من الرغبة في الإنجاب والتكاثر، في حين يسود مجتمع الغرب كبار السن الذين يحتاجون تدفق المهاجرين من بلدان العالم الثالث ويخافون منه بنفس الوقت! إن إزالة المخاوف من أذهان الجميع تحتاج الى تكييف بشري سريع في طرق التعامل والتفاهم مع الآخر، وهذا يتطلب مشاركة الجميع. |
الفصل الثلاثون: ماضي الأقليات العربية والمسلمة في بولونيا: المرآة والوعي الذاتي ..
تقديم: توماس مارسينياك .. أستاذ في أكاديمية العلوم ـ بولندا الصفحات 559ـ 568 يقول الباحث: أن الموضوع الذي بين يديه هو عرض تاريخ جماعة صغيرة من المسلمين، ويقسم الباحث تلك الجماعة الى ثلاث مجموعات: الأولى: هي مجموعة التتار البولنديين، أو بالأحرى البولنديين المنحدرين من أصول تترية والذين يقطنون منذ عدة قرون فوق التراب البولندي. والثانية: وهم العرب الذين قدموا من أجل الدراسة في القرن العشرين وارتبطوا بالزواج من بولنديات. والثالثة: هم اللاجئون البوسنيون، وهم أحدث المجموعات وأقلها عدداً. أولا: التتار البولنديون يذكر الباحث أنه منذ ستة قرون دخل الإسلام الى بولندا في حالات قليلة، ثم زاد عددهم في القرن السابع عشر حيث هرب أكثر من 100 ألف من المسلمين التتار من ظلم قياصرة روسيا ولجئوا الى بولندا، وقد اندمج هؤلاء مع الشعب البولندي مع حفاظهم على ديانتهم (الإسلام)، وأصبح منهم نبلاء لا يقلون مكانة عن نبلاء بولندا. وفي عام 1925 أسس ((الاتحاد الديني للمسلمينMuzulmanski Zwiaze Religiny)) الناطق باسم الطائفة المسلمة داخل التراب البولندي، وفي السنة نفسها عين المستشرق (يعقوب سينكفياك) مفتي الإسلام في بولندا. وانضمت الى هذا الاتحاد 19 جماعة و 17 مسجدا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وكان المسلمون يعدون حوالي 7 آلاف شخص. وقد يكون هذا الإحصاء بعيدا عن الدقة، فكيف يكون عددهم 600 ألف قبل عدة قرون ثم يتحولون الى هذا العدد المتواضع! يظهر الباحث أن المسلمين كانوا عرضة للانتقادات وجعلهم أشبه بالجماعات النادرة التي تستهوي عمل الباحثين الاجتماعيين، فضاق هؤلاء السكان ذرعا بتطفل وملاحقة الآخرين لهم، فابتعدوا عن مظاهر إشهار طقوسهم [ هذا رأيي]. وما جعلني أميل الى هذا الاستنتاج، هو عبارة دونها أحد الباحثين على لسان أحد المسلمين البولنديين إذا قال (( سيدي إننا لم نعد نرغب في أن نكون من التتار. أنتم لا تفعلون شيئا سوى أن تشاهدونا، أما نحن فنريد العيش عيشاً عاديا، كسائر الناس))*1 ثانيا: الحياة الدينية اليوم إثر الحروب تغيرت حدود بولندا، مما أجبر السكان الانتقال من مكان الى آخر، وهذا ما حدث مع مسلمي بولندا، فبعد أن كانوا يسكنون شرق البلاد، أصبحوا يسكنون شمال وغرب البلاد. في عام 1984 زار مفتي لبنان (حسن خالد) بولندا للاتصال بالمسلمين فيها، ثم تكررت زياراته، وفي عام 1986 زار عدد من ممثلي رابطة المسلمين العالمية قادمين من السعودية، وكان لتلك الزيارة أهمية كبيرة، حيث تبعها زيارة للأمين العام لرابطة المسلمين العالمية (الشيخ عبد الله عمر النصاف) الى (فرصوفيا). ثم تلا تلك الزيارات بناء مركز المسلمين للثقافة والتربية في مدينة (بياليستوك) عام 1990، ومسجد يحمل اسم (جمال الدين الأفغاني) في مدينة (غدانسك) وقاعات لتدريس العربية، ومسجد في (فرصوفيا) مع مكتبة ونادي وقاعة متعددة الاستخدامات. وتوجد في بولندا منذ عام 1939 مجموعة من (المهديين) لها أتباع حوالي مائة. وقد أنشأت تلك المجموعة (جمعية اتحاد المسلمين) ولها 6 فروع في (فرصوفيا ورادوم وكيالس وغدانسك وكاليز وبودج) ويرأس الجماعة المهداوية الشيخ (محمد طه ذوق). وينشط في (بياليستوك) اتحاد التتار البولنديين برئاسة (ستيفن مصطفى مورشارسكي) وتضم تلك الجماعة حوالي 500 شخص. وفي بولندا جمعية لا تحظى بتأييد مسلمي بولندا، وتدعى (جمعية الأخوان المسلمين). وهي التي رفعت دعوى أمام العدالة في (فرصوفيا) ضد الكاتب الهندي (سلمان رشدي) صاحب كتاب (آيات شيطانية). ثالثا: العرب في بولندا: مباحث سوسيولوجية معظم العرب في بولندا هم من الأطباء ورجال العلم والطلاب، وقبل التعرف على هؤلاء، لم يكن البولنديون يعرفون شيئا عن العرب. في حزيران/يونيو 1988 قام مجموعة من الباحثين البولنديين في طرح أسئلة على عينة مكونة من أكثر من ألف شخص، تتعلق بانطباعات أفراد تلك العينة عن طباع مجموعة من الأجناس (العرب، اليهود، الصينيون، السود)، وكان حوالي 61% من الإجابات حول العرب [ لا أعرف]. أما من أجاب بالمعرفة فكانت إجاباتهم (أن العرب كسولون وعدوانيون ولا يحترمون المرأة وعدم قدرتهم على التعايش مع غيرهم، وأنهم متعصبون دينيا وقساة وشرسون. وأخذ الباحثون انطباعا أن البولنديين يشعرون بنفور عميق تجاه العرب سببه الخوف منهم. وفي عام 1991، أجرى فريق من الباحثين برئاسة (جوزيف غورنيافيك) وعضوية (الباحث : صاحب البحث الذي بين أيدينا) دراسة على 8 مناطق في بولندا منها 5 تسكن فيها أقليات، وكان عدد المشمولين بالبحث 1235. وكان السؤال عن الديانات: أي الديانات التي تحظى بقبول أقل لدى المشمولين بالبحث، فاحتل الإسلام المرتبة الثالثة بالكراهية بعد (اليهودية و المسيحية الأرثوذكسية). أما عن السؤال عن العرقيات، فاحتل العرب المرتبة الثانية بعد اليهود وتلاهم السود ومن ثم (غجر التسيغان). رابعا: المنشورات الإسلامية يوجد في الوقت الحاضر (وقت كتابة البحث من الباحث)، ثلاث صحف إسلامية موجهة الى حلقات ضيقة من القراء، فواحدة تخاطب المسلمين التتريين، وواحدة تحاول شرح التعاليم الإسلامية، وتصدر باللغة البولندية وتلخيص بالإنجليزية والعربية، فتحاول شرح القرآن، ويرى الباحث أن مستوى تلك الصحيفة متواضع ويساهم في تشويه الإسلام أكثر من توضيح تعاليمه. كما توجد مجلة شهرية اسمها (As-Sadaka الصداقة) تمولها الحكومة الليبية وتصدر منذ عام 1981، وهي تتحدث عن تضخيم دور ليبيا أكثر مما تتحدث عن مواضيع أخرى. يختم الباحث بحثه، بأنه وبعد أن أطيح بالنظم الاشتراكية في شرق أوروبا، فإن صورة العربي والمسلم في بولندا ـ والتي كانت متواضعة ومرتبكة أصلا ـ قد زادت سوءا بعد تقوية علاقات النظام الجديد مع إسرائيل. هوامش (من تهميش الباحث نفسه) *1ـ Aldona Krajewska, "Zmierzech polksiezyca" Polityka 24/12/1988 |
الفصل الحادي والثلاثون: صورة الآخر: حالة المجر
تقديم: ميكلوس هاداس .. أستاذ في جامعة بودابست للعلوم الاقتصادية ـ المجر أولا: الخلفية التاريخية يبلغ عمر المجر كدولة أكثر من ألف عام وبالتحديد منذ عام 896م، وقد أصبح الدين المسيحي دين الدولة منذ عام 1000م، وقد بلغت الدولة أوج عظمتها في القرن الخامس عشر، حيث شملت معظم دول أوروبا الشرقية. فقدت الدولة سيطرتها وسقطت تحت الحكم العثماني بعد سقوط أهم مدنها الجنوبية (بلغراد: عاصمة صربيا ويوغسلافيا السابقة)، وقد بقيت ممتلكات الدولة المجرية تحت الحكم العثماني ما يقارب القرن والنصف. وقد انخفض عدد سكان البلاد إبان الحكم العثماني من 5 ملايين الى مليونين فقط، وقد قفرت البلاد وتدهور أداؤها الاقتصادي، وجند الأتراك من أطفالها جنودا ضمن الجيش الانكشاري، وقد وجدت في الحرب العالمية الثانية قبيلة تُدعى (المغاري) على ضفاف النيل (في مصر) تبين أن أصلها من الانكشاريين المجريين. وفي القرن السابع عشر، ونتيجة الى أن الضعف بدأ يدب في الإمبراطورية العثمانية، استطاعت النمسا أن تبسط نفوذ دولتها القوية (هابسبورغ) على الأراضي المجرية، وتدفقت العروق المختلفة على تلك الأراضي حتى أصبح الدخلاء يشكلون 54% من سكان المجر الذي كانوا يعدون 13.2 مليون عام 1869. ثم انخفض هؤلاء الغرباء ليصبحوا 45.5% عام 1910 من أصل 18.2 مليون نسمة وهم من أصول رومانية وألمانية وسلوفينية وصربية وغيرها. في عام 1867، وبعد مطالبات مجرية كثيرة، وبعد أن دب الضعف بإمبراطورية (هابسبورغ) تم اقتسام تلك الإمبراطورية بين المجر والنمسا. دخل حوالي 200 ألف يهودي الى أراضي المجر بعد اضطهادهم في روسيا وبولندا، وامتهنوا التجارة وأعمال المبادلة، تلك الأعمال التي كان يترفع عنها نبلاء المجر، ومن هنا أصبحوا من أغنى أغنياء المجر وتصاهروا مع طبقة النبلاء في المجر ليصبحوا قريبين من صناعة القرار، إضافة الى انفلاتهم من المراقبة والملاحقة القانونية. وفي عام 1910 كانت (بودابست) أكبر مدينة في أوروبا مساحة وسكانا، إذ كانت مساحتها تزيد عن 80 ميل مربع ربعهم من اليهود، ومن بين كل خمسة محامين هناك اثنان من اليهود. ثانياً: مواقف المجريين من الأمم الأخرى بعد الإيجاز التاريخي السريع، سيكون سهلاً على الباحث من تفسير مواقف المجريين من الأمم الأخرى، وقد كان للباحث نفسه دراسة شملت عينات من ثلاثة بلدان هي: المجر وبولندا وتشيكسلوفاكيا، وسنركز على سؤال واحد من مجموعة الأسئلة التي وجهت الى أفراد تلك العينات، وهو: هل تحبذ عدم وجود جماعة (كذا) بجوارك؟ وكانت الأجوبة: أ ـ الغجر 76% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 72% من البولنديين و 85% من التشيكوسلوفاكيين. ب ـ عرب 67% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 62% من البولنديين و 70% من التشيكوسلوفاكيين. ب ـ زنوج 48% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 54% من البولنديين و 57% من التشيكوسلوفاكيين. ب ـ آسيويون 42% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 51% من البولنديين و 57% من التشيكوسلوفاكيين. ب ـ روس 40% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 40% من البولنديين و 31% من التشيكوسلوفاكيين. ب ـ يهود 17% من المجريين لا يحبذون مجاورتهم. و 40% من البولنديين و 23% من التشيكوسلوفاكيين. ويلاحظ أن العرب بالبلدان الثلاثة يحتلون المرتبة الثانية بالكراهية بعد الغجر، والسبب هو الإعلام المسبق عن العرب بأنهم إرهابيون ويميلون للعنف، كما أن الإعلام العربي والذي يمكن أن يحسن تلك الصورة غائب وغير معتنى به. كما أن الزنوج والآسيويون يشتركون مع العرب في سلوك سيء وهو ملاحقة المراهقات والميل للعلاقات الجنسية الفجة. أما الروس، فالدول الثلاث لا تكن لهم أي نوع من الود، كونهم ارتبطوا بالاتحاد السوفييتي وقهره لتلك الدول الثلاث التي حاولت أكثر من مرة الخروج من دائرة نفوذه. واليهود، ارتبط ذكرهم بمقتل 600 ألف يهودي ناطق بالمجرية في عام 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية، فأحدث تعاطفا كبيرا معهم من زاوية إنسانية، أما شمولهم مع الجماعات الست المكروهة، وهي أن معظم قيادات الحزب الشيوعي الهنغاري كانت منهم. الدول الأكثر جذبا للمجريين يعتبر المجريون اليابانيين أكثر شعوب العالم تحضراً، ويليهم الإنجليز ثم الفرنسيون، والأمريكان فالألمان ثم الانماركيون ومن بعدهم الإيطاليون. ويكن المجريون مودة استثنائية لدولتين تعادلهما بالحجم من حيث السكان والقدرة وهما النمسا وفنلندا حيث تعتبر كل منهما نموذجا يُحتذى به بالمقارنة. |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.